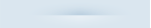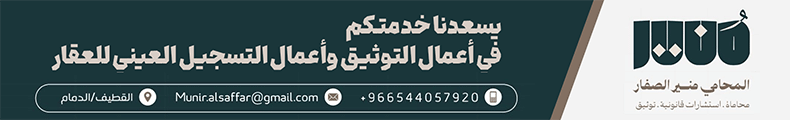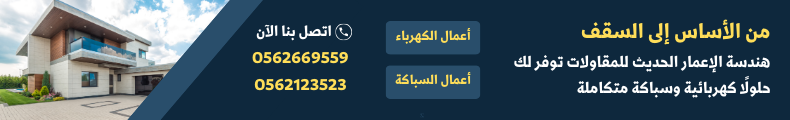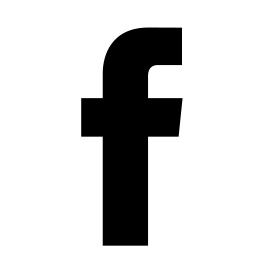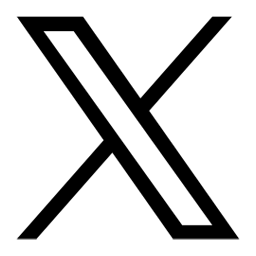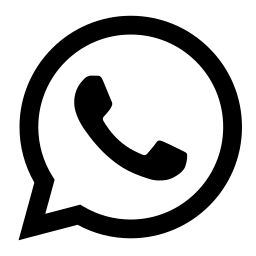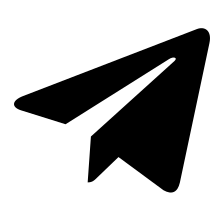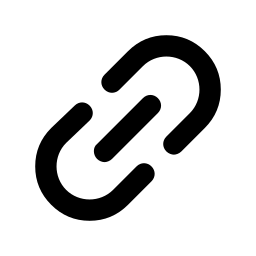حين يتدخل الرفق في القدر: قراءة في فعل الرحمة وآثاره المتراكبة
في زمنٍ يتسابق فيه الناس على التنفيذ والتشريع والتقنين، تظلُّ بعض الأفعال الفردية - مهما بدت عابرة - أكثر رسوخاً من عشرات المراسيم. إنّها الأفعال التي تسكن في الظلّ، لكنها تُوقظ الإنسانية من غفلتها. ما حدث في قصة الموظف الذي كاد يُفصل من عمله في أواخر شهر رمضان ثم تُوفي ثالث أيام العيد، ليس حدثاً عادياً، بل مرآة كاشفة، تعرض علينا تقاطع الرحمة البشرية مع التقدير الإلهي، وتكشف كيف تُغيّر لحظة تعاطف، مصيراً كاملاً.
حين قرر المدير تأجيل القرار احتراماً لبهجة العيد، لم يكن يتهرب من واجبه، بل اختار وجهاً آخر للعدل. اختار عدل الرحمة. لم يستند إلى نصٍّ قانوني، بل إلى سياق إنساني، وسؤال أخلاقي: هل يليق بنا أن نكسر قلوب عائلة وهي تستعد لفرحة العيد؟ هذه الوقفة، التي قد يراها البعض ضعفاً في الحزم، كانت قمة القوة، لأنها اصطفت مع الفطرة، مع الروح التي قال عنها القرآن:
﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: آية 107].
وهل الرحمة إلا قدرة على تأجيل الضرر إن لم يكن ضرورياً؟ على تخفيف الوطء حين يكون التشدد خياراً لا ضرورة؟
عجيب هو القدر حين ينسج خيوطه في صمت، ويعبر من خلال قلوب طيّبة تمارس مهنتها دون ضجيج. في هذه القصة، جاء التأجيل سبباً لا ليُنجّي الموظف من الفصل، بل ليُنجّي أسرته من فقدانين: فقد العائل، وفقد المورد. كأن الله تعالى أراد أن يُمضي على الأسرة قدراً واحداً، لا قدريْن. أن يأخذ الروح، ويترك لهم رزقها.
أليس هذا جوهر ما أشار إليه الحديث النبوي: ”إن الله يحب الرفق في الأمر كله“؟
والرفق هنا لم يكن مشاعر طيبة فحسب، بل تدخّل في مسار الزمان، في معادلة المال والحياة، في المشهد النفسي والاجتماعي الكامل لعائلة قد تفقد كل شيء.
شهر رمضان، من حيث الجوهر، ليس شهراً للعبادة الفردية فقط، بل لتدريب الإنسان على التعاطف، على تعليق غضبه، وترويض قراراته، وتبديل شعوره بالسيطرة إلى شعور بالشراكة في الضعف الإنساني العام.
تأجيل القرار لم يكن عن تردد ولا تهاون، بل كان انحيازاً للفكرة الرمضانية الكبرى: كفّ الأذى.
في شهرٍ يُطلب منك ألا تجرح بكلمة، فكيف لك أن تُصدر قراراً قد يهدم بيتاً؟
شهر رمضان يعلّم الإنسان أن الحسم لا يعني القسوة، وأنه ليس كل ما يُستطاع يُفعل، بل ما يُليق يُفعل.
لو تخيلنا للحظة أن القرار نُفذ قبل العيد، ثم جاء خبر الوفاة، لكان المشهد مضاعفاً في الألم. ما بين الحزن على الفقد، والقلق على المستقبل، والانكسار أمام مجتمعٍ لا يرحم.
لكن الرحمة هنا لعبت دور ”الطبيب النفسي غير المعلن“. لم تداوي الحزن، بل خفّفت من قسوته.
منحت العائلة شيئاً من الكرامة وهم يستقبلون العزاء، فلم يشعروا أنهم يعانون كل الخسارات دفعة واحدة.
هذا الفعل، الصغير في أوراقه، الكبير في أثره، يشبه ما قاله الله في القرآن:
﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [البقرة: آية 83].
لأن الكلمة، والموقف، والقرار حين يكون ”حُسناً“، يصير دواءً.
ليست الرمزية في الأدب مجرد رموز بلاغية، بل أفعال تتكرر ببساطة، لكنها تمثّل طبقات من المعاني.
في هذه القصة، الرمزية لا تسكن في الموت ولا في القرار، بل في ”النية“، في قرار لم يُنفذ لكنه أنقذ.
وهنا دعوة مفتوحة لكل الأدباء الشباب:
لا تبحثوا عن البطولة في أدوار خارقة، بل في لحظة صدق عادية، تتخذ فيها موقفاً أخلاقياً صامتاً.
البطولة ليست في إنقاذ العالم، بل في إنقاذ معنى الرحمة في قلب إنسان.
فلنكتب عن المدير الذي لم يُصدر القرار، عن الموظف الذي لم يعلم أن الله يدافع عنه دون سعي منه، عن الأسرة التي لم تفقد كل شيء، عن الزمن حين يحنو، عن الورقة التي بقيت في الدرج، فصارت معاشاً.
هذا هو الأدب الحقيقي: ليس فقط ما يُحكى، بل ما يُشعرنا أن الخير ما زال يعمل في السرّ، وأن النية قد تكون أكبر من الفعل، وأن الله يُدبّر حين نحسن النية.
هذه القصة ليست فقط عن رجل تأخّر في توقيع قرار، بل عن معنى أكبر: أن بعض الناس، حين يرفق، يُشابه تدبير السماء.
في عالم يتسارع فيه كل شيء، فلنتعلم كيف نؤجل ما يُؤذي، حتى لو بدافع لا نفهمه.
فلعلّ في هذا التأجيل حياة، أو كرامة، أو رزق، أو معنى.
﴿فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: آية 19].
والخَيرُ ها هنا، كان في قرارٍ لم يُصدر، لكنه كتب لأسرته رزقاً لا ينقطع.