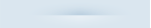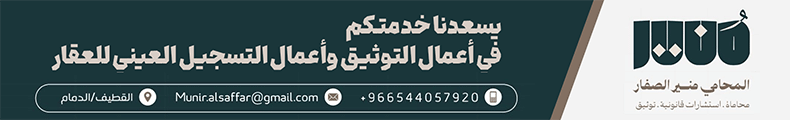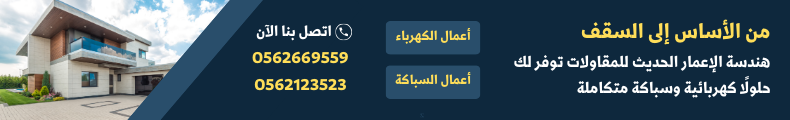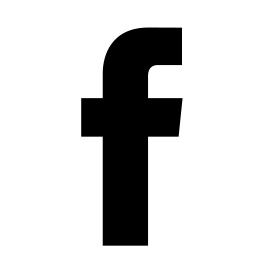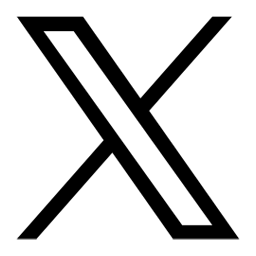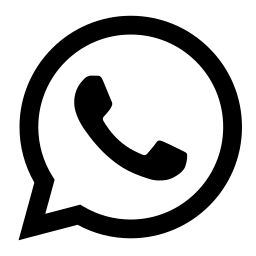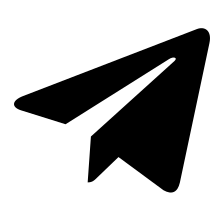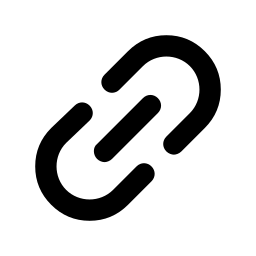نافذة على القرآن الكريم.. تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ..
من سور القرآن سورة الفرقان، وهي السورة الخامسة والعشرون في ترتيب المصحف الشريف. تقع في الجزء التاسع عشر، نزلت بعد سورة يس، وهي سورة مكية ما عدا الآيات 68 - 70 فمدنية، ولا يوجد لها أسماء ثانية، آياتها 77، السورة بها سجدة تلاوة في الآية 60. وسميت سورة الفرقان؛ لافتتاحها بالثناء على الله عزَّ وجلَّ الذي نزَّل الفرقان، هذا الكتاب المجيد على رسوله محمد صلّى الله عليه وآله وسلم، فهو النعمة العظمى، الذي فرق الله به بين الحق والباطل: ﴿تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيرًا﴾ . ولنا وقفة مع هذه الآية، وقبل ذلك نلقي نظرة عامة على سورة الفرقان.
عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن  قال: ”يا بن عمار، لا تدع قراءة سورة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فإن من قرأها في كل ليلة لم يعذبه الله أبدًا ولم يحاسبه، وكان منزله في الفردوس الأعلى“. [ثواب الأعمال، الشيخ الصدوق، ص 109].
قال: ”يا بن عمار، لا تدع قراءة سورة تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فإن من قرأها في كل ليلة لم يعذبه الله أبدًا ولم يحاسبه، وكان منزله في الفردوس الأعلى“. [ثواب الأعمال، الشيخ الصدوق، ص 109].
لأن السورة مكية؛ لذا اشتملت على موضوعات تُعنى بأصول الدين مثل التوحيد والنبوة وأحوال القيامة، في مفردات متعددة منها: إثبات وحدانية الله سبحانه، وصدق رسالة النبي محمد ﷺ، ووقع البعث لا محالة، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف ذكرت قصص بعض الأنبياء السابقين، وساقت أدلة على قدرة الله ووحدانيته.
ثم خُتمت السورة ببيان صفات عباد الرحمن المخلصين الموقنين، وما يتحلون به من أخلاق سامية وآداب رضية، تجعلهم يستحقون بها إكرام الله تعالى وثوابه الجزيل في جنات النعيم.
الآية الأولى من السورة هي: ﴿تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيرًا﴾ ، وسوف نقف عند كل كلمة منها لنصل في المجمل إلى دلالتها والمعارف المشتملة عليها بأدوات لغوية، سوف يلاحظها القارئ الكريم في أثناء بسط معانيها.
بدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بقوله: ﴿تَبَارَكَ﴾ [الفرقان: 1]، كما بدأ غيرها بقوله: ﴿سُبْحَانَ﴾ [الإسراء: 1].
سورتان بدأتا بـ تبارك هي «الفرقان» و«الملك».
﴿تَبَارَكَ﴾ : فعل ماضٍ مبني على الفتح، لم يأت منه فعل مضارع، ولا فعل أمر، ولا اسم فاعل، ولا يقال: يتبارك، كما يقال يتعالى. ولا يقال: متبارك، كما يقال متعالٍ. ويقال: تَبارَكَ أي ذو بركة. والبركة: هي كثرة الخير.
ولا يستعمل إلا مع الله تنزيهًا له سبحانه.
لكن أستاذنا الدكتور إبراهيم الشمسان يقول: "والذي ننتهي إليه أن الفعل «تبارك» ونحوه مثل «تعالى وتقدس وتعاظم» إن أريد بها إنشاء الثناء والتنزيه لله فهي جامدة لا يستعمل منها سوى الماضي، ومرد جمودها إلى خصوصية الاستعمال، وإن أريد بها الإخبار تصرَّفت، فمن تصرف الفعل «تعالى وتقدس» قول ابن الأثير «واللَّه يَتَعالى عَنْ ذَلِكَ ويَتَقدَّس» [الجزيرة الثقافية/ 27/ 2/ 2021 م]؛ ولذلك يقول بعضنا: أنا أتبارك بدخولك إلى منزلي، وهذا تعبير مقبول.
وفي دلالة نجد أن ﴿تَبَارَكَ﴾ : ”تَفاعَلَ“ من البركة، ومعناه: تَعالَى وجاء بكل بَرَكةٍ، وقيل: تَعَظَّمَ، وقيل: تَمَجَّدَ، وقيل: ثبت ودام بما لم يَزَلْ ولا يزال.
واشتقاقه من ”بَرَكَ الشيءُ“: إذا ثَبَتَ، ومنه: بَرَكَ الجملُ، وأصل البركة النماءُ والزيادةُ.
وفي هذه الصيغة ﴿تَبَارَكَ﴾ ثبوت الخير الكثير وفي صيغته دلالة على المبالغة على ما قيل، وهو كالمختص به تعالى لم يطلق على غيره إلا على سبيل الندرة.
يقول ابن عاشور 24/ 191: ”وتبارك خبر مستعمل في إنشاء المدح...“.
وجاءت هذه المفردة 9 مرات في كتاب الله، منها ثلاث مرات سورة الفرقان جاءت:
الموضع الأول في الآية الأولى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ﴾ .
والموضع الثاني في الآية العاشرة: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾
الموضع الثالث في الآية الواحدة والستين: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾ .
والمواضع الستة الأخرى التي وردت فيها كلمة «تَبَارَكَ» هي: الأعراف: 54، والمؤمنون: 14، وغافر: 64، والزخرف: 85، والرحمن: 78، والملك: 1.
وإذا كان الله تعالى مصدر البركة، فمن أرادها فليتعلق بمصدرها لا بغيره!، فيطلب الخير الكثير والرزق الوفير والعلم النافع وصلاح الذرية ومصالح الدنيا والعاقبة الحسنة في الأخرى، نطلب ذلك كله من مصدره وهو الله تعالى الرزَّاق المنعم المتفضل، لا من غيره، كفلَّاح يطلب سقي حقوله من مصدر الماء ومعينه، لا من فروعه وتشعباته؛ ومن هنا جاءت هذه المفردة باشتقاقاتها في الأحاديث الشريفة. عن أبي عبد الله البرقي رفعه قال لما زوج رسول الله ﷺ فاطمة  قالوا: بالرفاء والبنين، فقال: لا، بل على الخير والبركة. [جامع أحاديث الشيعة، السيد البروجردي، 20/ 109].
قالوا: بالرفاء والبنين، فقال: لا، بل على الخير والبركة. [جامع أحاديث الشيعة، السيد البروجردي، 20/ 109].
«الَّذِي» اسم موصول فاعل «تَبَارَكَ» في محل رفع، والمقصود به الله سبحانه، لم يذكر اسمه جلَّ جلاله تعظيمًا لشأنه.
وفي كون فاعل «تبارك» اسمًا موصولًا إشعار بواحد من مظاهر خيره العميم وبركته العظمى على عباده؛ هذا الخير يوضحه صلة الموصول: ﴿نَزَّلَ آلفُرقَانَ﴾ . هو الامتنان بتنزيل القرآن الكريم على قلب نبيه ﷺ: ﴿وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ [سورة النمل: 6].
مادة الفعل «ن ز ل»: هو في الأصل انحطاط من علو، وقد نزلهم، ونزل بهم، ونزل عليهم. [تاج العروس، الزبيدي، 15/ 72].
«نزَّل»، تشديد الفعل: نَزَل: نزَّل، التضعيف في «نَزَّلَ» ليس للتكثير والتفريق، وإنما هو للتعدية، وهو مرادف للهمزة [تفسير البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، 3/ 387]. أي يصبح الفعل اللازم «نزَل» متعديًا بالتضعيف: نزَّل، وبالهمزة: أنزل، وتسمَّى هذه الهمزة همزة التعدية.
وفي الفرق بين «الإنزال والتنزيل» ذكروا أن النزول دفعة واحدة، وأن التنزيل هو النزول بتدرج. ومثل هذه التفسيرات مشتقة من بعض الاستعمالات القرآنية لمادة نزل. فقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [القدر: 1]. [يُنظر: المفردات في غريب القرآن، الرغب الأصفهاني ص 489، ومعجم الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، ص 79، وفي علوم القرآن دراسات ومحاضرات، مجموعة من المؤلفين، ص 36].
وفي «تاج العروس»: ”وفرق جماعة من أرباب التحقيق، فقالوا: التنزيل: تدريجي، والإنزال دفعي“. [تاج العروس، الزبيدي، 15/ 72].
مصدر فَرَقَ يفرق فرْقًا وفرقانًا. سُمي فرقانًا لأنه يفرق به بين الصواب والخطأ، والحق والباطل في أمور الدين، بما فيه من الوعظ والزجر عن القبائح والحث على أفعال الخير. قال تعالى: ﴿وَلَقَد ءَاتَينَا مُوسَى وَهَرُونَ آلفُرقَانَ وَضِيَاء وَذِكرًا لِّلمُتَّقِينَ﴾ [الأنبياء: 48].
وسُئل رسول الله ﷺ فقال له: لم سمي الفرقان فرقانًا؟ قال: ”لأنه متفرق الآيات والسور أنزلت في غير الألواح وغيره من الصحف والتوراة والإنجيل والزبور، نزلت كلها جلمة في الألواح والورق“. [علل الشرائع، الشيخ الصدوق، 2/ 470].
وفي الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين  من دعائه عند ختم القرآن: ”اللهم إنك أعنتني على ختم كتابك الذي أنزلته نورًا، وجعلته مهيمنًا على كل كتاب أنزلته، وفضَّلته على كل حديث قصصته وفرقانًا فرقت به بين حلالك وحرامك، وقرآنًا أعربت به عن شرائع أحكامك، وكتابًا فصلته لعبادك تفصيلًا،...“. [الصحيفة السجادية، الإمام زين العابدين
من دعائه عند ختم القرآن: ”اللهم إنك أعنتني على ختم كتابك الذي أنزلته نورًا، وجعلته مهيمنًا على كل كتاب أنزلته، وفضَّلته على كل حديث قصصته وفرقانًا فرقت به بين حلالك وحرامك، وقرآنًا أعربت به عن شرائع أحكامك، وكتابًا فصلته لعبادك تفصيلًا،...“. [الصحيفة السجادية، الإمام زين العابدين  ، ص 194 «أبطحي» ].
، ص 194 «أبطحي» ].
الضمير في عبده «هاء الغائب» يعود على كلمة مفهومة من السياق، إذ الأصل في الضمير أن يعود على كلمة سابقة، لكنها هنا مفقودة، فلا محالة من عوده على اسم مفهوم من سياق الآية، لأنه من المعلوم - بالضرورة - أن القرآن الكريم نزل على رسول الله ﷺ. قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحنُ نَزَّلنَا عَلَيكَ آلقُرءَانَ تَنزِيلًا﴾ [الإنسان: 23].
ووصفه بالعبد دون غيره يُوحي بأنه عبد ممتثل لأوامر سيده ومولاه لا يعصيه ولا يحيد عنه، وهو هنا يقتضي أن يبلِّغ رسالة القرآن لجميع من بُعث إليهم منذرًا لهم يخوِّفهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا به ويخضعوا لأوامره ويجتنبوا عن نواهيه.
اللام للتعليل. كأنه جواب لسؤال مقدر: لماذا نزَّل الله القرآن على عبده؟ والجواب: لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيرًا؛ هذه هي الغاية من الرسالة الإلهية.
ما اسم يكون؟
ضمير مستتر تقديره «هو»، يحتمل أن يعود على «عبده» أو «الفرقان»، والمؤدَّى واحد؛ إذ إما أن يكون القرآن الكريم هو النذير، ومبلِّغ القرآن هو النبي محمد، أو يكون النبي محمد هو مبلِّغ القرآن، والمعنى واحد سواء أرجعنا الضمير «المستتر» على النبي أو على القرآن. و«نَذِيرًا» خبر «يكون» منصوب.
الجمع المحلى باللام يفيد الاستغراق «العالمين» يدل على عموم رسالته ﷺ لجميع الكائنات، لكن لمَّا كان المكلفون منهم الإنس والجن فحسب، فرسالته إليهما دون سائر المخلوقات. قال تعالى: ﴿قُلْ يأَيُّهَا آلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ آللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الأعراف: 158]، وقال: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَآفَّةً لِلنَّاسِ﴾ [سبأ: 28]، أي أرسلناك للناس جميعًا من دون استثناء أحد منهم.
النذير هو المخبِر بسوء يقع، وهو فَعيل بمعنى مُفْعِل بصيغة اسم الفاعل مثل الحَكيم. والاقتصار في وصف الرسول هنا على النذير دون البشير كما في قوله: ﴿أَوَلَم يَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِن هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ [الأعراف: 184]. لأن المقام هنا لتهديد المشركين إذ كذبوا بالقرآن وبالرسول عليه الصلاة والسلام. فكان مقتضيًا لذكر النذارة دون البشارة، وفي ذلك اكتفاء لأن البشارة تخطر ببال السامع عند ذكر النذارة.
والحمد لله ربِّ العالمين.