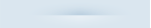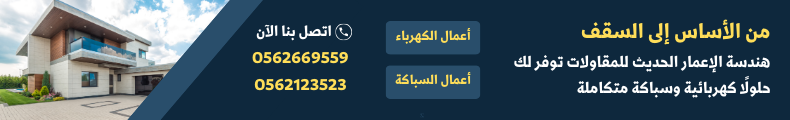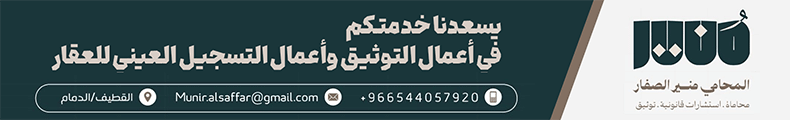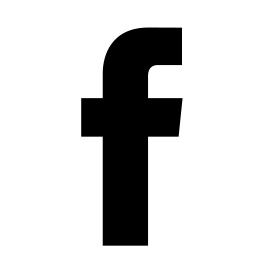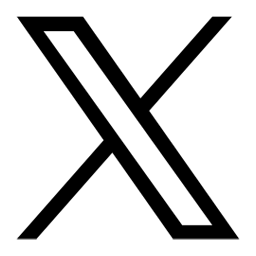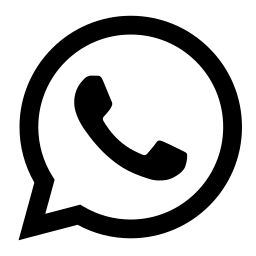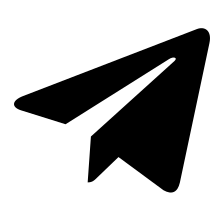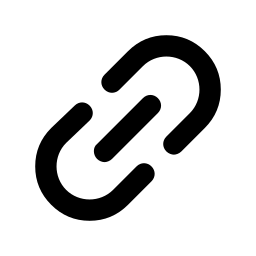ظاهرة تلقّي الفلسفة عند فئة من الشباب
ظاهرة الإقبال على الفلسفة قراءة وكتابة جزء من التحول الشامل الذي يعيشه المجتمع السعودي في لحظته الراهنة بعدما كان المؤشر على هذا الإقبال في السنوات السابقة على سنوات التحول مقتصرا على دوائر النخبة فقط، ومعدوما أيضا في الأوساط التعليمية والمنهجية بشكل عام.
لا أريد في هذه المقالة مناقشة حالة الإقبال تلك والمظاهر المصاحبة لها، ومسألة تلقى المتون الفلسفية سواء على تلك المنصات المختصة أو الإصدارات المتعاقبة التي تطالعنا بها دور النشر ترجمة أو تأليفا، أو تلك الجهود التي تبذلها جمعية الفلسفة من أنشطة وفاعليات ومهرجانات هي واضحة للعيان وتشكل رافعة مهمة في تأسيس وعي فلسفي، سيأتي أكله لا حقا.
ما أريد مناقشته حقا هي ملاحظاتي التي استخلصتها منذ فترة من خلال حواراتي مع بعض الشباب المهتمين بالفلسفة، ومن كتاباتهم التي يأتي بعضها منغمسا في النصوص الفلسفية، وبعضها الآخر يرتبط بفلاسفة معينيين اشتهروا باعتبارهم أيقونات لا تخلو مقولاتهم من التدوال على الألسنة عند فئة من الشباب.
لقد قادتني ملاحظاتي إلى طرح السؤال التالي: ما الغاية من قراءة الفلسفة إذا لم تضع الفكر أمام حلول نظرية وعملية للأزمات التي يمر بها الفرد والمجتمع في حياته اليومية؟ أعلم تماما أن البعض يرى أن مجرد الاهتمام بالقضايا الفلسفية المعاصرة يجعلك منخرطا ومتفاعلا مع الأزمات الاجتماعية والثقافية والسياسية والفكرية والعلمية التي تمر بها مجتمعات العالم، وبالتالي تصبح مساهما فعّالا في قضايا العالم كأزمة المناخ وحقوق الإنسان والأقليات وأزمة أخلاق الحداثة.. ألخ.
رغم صحة هذا القول على العموم. لكنه لا ينطبق على مجتمعنا الذي للتو بدأ يتلمس طريقه إلى الفلسفة.
لذلك ما أراه «وعسى أن أكون مخطئا لأن ملاحظاتي قائمة على نتائج حوارات وبعض القراءات» هو أن هناك فئة من الشباب أدى انغماسها في متون الفلسفة وتاريخ مقولاتها وأفكارها حد الهوس إلى الانفصال التام عن واقعها وشؤونه. وهذا الانفصال في ظني نتاج عملية تلقّي الأفكار الفلسفية الكبرى دون وضع التاريخ بجميع فروعه محور الاهتمام أو الركيزة والمعيار في حال كنا نتوقف عند هذا الفيلسوف في أفكاره أو عند آخر في مقولاته الرئيسية.
أحد الباحثين يقترح ثلاثة طرق في النظر إلى الفيلسوف إذا ما أردنا أن نفهم مكانته في تاريخ الفلسفة ولا بد أن توضع هذه الطرق في الاعتبار.
الأولى: هي العلاقة المنطقية لفكر الفيلسوف بالفلاسفة السابقين عليه واللاحقين. فمثلا قد يتابع الفيلسوف الحديث النتائج المنطقية لبعض أفكار سابقيه أكثر مما فعلوا، ولهذا وصل كل من سبينوزا وليبنتس بأحد اتجاهات فكر ديكارت إلى ذروته.
وسنرى مع كانط أنه حاول أن يوفّق بين اتجاهين متعارضين «المثالية والتجريبية» وخرج بوجهة نظر جديدة.
الثانية: أن ننظر إلى كل فيلسوف على أن أفكاره تعبير بطريقة ما عن نظرة عصره العلمية والدينية والأخلاقية والاقتصادية. لذلك، عّبر ديكارت تعبيرا تاما عن أفضل ما في العبقرية القومية الفرنسية إلى درجة أن كل مفكر فرنسي جاء بعده، ودرس موضوعات فلسفية الطابع أظهر تأثير ديكارت بطريقة أو بأخرى.
كذلك كان جون لوك الذي عبّر في مجال السياسة والتعليم والدين بأفكار كان كثيرون يفكرون بها. لذلك، كان أثره على اللاحقين إلى حدود 100 سنة.
الثالثة: هي التي تأخذ بالاعتبار الحياة الخاصة لكل فيلسوف وكذلك شخصيته وصفاته. فهذا سبينوزا الذي طُرد من المحفل الديني اليهودي وأصبح منبوذا يجد في الجانب الآلي لفلسفة ديكارت وهوبز تفسيرا روحيا يتيح تصالحا وهدوءا لنفسه المعذبة. وهذا شوبنهاور الذي كان عاشقا أنانيا وعصابيا للنجاح مع كرهه للعمل استطاع أن يرى لهذا السلوك تبريرا فلسفيا تشاؤميا مطلقا ونبذا للعالم.
هذا المقترح من الباحث يضعنا تماما أمام أزمة الوعي بالتاريخ العربي الإسلامي، فإذا كان من السهولة بمكان على قارئي الفلسفة الغربية ومختصيها أن يكتشفوا هذه الطرق ويربطوها بالحوادث التاريخية وحياة أصحابها من فلاسفة ومبدعين وكتاب ومفكرين لوفرة المدونات التاريخية عندهم، فإن ما ينقصنا هو تلك الوفرة تماما.