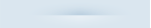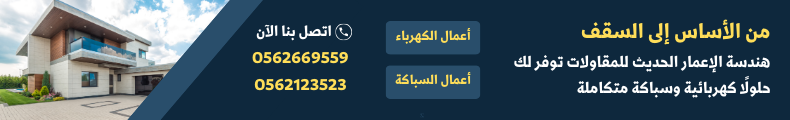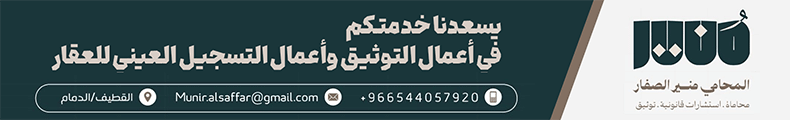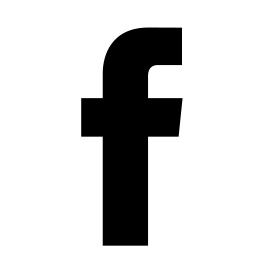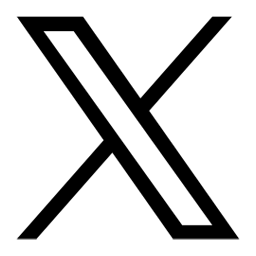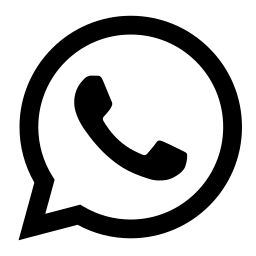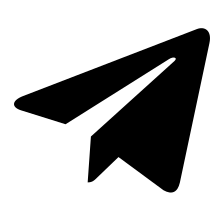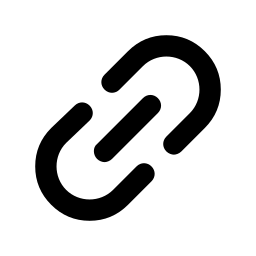الوهم الكبير... أن نتفق دائمًا
في الرِّياضة نختلف على رئيس نادٍ، وفي الجمعيات نختلف على رئيس أو مجلس، وفي الدِّين نختلف على خطيب أو عالم، وفي المجالس العادية نختلف في الذَّائقة والاستماع، فيمن نرتاح له ومن لا نرتاح. وكلُّ هذه الاختلافات طبيعيَّة، وضرورية أحيانًا؛ لأنَّها تعكس تنوعًا في الأذواق والتَّجارب والخبرات. والمشكلة ليست في أن نختلف، وإنَّما في غياب فقه الاختلاف، وفي تعصب بعضنا لآرائه حتَّى يتحول هذا التَّباين الطَّبيعي إلى خلافات مذمومة.
لماذا نخاف أن نُبدي رأيًا مختلفًا؟
ولماذا صار البعض يتوجس من التَّعبير عن رأيه في شخصيَّة دينيَّة أو أكاديميَّة أو حتَّى رياضيَّة؟
متى أصبح اختلاف الرأي تهديدًا؟
ومتى تحوَّل الحوار إلى ساحة صراع بدل أن يكون مساحة تفاهم؟
في بداية أي موسم انتخابي لرئاسة نادٍ رياضي، تقوم الدُّنيا ولا تقعد. وتنقسم الآراء إلى فريقين متضادين: أحدهما يمدح حتَّى يرفع مرشحه إلى مصاف المنقذينَ، والآخر يذم حتَّى يشكك في النَّوايا والقدرات. والأسوأ أنَّ البعض لا يكتفي بالخلاف؛ يَفْجُرُ في الخُصومةِ، وكأنَّها معركة مصيريَّة لا تحتمل إلَّا غالبًا ومغلوبًا؛ فإن كانت هذه الحالة الانفعاليَّة الحادة تقع في موضوع رياضي - يُفترض أنَّه من أبسط الشؤون الاجتماعية - فكيف بنا إذا انتقلنا إلى ما هو أعمق وأهم؟
وكيف سيكون المشهد حين نختلف حول قضايا فكريَّة، أو نناقش مرجعيات دينيَّة، أو ننتقد أداء شخصيات عامَّة في مواقع التأثير؟
إنَّ الاختلاف بين النَّاس أمر فطري لا مهرب منه، وهو من سنن الحياة التي أرادها الله تعالى، لحكمة في تنوع العقول والتَّجارب والتَّوجهات. لكن الإشكال يكمن في غياب ثقافة تحسن التَّعامل معه؛ لذلك، نحن بحاجة إلى ”فقه الاختلاف“ لا إلى وهم الاتفاق الكامل. وهذا الفقه لا يُقصد به فقط معرفة أنَّ النَّاس تختلف، ولكن إدراك أنَّ الاختلاف لا يُفسد الودَّ، ولا يُسقط الاحترام، ولا ينبغي أن يتحوَّل إلى خصومة أو شتائم أو تخوين؛ فالتَّعصب للرَّأي، ورفض سماع الطَّرف الآخر، ومحاولة احتكار الصَّواب، هي مظاهر ضعف لا قوَّة، وهي ما يجعلنا نحول أبسط التباينات إلى خلافات متأزمة، وأحيانًا إلى قطيعة اجتماعيَّة لا تليق بمجتمع واعٍ.
فهل كلُّ من خالفك الرَأي هو عدوك؟
وهل كلُّ من لم يصفق لك، يقف ضدَّك؟
الاختلاف في الرأي هو ظاهرة طبيعية، وضرورية، وليس طارئًا على المجتمعات، تثبت أنَّ العقول تعمل، وأنَّ النَّاس تفكِّر وتفهم من زوايا متعددة. ولو كنَّا جميعًا متفقين في كلِّ شيء، لانتفى معنى الحوار، ولما تطورت الأفكار، ولا استقام البناء الاجتماعي. حتَّى داخل الأسرة الواحدة، نختلف في الميول والاهتمامات والتفضيلات، فكيف بين المجتمعات والدَّوائر الأوسع؟
مما لا شكَّ فيه أنَّ القرآن الكريم نفسه أقرَّ بحقيقة هذا الاختلاف، فقال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ [سورة هود/ الآية: 118]، ثمَّ ختمها ب: ﴿إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ﴾ [سورة هود/ الآية: 119]، كأنَّها تقول لنا: الاختلاف باقٍ، والرَّحمة وحدها هي التي تُجنِّبنا شروره؛ فالاختلاف طبيعي، ودليل عافية، متى ما بقي في إطاره الصحي؛ وأمَّا حين يتحوَّل إلى تعصب وخصومة، فهنا يبدأ الخلل.
لكن رغم أنَّ الاختلاف طبيعي وصحي، لماذا نخاف منه؟
ولماذا يشعر البعض أنَّ مجرَّد وجود رأي مخالف يُهدد مكانته أو يهز ثقته؟
في كثير من الحالات، لا تعود المشكلة للاختلاف نفسه؛ وإنَّما للطريقة التي نُربَّى بها على تقبُّل الرَّأي الآخر. وبعضنا نشأ على قاعدة أنَّ الاتفاق هو المعيار الوحيد للولاء، وأنَّ المخالف إنَّما هو ضد، لا مجرَّد مختلف.
إننا نخاف من الاختلاف أحيانًا؛ لأنَّه يكشف هشاشتنا الفكريَّة، أو لأننا لا نملك حججًا تدافع عن موقفنا، فنلجأ إلى إسكات الطَّرف الآخر بدل محاورته. وأحيانًا نخاف لأننا ربطنا آراءنا بأشخاص، فصرنا نعتبر النَّقد رأيًا فينا نحن، لا في الأفكار أو المواقف.
ولذلك، أصبح من النَّادر أن يُعبِّر أحد عن رأيه بارتياح، سواء في موضوع ديني، أو ثقافي، أو حتَّى رياضي بسيط، خشية أن يُفسَّر كلامه على أنَّه تهجم، أو اصطفاف، أو خيانة لطرف ما. مع أنَّ الاختلاف ليس ضعفًا، ولا خطرًا، ولا نقصًا؛ بل الخطر الحقيقي هو في كبت الرَّأي، وفي صناعة بيئة لا تتنفس فيها العقول بحريَّة.
حين يُكبت الرَّأي في المساحات الاجتماعيَّة البسيطة، كأن تقول رأيك في أداء نادٍ رياضي، أو تنتقد قرارًا في جمعيَّة أهليَّة، أو تبدي ملاحظتك على أسلوب أحد الخطباء أو الأكاديميين، فاعلم أنَّ هناك خللًا أكبر يتشكل بهدوء؛ فالنَّاس لم تعد تعبِّر كما كانت؛ لأنَّهم يخشون من التَّبعات؛ والتَّصنيف، والهجوم، من تحويل النقاش إلى معركة.
وصار البعض يفضل الصمت على أن يقول رأيًا قد يُغضب أحد المقربين، أو يُفهم خطأ، أو يُؤوّل على غير مقصده. وهكذا نخسر شيئًا فشيئًا بيئة النقاش، ونتحوَّل إلى مجالس يُحظر فيها الخروج عن ”الرَّأي السَّائد“.
وحين نصمت عن أبسط الأمور، كأن نقول: إنَّ رئيس هذا النَّادي لم يكن موفقًا، أو إنَّ رئيس هذه الجمعيَّة لم يُرضِ طموحاتنا، فمتى سنتكلم؟
وأنا أضرب هنا أمثلة بالنَّادي أو الجمعيَّة؛ لا لأنَّهم وحدهم من يستحقون النقد؛ بل لأنَّهم يمثِّلون صورة مصغَّرة لمدننا بأهلها ومواطنيها، ويكشفون لنا كيف نتعامل مع بعضنا عند أوَّل اختلاف.
إذا أردنا أن نعالج هذه الحالة؛ فالعلاج لا يبدأ من فوق؛ بل من تحت، من النَّاس، ومن المجالس، ومن المدارس، ومن النقاشات اليوميَة البسيطة. ونحتاج أن نُعيد الاعتبار لثقافة الحوار، لا أن نربِّي أبناءنا على أنَّ الصَّواب واحد، والرَّأي المخالف مرفوض. كما نحتاج إلى بيئة تسمع قبل أن تحكم، وتفهم قبل أن ترد، وتحترم الرَّأي الآخر حتَّى لو لم تقنع به.
العلاج يبدأ عندما نُفرّق بين ”الاختلاف“ و”الخلاف“، بين أن أقول رأيي وأحترمك، وبين أن أهاجمك؛ لأنِّي لم أوافقك. وحين نتعلَّم أن نقول: ”أنا لا أتفق معك، لكني أُقدِّرك“، بدل أن نقول: ”أنت ضدِّي، إذًا أنت عدوي“... هنا نكون قد بدأنا نخطو الطَّريق الصَّحيح.
كذلك، على القائمين على الأنديَّة، والجمعيات، والمؤسسات العامَّة، أن يتقبلوا النَّقد، لا أن يتحصنوا خلف جماعة ترد بالنيابة عنهم، أو تُخوّن من يعترض؛ فالمنصب العام لا يُقدِّس أحدًا، والرَّأي لا يُقصي أحدًا، وكرامة الإنسان لا تُمس لمجرد أنَّه خالف التَّيار.
من المسائل التي يغفل عنها كثير من النَّاس، أنَّ الاختلاف في رأي أو موضوع معيَّن لا يعني أننا سنختلف إلى الأبد. قد أختلف معك اليوم في موقف، وأتفق معك غدًا في آخر. وقد أرفض رأيك الآن، ثم أجد نفسي بعد أشهر أتّبع نفس الرَّأي عن قناعة وتجربة؛ فالآراء ليست أبديَّة، والعقول تنمو، والظروف تتغيَّر، والمواقف تتبدَّل. ولذلك، من الخطأ أن نحكم على الآخرين حكمًا قاطعًا لمجرَّد أنَّهم خالفونا في نقطة، أو لم يتفقوا معنا في لحظة.
إنَّ التَّباين في المواقف لا ينبغي أن يُفسد العلاقة، ولا أن يُلغي الاحترام؛ فكم من أصدقاء ومقربين اختلفنا معهم في تفاصيل، وبقينا نكنُّ لهم الودَّ والتَّقدير؛ ولكن اتفقنا معهم لاحقًا في ما هو أكبر وأهم.
دعونا نُعيد الاحترام للاختلاف، فهو ليس خصومة. وهو دليل وعي وتعدد في الزَّوايا. حين نسمح لأنفسنا ولغيرنا بالتَّعبير عن الرَّأي بحرية وأدب، نفتح بابًا لفهم أعمق، وربما نصل لحلول لم نكن نراها من زاويتنا وحدنا؛ لأنَّ المساحات التي تجمعنا في حياتنا العامَّة، سواء كانت رسميَّة أو شعبيَّة، يجب أن تبقى بيئة تواصل، لا ساحة خوف أو حسابات شخصيَّة، ثمَّ إنَّ الخلاف لا يفسد للودِّ قضيَّة، ما دام مبنيًا على احترام، ومتى ما تجاوزنا وهم الاتفاق الكامل، سنبدأ أولى خطواتنا نحو مجتمع أكثر نضجًا واتزانًا.