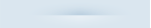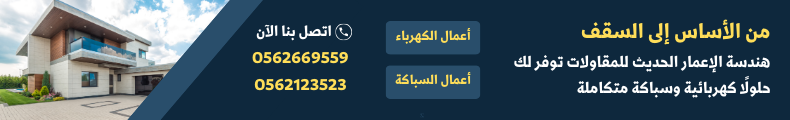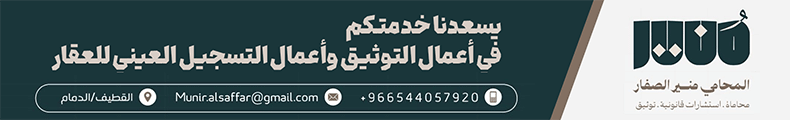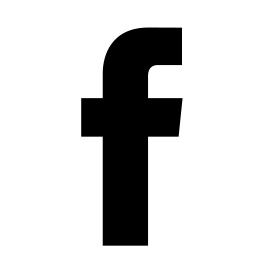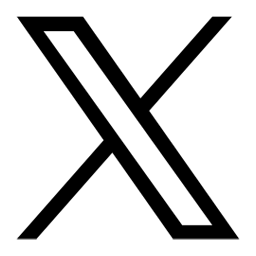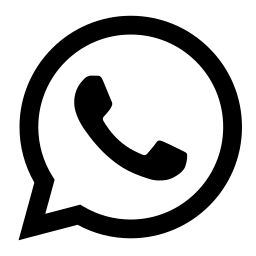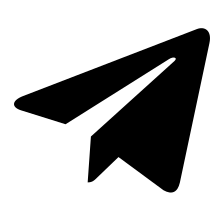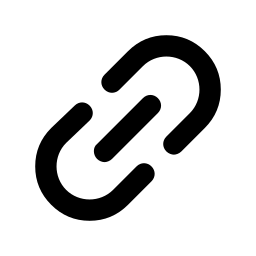أدونيس: بين التحدّي والإصغاء… شاعرٌ يحمل مجرّات من الفكر والإنسانية
من بين الأسماء التي لا تغادر الذاكرة الثقافية في الوطن العربي، يأتي اسم أدونيس متوهجًا ككوكبٍ يشعّ بالأسئلة قبل الإجابات، وبالقلق الخلّاق لا بالرضا الكسول. لم يكن علي أحمد سعيد إسبر، ابن قرية ”قصابين“ السورية، يعلم وهو يرعى غنم والده، أنه سيتحوّل إلى أحد أهم شعراء ومفكري العالم العربي في القرن العشرين وما بعده، وأن اسمه الجديد ”أدونيس“ سيصير مرادفًا للتمرد، التجديد، والعبور الحُر بين الأسطورة والواقع.
ولد أدونيس عام 1930، وسط بيئة بسيطة، حيث الحقول الخضراء والجبال التي تنحت في شخصية الطفل طقوس التأمل والانتماء للكون. عاش الطفولة في كنف أسرة فقيرة لكنها متشبعة بالتراث الشعبي والثقافة الشفوية. كانت والدته أمية، لكن والده علّمه القرآن والخطابة، مما جعله يلتقط منذ نعومة أظفاره نَفَس الشعر وروح اللغة.
مع بداية وعيه، بدأ أدونيس يكتب القصائد ويلقيها في المناسبات المحلية. لكن ما جعله يخطو أولى خطواته الحقيقية في طريق الشهرة، كان لقاؤه بالرئيس السوري شكري القوتلي، حين ألقى أمامه قصيدة وهو لا يزال شابًا، فتبناه وفتح له باب التعليم العالي، ليكمل دراسته في جامعة دمشق، ثم ينطلق بعدها نحو بيروت التي كانت وقتها عاصمة الفكر والثقافة العربية.
في بيروت، لم يكن أدونيس مجرد شاعر بل فاعل ثقافي. ساهم في تأسيس مجلة ”شعر“ الشهيرة إلى جانب يوسف الخال، والتي كانت من أولى المنابر التي رفعت شعار الحداثة الشعرية في وجه النموذج التقليدي. وهناك، بدأ أدونيس بنشر رؤيته الجديدة، حيث رأى أن القصيدة العربية بحاجة إلى ثورة في الشكل والمضمون، لا مجرد تحسينات تجميلية.
صدرت له دواوين عديدة منها:
”أغاني مهيار الدمشقي“،”أوراق في الريح“،”الكتاب“،وغيرها، التي مزج فيها الأسطورة بالتاريخ، والصوفي بالسياسي، مستخدمًا لغة كثيفة ومتوهجة.
وعلى المستوى الفكري، كانت سلسلة ”الثابت والمتحول“ بمثابة انقلاب في النقد الثقافي العربي، حيث أعاد النظر في مسار الثقافة العربية، بين ما هو راكد «ثابت» وما هو تجديدي «متحول». وكان صريحًا في نقده لبعض مظاهر الجمود في الفكر العربي والإسلامي، مما جلب له الكثير من العداء والجدل.
لم يكن الطريق مفروشًا بالورود لأدونيس. فقد وُوجِه بعنف إعلامي وثقافي، وتعرض لحملات تشويه ورفض، خصوصًا من بعض الأصوات المحافظة التي رأت في أطروحاته تهديدًا للمقدس أو للهوية.
واجه انتقادات حادة من شخصيات فكرية بارزة مثل عبد الله الغذامي، لكن ردوده لم تكن انفعالية، بل اتسمت بالتحليل والتماسك الفكري، مؤكدًا أن الشعر لا يُقاس فقط بمقاييس البلاغة القديمة بل بقدرته على طرح الأسئلة الوجودية.
أيضًا حين حصل على جائزة ”إيريش ماريا ريمارك“ للسلام، انهالت عليه الانتقادات من جهات عربية وأوروبية، إما بسبب مواقفه من الثورات أو تحليلاته للفكر الديني، لكنه ظل متمسكًا برأيه: أن الفكر يجب أن يُناقش لا أن يُكفّر، وأن الشعر هو وسيلة للحرية لا للتلقين.
رغم الصخب والجدل، استمر أدونيس في الترحال الثقافي، وحضر عشرات المنتديات والمؤتمرات في باريس، مدريد، القاهرة، عمّان، بيروت، وأخيرًا في الرياض، جدة، والطائف، حيث أُقيمت له أمسيات شعرية ومحاضرات فكرية ضمن موسم ثقافي سعودي.
في كل مكان يذهب إليه، يبهر الحاضرين بحديثه الهادئ العميق، ويترك أثرًا فكريًا في من يستمع إليه. كان حضوره في هذه المنتديات شاهدًا على أن الفكر، مهما اختلفنا معه، لا بد أن يُصغى إليه إذا أردنا أن ننهض بثقافتنا.
أكثر ما يُدهشك في أدونيس، ليس فقط عمق شعره أو جرأة فكره، بل تلك الهيبة المتواضعة التي تسكنه حين تتحدث إليه مباشرة.
التقيت به في إحدى المناسبات، وألقيت عليه كلمة شكر وتقدير. ما فاجأني هو طريقته في الإصغاء؛ لا يقاطع، لا ينشغل، لا يُشعرك أنك ”ثقيل الحديث“ بل العكس، بهدوء عينيه وابتسامته يردّك إلى جوهر الإنسان فيك.
أدونيس، برغم قامته الفكرية، يذكّرك أن العظمة الحقيقية لا تكتمل إلا بالتواضع.
في زمن التكرار والتسطيح، يبقى أدونيس استثناءً. شاعرًا لا يكتب من أجل التصفيق، بل من أجل المواجهة. مفكرًا لا يطلب الإجماع، بل يثير الشك الخلّاق. وإن كان البعض يختلف مع مواقفه أو لغته أو تحليلاته، فإن أحدًا لا يستطيع إنكار دوره في توسيع أفق الشعر العربي، وخلخلة بنيان الفكر الساكن.
وأنا، ككاتب وكمستمع، أجد في أدونيس صورة نادرة: رجلٌ يحمل مجرات فكرية، لكنه حين يجلس معك، يصغي كأنه يتعلم منك… لا كأنه يُلقي عليك محاضرة.
وتلك، في رأيي، إحدى علامات العبقرية.