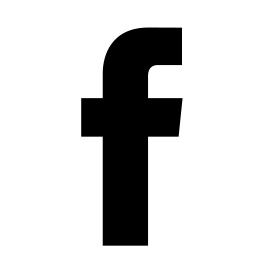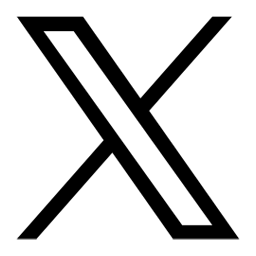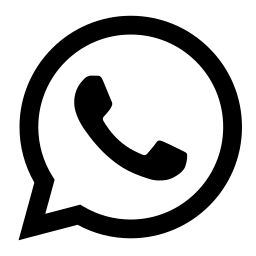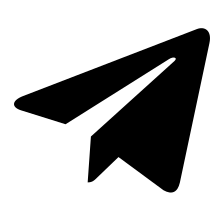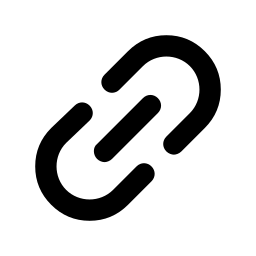الوطن… شجرة الظل وأغنية المسافة
يولد الإنسان وفي داخله موطن خفي، لا تحدّه الجغرافيا ولا تفسّره الخرائط، يسبق الجسد كما لو كان النَفَس الأول للروح. قد نرحل بعيدًا ونظن أننا نغادره، لكنه يظل فينا يقيس خطواتنا بميزان لا تراه العيون. إنه كيان ينبت فينا قبل أن نتجذّر فيه، ذاكرة تسبق الذاكرة، وحكاية وُجدنا فجأة في قلبها، فصرنا شخوصها ورُواتها معًا.
هو الصمت المعلّق على جدران البيوت القديمة، ورائحة التراب حين يتطهّر بالمطر، وصوت الأم يناديك باسمك قبل أن يولد النهار. ليس زمنًا يتساقط من عقارب الساعة، بل طفولة انسلت كالماء من بين الأصابع، وآباء غابوا كما تغيب المجرات في سديمها، وأحلام ما زالت تنتظر انبثاقها. إنه الحضن الذي يلمّ شتات الأزمنة في لحظة واحدة، كما لو أن الأبد قد طوى نفسه بين ذراعين.
وفي فلسفة الانتماء يتجلّى سؤال الوجود. فالإنسان في جوهره كائن مشرّد، يحمل غربة أبدية في قلبه، ويظل يفتّش عن مأوى يخفّف وطأة العدم. إنه محاولة الروح أن تشيّد طريقًا بين وحدتها وضجيج العالم، بين هشاشة الفرد وتطلّع الجماعة. غير أن الطريق قد يفقد شيئًا من صفائه، حين يتحوّل الحب إلى حنينٍ شفيف يرافق القلب كأغنية بعيدة، ويغدو الانتماء شوقًا هادئًا يفتح مسامه للندى، وتصير الهوية ملامح تبحث عن فسحةٍ أرحب. عندها ندرك أن ما نحمله في داخلنا ليس عبئًا، بل نغمةً رقيقة تتردّد في أرواحنا، تذكّرنا أن الحب والحنين هما سرّ البقاء، وأن الشوق هو الخيط الذي يشدّنا دومًا إلى جذورنا مهما ابتعدنا.
قد يظهر في المنافي قدرًا يتسلّل في لحظة حنين عابرة، حين تستيقظ رائحة مألوفة أو تنبعث نغمة قديمة فتوقظ ما اعتقدنا أنه انطفأ. هو وجع يضيء في القلب كلما استدعيت شارعًا لم تعد تخطوه، أو وجهًا صار غيابه أرسخ من أي حضور. ندبة الروح التي لا تندمل، لكنه الجرح الذي يتوهّج كلما حاول الزمن أن يطفئه، ليذكّرنا أن الألم أحيانًا ليس هزيمة، بل طريقًا إلى الخلود.
ومع ذلك، فالمعنى ليس ما مضى فحسب؛ قد يكون أيضًا ما لم يأتِ بعد: وعدًا يتقدّم نحونا، وإمكانًا نخبئه في صدورنا كشرارة لا تهدأ. إنه المستقبل بقدر ما هو الماضي، المساحة التي نخطّها بقيمنا وعدالتنا، ونُشعلها بجرأتنا على أن نكون أكثر إنسانية. ليس فقط ما كان، وإنما ما ينبغي أن يكون: أفقًا يفتح على المعنى، لا سورًا يصدّه.
وفي خاتمة الأمر، يبقى سؤالًا يتردّد بلا جواب.