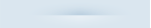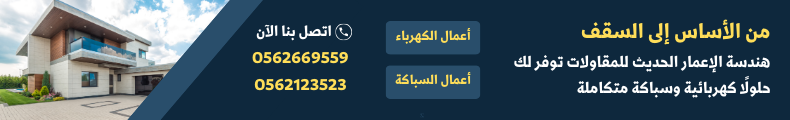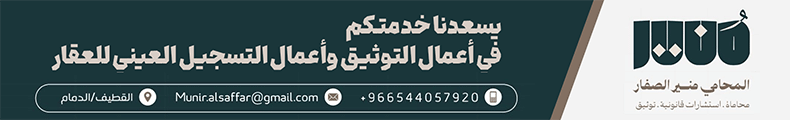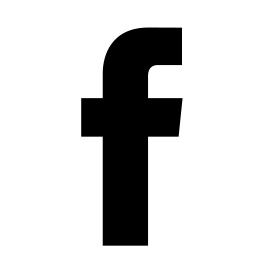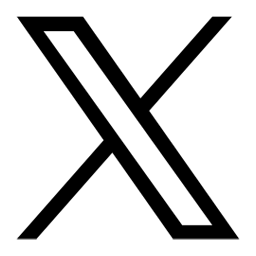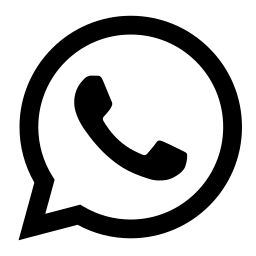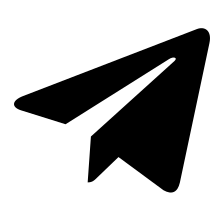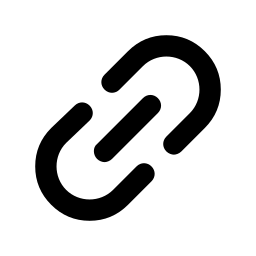العقل.. المجهول الحاضر
تخيل أنك اقتنيت جهازًا متقدّمًا تقنيًا، يمتلك إمكانيات هائلة، لكنك لا تستخدم من تلك الإمكانيات سوى أقلّ القليل! بل تكتفي بما يعمل تلقائيًا دون أن تغوص في أسراره أو تكتشف ميزاته. عندها، ستكون مدركًا تمامًا أن استفادتك محدودة، لا لضعف في الجهاز، بل لضعفٍ في معرفتك به.
وهكذا هو الحال مع الإنسان؛ فما لم يُحسن التعرّف على الهبات الإلهية التي أودعها الله فيه، ثم يعرف كيف يستثمرها، ويستخدمها في الطريق الذي يوصله إلى سعادته في الدنيا والآخرة، فسيظل يعيش دون أن يلامس عظمة ما خُلق له.
إن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، وجعله أكرم المخلوقات وخصّه بهبةٍ ساميةٍ غُرست في أعماق ذاته الإنسانية، لم تُمنح لأيٍّ من المخلوقات سواه، تلك الهبة هي: العقل.
والعقل ذلك المخلوق الباطني الذي وصفه الله بأنه أعظم خلقه، ظلّ محاطاً بتشويشٍ بسبب ما تعرّض له من تسامحٍ مفهومي مع عناصر أخرى تشاركه بعض الملامح، لكنها تبقى مغايرةً له في الجوهر. وقد أنتج هذا التسامح فوضى معرفية في الوعي الجمعي، نتج عنها خلطٌ بين العقل وغيره من مكوّنات الذات الإنسانية.
وحين نُمعن في الخطاب الجماهيري، نلحظ تساهلًا لافتًا في توظيف المفاهيم، حيث تُستعمل ألفاظ متباينة بمعانٍ متقاربة أو بالعكس، دون تدقيقٍ لغويّ أو تمييزٍ معرفيّ. ونقصد بـ ”التسامح المفهومي“ الخلط غير الواعي بين المفاهيم المتمايزة، أو استخدام مصطلحات مختلفة للإشارة إلى معنى واحد، مما يُربك الفهم ويشوّه الإدراك. وهو - بحق - كارثة معرفية تضعف من صفاء التفكير، وتهزّ أركان الفهم السليم، وتُفقد الإنسان القدرة على التمييز الدقيق بين المعاني.
ومن أوضح مظاهر هذا الخلط ما يتردّد على الألسن من عبارات مثل: ”أنا أفكر بعقلي“، أو ”عندي عقلٌ أفكر به“، وهنا يتجلّى الخلط بين العقل والتفكير، فالعقل شيء، والتفكير شيء آخر، والفكر نتاج عملية ذهنية مستقلة.
فالتفكير هو فعلٌ يقوم به الذهن من خلال معالجة المعلومات القادمة من البيئة أو المسترجعة من الذاكرة، وهو عملية تلقائية لا تنفكّ عن الإنسان لحظة واحدة. وقد عبّر الفيلسوف ديكارت عن ذلك بقوله: ”أنا أفكر، إذًا أنا موجود“. فالتفكير هو حركة الذهن، أما العقل فله مقامٌ أرفع ووظيفة أخرى تمامًا.
ومن مظاهر الخلط المفهومي أيضًا التباس العلاقة بين العقل والقلب. فكثيرًا ما نسمع شخصًا يقول: ”أنا حائر بين عقلي وقلبي“، بينما المسألة أدق من ذلك؛ فالصراع الحقيقي غالبًا ما يكون بين العقل والنفس، وليس بين العقل والقلب.
فالنفس بطبيعتها تميل إلى تلبية الرغبات، بينما العقل ينظر في العواقب، وما فيه مصلحة الإنسان على المدى الطويل، أما القلب الوجداني، الذي يمثل مركز الإرادة، فهو الذي يُصدر القرار النهائي بناءً على التجاذبات بين العقل والنفس.
والقلب الوجداني يواجه ضغوطًا متعددة؛ فمن جهة، هناك النفس الجامحة التي تتأثر بالهوى، وتزداد قوتها بتدخل الشيطان الرجيم إذا كان في الأمر ميلٌ للرغبات المحظورة. ومن جهة أخرى، هناك تدخلات خارجية قد تدفع لاتخاذ قرار معين، وفي النهاية، يتخذ القلب القرار، سواء كان عقلانيًا، أو عاطفيًا، أو مزيجًا بينهما، بعد نشاط ذهني معقّد يجمع بين تأثير العقل والنفس.
وقد عبّر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  عن هذا الصراع بكلامٍ بليغ، حيث قال
عن هذا الصراع بكلامٍ بليغ، حيث قال  : «العقل صاحب جيش الرحمن، والهوى قائد جيش الشيطان، والنفس متجاذبة بينهما، فأيهما غلب كانت في حيزه» ”ميزان الحكمة، محمد الريشهري، ج: 3، ص: 2038“.
: «العقل صاحب جيش الرحمن، والهوى قائد جيش الشيطان، والنفس متجاذبة بينهما، فأيهما غلب كانت في حيزه» ”ميزان الحكمة، محمد الريشهري، ج: 3، ص: 2038“.
وهذا القول البليغ يصف بدقة حالة النفس البشرية، التي تتأرجح بين منطق العقل المستنير بتعاليم الرحمن، ورغبات الهوى التي يعززها الشيطان الرجيم، وتوضح أهمية الغلبة لأي منهما في توجيه مصير الإنسان.
ورغم هذا التمايز بين العقل والقلب الوجداني نجد أن الخطاب العام، كثيرًا ما يُبسّط هذه العملية وتُستخدم العبارات بشكلٍ تسامحي دون إدراكٍ دقيقٍ لمعانيها، وهذا التسطيح للمفاهيم له آثار وخيمة على مستوى الوعي والإدراك والمعرفة.
وهكذا تتجلّى عظمة هذا الكائن غير المرئي: العقل، فهو ليس أداة للتفكير، بل هو القوّة التي تُوجّه المخ نحو التفكير، وتفصل بين الحق والباطل، وتُرشد الإنسان إلى الخير والصواب.
إنه مخلوقٌ لطيف لا يُدرك بالحواس، بل يُلمس أثره في التمييز والاختيار، وفي الاستجابة لنداء الفطرة ونداء القيم.
ومن هنا نفهم السرّ في أن ”العقل“ لم يُذكر في القرآن الكريم كمفهومٍ مجرد، بل جاء الحديث عنه عبر آثاره وتجلياته، كقوله تعالى: ﴿قد بيّنا لكم الآيات لعلكم تعقلون﴾ [آل عمران، 118]؛ وقوله تعالى: ﴿إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون﴾ [الأنفال، 22]، وقوله تعالى: ﴿وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون﴾ [العنكبوت، 43]، وفي كل هذه الآيات تتكرّر الإشارة إلى ”العقل“ لا بوصفه وجودًا في ذاته، بل من خلال مفاعيله في الفهم والاستجابة والتمييز.
وهذا ما يُؤكّد حقيقةً جوهرية: أن العقل ليس هو الدماغ، ولا هو العمليات الذهنية التي يُجريها، كما أنّه ليس القلب بمفهومه العضوي أو الوجداني. إنّه وجودٌ مستقلٌّ بذاته، مختلفٌ عن هذه الأدوات، وإنْ تفاعل معها.
فالعقل لا يُدرك بكينونته المجرّدة، بل يُستدلّ عليه من خلال أثره في السلوك الإنساني، وفي بصمة الوعي التي يتركها في القرارات والمواقف.
إنّه نورٌ داخليّ، تتجلّى إشراقاته في مسار الإنسان، وتوجّهاته، وطريقة تعاطيه مع ذاته، ومع الحياة، ومع الوجود بأسره.