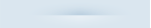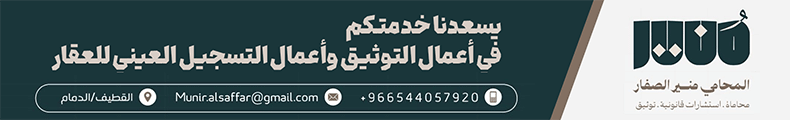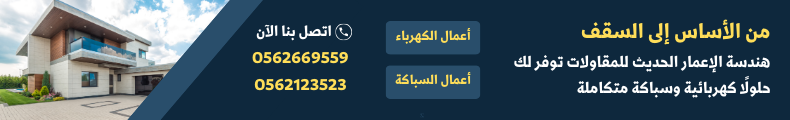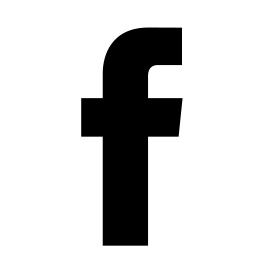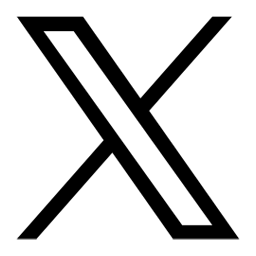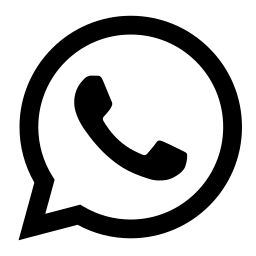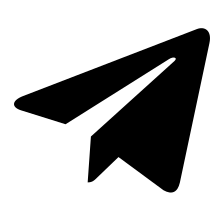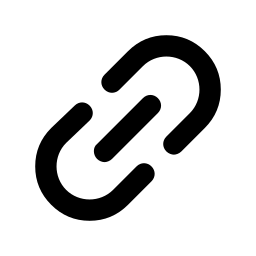الفكر الإسلامي ومقتضيات المرحلة المعاصرة.. حوار مع المفكر زكي الميلاد

يحتل النقاش حول تجديد الفكر الإسلامي موقعًا مركزيًا في ساحة الفكر العربي والإسلامي المعاصر، باعتباره ضرورة ملحة لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، والاستجابة للتحديات الحضارية الكبرى التي تواجه الأمة. لا يدور هذا النقاش حول قطيعة مع التراث، بل يسعى إلى إعادة قراءته وتفعيله ليصبح قادرًا على الإجابة عن أسئلة الحاضر واستشراف المستقبل.
في هذا السياق، تبرز إسهامات المفكرين الذين كرسوا جهودهم لبناء منهجيات أصيلة قادرة على فهم الواقع المعقد وتفكيك إشكالياته من منظور إسلامي متجدد. ومن بين هؤلاء المفكرين يبرز اسم فضيلة الأستاذ زكي الميلاد، الذي يُعد واحدًا من الأصوات الفكرية المهمة التي اهتمت بقضايا التجديد والإصلاح في الفكر الإسلامي المعاصر.
إضافة إلى هذه المؤلفات فقد التزمت بكتابة مقالة فكرية أسبوعية امتدت لسنوات طويلة مع عدد من الصحف السعودية والعربية، مثل صحيفة ”عكاظ“ التي نشرت فيها لأكثر من عشر سنوات متصلة، كما نشرت بهذا الالتزام الأسبوعي في صحيفتي ”اليوم“ و”الرياض“ السعوديتين، وصحيفة ”الغد“ الأردنية. إلى جانب النشر المستمر في عدد من المجلات والدوريات الفكرية المحكمة وغير المحكمة.
كما توليت رئاسة تحرير مجلة ”الكلمة“ وهي مجلة فكرية فصلية تعنى بشؤون الفكر الإسلامي وقضايا العصر والتجدد الحضاري، وقد مضى عليها ما يزيد على ربع قرن من الزمن وما زالت تواصل عطائها الفكري، مسجلة حضورا فكريا يستحق التنويه، خصوصا وأنها من المجلات الفكرية غير الحكومية القليلة التي حافظت على بقائها واستمراريتها. وفي هذا الشأن كذلك فإني اسمي موجود في الهيئة الاستشارية لأكثر من عشر مجلات فكرية مشرقية ومغربية.
وضمن هذا السياق الفكري حضرت بعض نصوصي وأطروحاتي في مناهج التعليم العام والعالي في عدد من البلدان العربية مشرقية ومغربية، من هذه البلدان: الإمارات العربية المتحدة فقد حضرت نظرية ”تعارف الحضارات“ في كتاب التاريخ المقرر الدراسي لمرحلة الصف الحادي عشر لسنة 2009 م، ضمن فقرة بعنوان: ”نظرية تعارف الحضارات من وجهة نظر زكي الميلاد“ وتعلق بهذه الفقرة نشاط على هيئة أسئلة لتنمية مهارة التشابه والاختلاف. وفي المملكة العربية السعودية حضر لي نصين في كتاب ”التفكير الناقد“ المقرر الدراسي لمرحلة الصف ثالث متوسط لسنة 2021 م، في درس بعنوان ”التفكير الناقد وطرح الأسئلة“، النص الأول بعنوان ”دهشة السؤال“، والثاني بعنوان ”ما الدهشة“، وتعلقت بهما مجموعة من الأسئلة. وعلى مستوى التعليم العالي أدرجت نظرية تعارف الحضارات في جامعات الجزائر في مادتين على مستوى مرحلة الماستر هما: مادة ”فلسفة عربية وإسلامية“ ومن محتوياتها فقرة بعنوان ”تعارف الحضارات عند زكي الميلاد“، ومادة ”فلسفة تطبيقية“، ويقدم فيها فقرة بعنوان ”أطروحة تعارف الحضارات“.
وتتمة لهذه السيرة الفكرية فقد أنجزت حول افكاري وأطروحاتي ما يزيد على خمس عشرة رسالة جامعية في بلدان مشرقية ومغربية منها العراق وتونس والجزائر والمغرب بالإضافة إلى إيران، كما قُدمت محاضرات وأوراق بحثية عن أفكاري وأطروحاتي أيضا في بلدان منها السعودية والعراق ومصر والجزائر والمغرب.
وإذا أردنا تحليل مشكلة الفكر العربي الإسلامي وتعثره المستمر، يمكن الإشارة إلى ثلاثة عناصر أساسية، هي:
أولا: مشكلة الفكر من ناحية المؤسسة، ونعني بها المؤسسة التي تنتج الفكر ويتصل بها الفكر ولا ينقطع وجودا وبقاء، وتتحدد هذه المؤسسة في جهتين هما: المؤسسة الدينية ومؤسسة الجامعة، فهناك أزمة في هاتين المؤسستين في ناحية صناعة المعرفة وتوليد الفكر، فهذه الأزمة ولدت أزمة في الفكر العربي الإسلامي. وبهذا المعنى فإن مشكلة الفكر العربي الإسلامي ليست مشكلة ذاتية وبنيوية وإنما هي مشكلة مؤسساتية.
ثانيا: مشكلة الفكر من ناحية تقدم العلم، والسؤال: هل يتقدم الفكر من دون تقدم العلم، أم أن تقدم الفكر يتوقف على تقدم العلم؟ لا شك أن تقدم العلم يدفع بقوة إلى تقدم الفكر، إذ يوفر له أرضيات التقدم، ويزوده بالخبرات العلمية والتجريبات والاكتشافات التي يقف عليها الفكر وبها يتماسك، ومنها يتحفز وينطلق. وهذا ما برهنت عليه التجربة الغربية الحديثة التي ظل العلم فيها يقود تقدم الفكر، ومن دلائل ذلك مقولة ”لولا نيوتن لما كان كانت“، فقد أسس كانت فلسفته وشيد بنيانها وأقام قواعدها على أساس فيزياء نيوتن وكشوفته العلمية. وقياسا على هذه المقولة توصلت إلى مقولة أخرى تطابقها في الصدق العلمي والموضوعي وهي ”لولا أينشتاين لما كان كارل بوبر“، وقد نشرت مقالة تشرح صدقية هذه المقولة مقارنة مع المقولة السابقة. وبهذا المعنى فإن مشكلة الفكر العربي الإسلامي هي في عمقها مشكلة تتصل بأزمة العلم في عالمنا العربي والإسلامي.
ثالثا: مشكلة الفكر من ناحية تقدم الحياة، لا شك أن طبيعة الحياة تقدما وتراجعا تفرض منظوراتها على حركة الفكر، فكلما تقدمت الحياة حفزت الفكر نحو التقدم، وكلما تراجعت الحياة قلصت فرص الفكر نحو التقدم. لذا لا يمكن قياس حركة الفكر في بلد مثل ماليزيا مع بلدان مثل اليمن أو السودان أو سوريا أو غيرها. وبهذا المعنى فإن مشكلة الفكر العربي الإسلامي لا تنفصل ومشكلة تراجع الحياة في البلدان العربية.
وتتأكد مثل هذه المراجعات بالنسبة إلى الفكر العربي الإسلامي خصوصا في ظل هذه الأزمنة المعاصرة، ومع انبعاث أخطر ظاهرة في تاريخ عالم الإسلام برمته، وهي الظاهرة الداعشية التي لا تعادلها ولا تقارن بأي ظاهرة أخرى مهما عظمت في التاريخ الإسلامي، فقد مثلت تركيبا هجينا مكونا من ثلاثة عناصر خطيرة هي التطرف والتكفير والتوحش، فأنتج هذا التركيب مزيجا مخيفا وقبيحا يمكن وصفه بالهمجية والبربرية.
الأمر الذي يعني أن مع هذه الظاهرة انبعثت الهمجية في ساحة المسلمين وتصاعدت وتعاظمت، فهل من الممكن وهل نصدق أن تظهر الهمجية في ساحة المسلمين، قبل داعش كان من الصعب تصديق هذا الأمر، أما بعدها فقد أصبح في حكم الواقع الفعلي ليس توهما ولا تصنعا. وهذا الوصف ليس على سبيل المبالغة وإنما على سبيل الحقيقة والحقيقة التامة، فهل هناك همجية أكثر من همجية هذه الجماعة من الناس التي عرفت نفسها بالقتل والتدمير والتخريب والتوحش المسرف والمخيف والمرعب.
وتتعاظم الدهشة أمام هذه الظاهرة، كونها انبعثت مع مطلع القرن الجديد، فنحن استقبلنا القرن الحادي والعشرين بهذه الظاهرة التي نعدها أخطر ظاهرة في تاريخ الإسلام، ومثلت أعظم نكسة في تاريخ الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر. بينما استقبل العالم هذا القرن متباهيا بإنجازاته العظيمة في ميادين العلم والتقنية والصناعة والطب والهندسة والاتصالات والمعلوماتية، وهكذا في الميادين الأخرى.
لذا كان ينبغي أن يكون لهذه الظاهرة وقع الصدمة والصدمة المدوية في المجال الديني الإسلامي، الصدمة التي يترتب عليها القيام بمراجعات عميقة في بنية الفكر الديني للتخلص من بنية هذه الظاهرة وتقويض أركانها، وسد الطريق نهائيا على انبعاثها مرة أخرى. لكن مثل هذه المراجعات لم تحدث فعليا!
وفي هذا النطاق طرحت نظرية جادة ومهمة أطلقت عليها تسمية ”بناء النظرية الدينية النقدية“، أردت منها أن تنهض بهذا الدور، وتنصبُّ عليه بتركيز شديد، مقدرا أننا بحاجة إلى نظرية تستوفي مقوِّمات النظرية وشروطها المنهجية والمعرفية، وليس لمجرَّد خُطب أو مواعظ أو بيانات أو كلمات بيانية ولسانية ووعظية. مع شرط النقد في النظرية، فلسنا بحاجة لأيَّة نظرية، وإنما نحن بحاجة لنظرية نقدية لها فعالية نقدية، وتنتسب إلى المجال الديني، وتُعرف بصفة النظرية الدينية النقدية، وتكون متخصِّصة في تفكيك الظاهرة الداعشية، والتخلُّص منها كليًّا.
ومن خلال منطق الاجتهاد يمكن التنبه في الخطوة الأولى إلى إدراك الحاجة إلى مثل هذه المراجعات وعدم التغافل عنها أو عدم الالتفات إليها، وفي الخطوة الثانية الإقدام على هذه المراجعات وعدم التردد أو التخوف أو التشكك، وفي الخطوة الثالثة امتلاك حس التبصر في هذه المراجعات ببذل الجهد واستفراغ الوسع وإعطاء العقل أقصى درجات الفاعلية، وذلك لتحصيل أعلى مستويات النفع من هذه المراجعات.
وفي مستوى التطلعات الحضارية للأمة، بمعنى أن أفق هذه المراجعات ينبغي أن يكون عاليا وبعيدا ويرتقي إلى مستوى التطلعات الحضارية، متخطيا المستويات السطحية والضيقة والمحدودة، ومتجها نحو الانتقال بالأمة من وضعيات التراجع والتخلف والصعود بها إلى وضعيات التقدم والتحضر.
ومن خلال المراجعات الاجتهادية وإعمال منطق الاجتهاد نستطيع التثبت من بلوغ هذه التطلعات الحضارية، والسير في دربها الطويل، وهذا هو وجه العلاقة بين هذين الأمرين.
ويفهم من هذا الكلام أن المراجعات الاجتهادية هي مهمة كبيرة ومعقدة وليست مهمة سهلة أو بسيطة، لذا فإن من ينهض بها هم أهل الصفوة في الأمة من العلماء والعقلاء والحكماء، الذي يعرفون بحس التبصر، وسعة النظر، وبعد الأفق، وتنور العقل، ورجحان الحكمة. ولكي تتسهل علينا هذه المهمة ونتلمس طرائقها وخطواتها ومنهجياتها فنحن بحاجة إلى ما عرف في هذه الأزمنة الحديثة بفقه المراجعات، لكي تكون المراجعات عن فقه يستند إلى قواعد وضوابط، ويتولد من تبصر وتحقيق.
وهناك معركة فكرية خطيرة لها علاقة بناحية الوعي والثقافة والفكر تعرف بمعركة المفاهيم، وفيها تحاول الأمم الغالبة فرض مفاهيمها على الأمم المغلوبة، والأمم المتقدمة تحاول فرض مفاهيمها على الأمم المتخلفة، والثقافات العالية تحاول فرض مفاهيمها على الثقافات البدائية، وهكذا تجري معركة المفاهيم بقصد التأثير الفكري على الأمم والمجتمعات والثقافات.
وعلى مستوى التطبيق، فقد كانت لدي بعض المحاولات في هذا الشأن، من هذه المحاولات العمل على بناء مفهوم يتعلق بنمط العلاقة بين الحضارات، أطلقت عليه تسمية ”تعارف الحضارات“ وقد طرحته بهذا النحت البياني سنة 1997 م، وقمت بالتأسيس الاجتهادي له، واستندت في تكوينه إلى أصل قرآني، تحدَّد في الآية التي سمَّيتها آية التعارف، الواردة في سورة الحجرات في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ ، فقد جاءت هذه الآية وقررت مقصد التعارف بين الناس كافة شعوبًا وقبائل، وتقرر هذا المقصد التعارفي متصلا بنسق من المبادئ الإنسانية الكلية والعامة التي تضمنتها الآية الكريمة متوافقة مع الأفق الإنساني العام، وهي: توجه الخطاب إلى الناس كافة وليس إلى المؤمنين خاصة بلسان: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ بما يشمل جنس الناس بكل تنوعاتهم العرقية والقومية، اللغوية واللسانية، الدينية والمذهبية، الذكورية والأنثوية، وتذكير بوحدة الأصل الإنساني ”إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى“، وإقرار بقاعدة التنوع الإنساني ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ﴾ ، وتأكيد على مبدأ الكرامة الإلهية ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ آللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ . الأمر الذي يعني أن الأصل في العلاقات بين الناس كافة هو التعارف، ولأن التعارف بين شعوب وقبائل، أي بين جماعات ومجتمعات وليس بين أفراد، فيصح انطباقه على جميع أشكال الجماعات الإنسانية وأنماطها، ومنها الحضارات التي هي أكبر أشكال هذه الجماعات الإنسانية.
وما إن عُرف هذا المفهوم، حتى أخذ طريقه سريعًا إلى المجال التداولي، ونال شهرةً واسعةً، واكتسب اهتمامًا كبيرًا، وشهد تطوُّرًا متراكمًا، وما زال محافظًا على هذه الوتيرة الصاعدة، وقد تجاوز مرحلة بناء المفهوم، وبات معروفًا ومُتحرِّكًا في حقل الدراسات الحضارية. وقد تشكَّلت له سيرة في أبعاد متعدِّدة، فعلى مستوى التأليف صدرت حوله العديد من التأليفات الفكرية العربية، وعلى مستوى النشر الفكري والأكاديمي، فقد حظي هذا المفهوم بالعديد من الدراسات والأبحاث المنشورة في مجلات فكرية محكمة وغير محكمة، كما أصبح موضوعًا للعديد من الرسائل والأطروحات الجامعية المنجزة على مستوى الماستر والماجستير والدكتوراه، أما التطوُّر الأهم في هذا الشأن، فقد تمثَّل في إدراج هذا المفهوم في مناهج التعليم على ثلاثة مستويات الثانوي والجامعي والتدريبي.
وشرحا لهذا المفهوم وضبطا وتقعيدا، فقد أعددت ثلاثة مؤلفات، الأول صدر سنة 2006 م بعنوان: ”تعارف الحضارات“ جمعت فيه المقالات المنشورة عربيا حول هذه النظرية، والثاني صدر سنة 2014 م بعنوان: ”تعارف الحضارات.. رؤية جديدة لمستقبل العلاقات بين الحضارات“ ويضم الأوراق المقدمة في المؤتمر الدولي الذي نظمته مكتبة الإسكندرية سنة 2011 م بالتعاون مع مركز الحوار في الأزهر الشريف ومركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، والثالث صدر سنة 2024 م بعنوان: ”تعارف الحضارات.. سيرة الفكرة وكيف تطورت“.
وفي هذا النطاق أيضا، أصدرت في سنة 1998 م كتابًا بعنوان: ”الجامع والجامعة والجماعة.. دراسة في المكوِّنات المفاهيمية والتكامل المعرفي“، نشره في القاهرة المعهد العالمي للفكر الإسلامي، صدر ضمن سلسلة المفاهيم والمصطلحات، تناولت فيه ثلاثة مفاهيم لأول مرة يتمُّ الجمع بينها والاقتران، وقمت بدراستها بطريقة معرفية تحليلًا وتركيبًا وتكاملًا، وهي مفاهيم: الجامع والجامعة والجماعة. إلى جانب محاولات أخرى.
ومن أصول هذه المنهجية وقواعدها أيضا، ما يتعلق بجانب اللغة، فالقرآن الكريم اختار لغته، وتعينت في اللغة العربية، ونص على ذلك في آياته، مبرزا هذا الأمر ومؤكدا عليه، ومن هذه الآيات قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [سورة الزخرف، آية 3]، وقد أصبحت هذه اللغة تمثل السبيل الوحيد لتكوين المعرفة به، ولا سبيل آخر على الإطلاق يحل مكان هذه اللغة، ولن يتغير هذا الأمر أبدا لا مع تقادم الأيام، ولا مع تعاقب الأجيال، ولا مع تراكم المعارف، ولا مع تغير وضعيات الأمة والعالم تقدما وتراجعا.
ومن أصول هذه المنهجية وقواعدها، ربط المفاهيم بالتفهيم والعمل معا، لا بالتفهيم منقطعا عن العمل، ولا بالعمل منقطعا عن التفهيم، والتفهيم مقدمة إلى العمل، والعمل تطبيق إلى الفهم والتفهيم، ونلمس هذا الأمر من كلمات ”يعقلون ويتفكرون ويفقهون ويتذكرون وتعلمون...“، التي وردت مرارا وتعينت في خواتم الآيات لمقصديتها. والتفهيم يراد منه تجنب التصعيب والتعقيد، والعمل يراد منه التجسيد والتطبيق.
ومن أصول هذه المنهجية وقواعدها، ربط المفاهيم بشرطي الحال والمآل، لا بشرط الحال بعيدا عن شرط المآل، ولا بشرط المآل بعيد عن شرط الحال. وشرط الحال ناظرا لعصر المخاطبين، فلا بد أن يكون هناك مخاطبون يتعقلون الخطاب في عصرهم ويطبقون له. وشرط المآل ناظرا لعصور ما بعد هؤلاء المخاطبين، ليكون خطابا لكل المآلات. وفي هذا النطاق تأسست بعض القواعد لتقعيد هذا المعنى، منها قاعدة ”المورد لا يخصص الوارد“، وقاعدتا ”العموم والإطلاق“، إلى جانب قواعد أخرى.
ومن أصول هذه المنهجية وقواعدها، ربط المفاهيم ببقاء المعنى ورسوخه، فلا توجد في القرآن كلمة خالية من المعنى، أو يتوقف منها المعنى أو ينخفض أو يتقلص، فالمفهوم ينبغي أن يتسم بشرط المعنى ورسوخه. هذه بعض القواعد الدالة على منهجية القرآن الكريم في ضبط المفاهيم، وهناك قواعد أخرى.
وأما مفهوم الاجتهاد فإن له سيرة طويلة في تاريخ الثقافة الإسلامية، وقد ارتبط مجاله التداولي في الأزمنة القديمة بالفقه والفقهاء، واضعين له معنى وظيفيا محددا ينسجم مع حقلهم الفقهي، قاصدين به بذل الجهد واستفراغ الوسع في تحصيل الحكم الشرعي من أدلته التفصيلية، وفي الأزمنة الحديثة اتسع نطاقه وامتد إلى المجالات الفكرية، بناء على التفريق بين النظر الخاص المنحصر بالفقه والمجال الفقهي، والنظر العام المتسع والمتصل بالمجالات الأخرى.
وبالنسبة إلى مفهوم التجديد فقد ارتبط في تاريخ الثقافة الإسلامية بشأن الدين تجديدا لأمره في الأمة، عملا بالحديث المروي ”إن الله يبعث لهذ الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها“، أو ”أمر دينها“. وقد اتسع نطاق هذا المفهوم ومداه في هذه الأزمنة المعاصرة، متصلا بمجال الفكر الديني، قاصدين به التجديد في الفكر وليس الدين.
ومن بين هذه المفاهيم الثلاثة، توقفت كثيرا عند مفهوم الاجتهاد فحصا وتبصرا، وكونت نظرية في هذا الشأن، فقد رأيت أن الاجتهاد يعدُّ أحد أهم المفاهيم الذي ابتكرته الثقافة الإسلامية، وانفردت به الحضارة الإسلامية، إذ نشأ وتطوَّر في ظل هذه الحضارة، وترك تأثيرًا مهمًّا في تطوُّر ثقافة المسلمين ومعرفتهم، وبفضله استطاع المسلمون في عصرهم الأول تحقيق ما حقَّقوه على مستوى تأسيس العلوم، واكتشاف المناهج، وابتكار النظريات، وتصنيف تلك التأليفات الرائدة والخالدة في ميادين التفسير والفقه واللغة والتاريخ والكلام والفلسفة والعلوم. كما أنه المفهوم الذي ألهم علماء المسلمين شجاعة النظر، وعزيمة الكشف، وجسارة الإقدام، وامتلاك ناصية العلم، والتخلص من أوهام الرهبة والهيبة، ومن أصنام التبعية والتقليد.
لذا وجدت أن هذا المفهوم بحاجة إلى إعادة اكتشاف من جديد، لتأكيد مركزيته في الثقافة الإسلامية، واستظهار قوة حقله الدلالي، والاستلهام من روحه الخلَّاقة، واستحضار إرثه العلمي العظيم، والتزود من يقظته وفاعليته. بهذا الأفق نظرت إلى هذا المفهوم، وبهذا الإدراك تعاملت معه، وجعلت منه مفهومًا حاضرًا لا يغيب عن ذهني وتأمُّلاتي.
إن تركيز النظر على هذا المفهوم، والاشتغال عليه بهذا الأفق المعرفي الفاحص، أوصلني إلى بلورة نظرية تحدَّدت في إطار المقاربة بين الحداثة والاجتهاد، إذ وجدت أن الاجتهاد في المجال الإسلامي هو المفهوم الذي يعادل أو بإمكانه أن يعادل مفهوم الحداثة في المجال الغربي، وذلك لكون أن مفهوم الحداثة يتكوَّن من ثلاثة عناصر أساسية وجوهرية وثابتة هي: العقل والعلم والزمن، وهذه العناصر الثلاثة بتمامها من مكوِّنات مفهوم الاجتهاد. وقد شرحت هذه القضية في كتابي ”الفكر والابتكار“.
أما دائرة التجديد فإنها تتعلق بالعقل، بحيث نضيف إليه منهجا جديدا، أو أن نستعيد مناهجه القادرة على العطاء. وبذلك يتضح أن دائرة الإصلاح تتعلق بالعقائد، وإذا تعلق الأمر بتغيير المجتمع بحيث تستنهضه، فنحن في دائرة الإحياء، وإذا تعلق الأمر بالعقل وفاعلياته، فنحن في دائرة التجديد. ما هو تصوركم حول هذا التفريق؟ وهل بالفعل دائرة مفهوم الإصلاح تأتي مقتصرة على مجال العقيدة؟ وما مدى قرب أو بعد هذا الفهم من مفهوم الإصلاح القرآني؟
وعند التفحص والتبصر نرى أن الإصلاح مورده التطبيقي العام يتعلق بوجود خلل أو اعوجاج أو فساد، وهذا التعلق لا ينحصر في نطاق العقيدة وإنما يشمل النطاقات كافة، فقد يحدث في النطاق الاجتماعي فيستوجب إصلاحا متعينا في هذا النطاق متحددا بصفة الإصلاح الاجتماعي، وقد يحدث في النطاق الثقافي فيستوجب إصلاحا متعينا في هذا النطاق متحددا بصفة الإصلاح الثقافي، وقد يحدث في النطاق الاقتصادي فيستوجب إصلاحا متعينا في هذا النطاق متحددا بصفة الإصلاح الاقتصادي، وهكذا في باقي النطاقات الأخرى، وذلك لأن جميع هذه النطاقات تكون معرضة إلى حدوث خلل أو اعوجاج أو فساد يستوجب الإصلاح.
وأما الإحياء فمورده التطبيقي العام يتعلق بوجود حالات من موات أو خمول أو انقطاع، تحدث مع تقادم الأيام، وتدخل في دائرة الإهمال لفترة من الزمن، الوضع الذي يستدعي أمر الإحياء بعثا ويقظة وصحوة، ترفع الموات، وتزيل الخمول، وتصل ما انقطع.
وبالنسبة إلى التجديد فإن مورده التطبيقي العام يتعلق بوجود البلى أو القدم الذي يتطاول أمده، فتأتي الحاجة إلى التجديد لرفع هذا البلى وإزالة هذا القدم.
وبهذا تتكشف الصورة العامة لهذه المفاهيم الثلاثة وطبيعة متعلقاتها التطبيقية، وكيف أنها تجري في النطاقات كافة. ففي نطاق العقيدة يجري مفهوم الإصلاح إذا ظهرت حالات خلل أو اعوجاج أو فساد في علاقة المجتمع بالعقيدة، ويجري مفهوم الإحياء إذا ظهرت حالات من الموات أو الخمول أو الانقطاع، ويجري مفهوم التجديد إذا ظهرت حالات من البلى أو القدم. وهكذا الحال في باقي النطاقات الأخرى.
من جانب آخر، وتتمة لتكوين المعرفة بهذه المفاهيم، فإن الإصلاح يكون ناظرا إلى ما هو كائن، أي إصلاح الحال الكائن. والإحياء يكون ناظرا إلى ما هو ماض، أي إعادة إحياء ما انقطع وتوقف. والتجديد يكون ناظرا إلى ما هو قادم، أي أن يكون الحال أحسن مما كان.
وبهذا اللحاظ فإن الإصلاح يكون مقدما على التجديد، فلا بد من إصلاح ما هو كائن تمهيدا لبلوغ درجة أرقى من الوضع الكائن. بمعنى أن التجديد يحمل شيئا يضيفه إلى الإصلاح. ولهذا يقال في موضوع المرأة علينا أولا أن نصلح أحوالها الكائنة، ثم نفكر في تجديد هذه الأحوال. وإذا لم نتمكن من إصلاح هذه الأحوال، فهل يحق لنا أن نفكر في تجديدها! كما يمكن القول إن الإصلاح قد يعبر عن مرحلة الهدم، والتجديد يعبر عن مرحلة البناء، والقاعدة أن الهدم مقدمة إلى البناء.
ولعل من أوضح الفروقات بين القراءتين الأولى والثانية، أن القراءة الأولى يغلب عليها من الناحية النفسية حالة الشك والارتياب، ومن الناحية الفكرية يغلب عليها التمسُّك بقاعدتي ”دفع الضرر“ و”سد الذرائع“، ومن الناحية المنهجية يغلب عليها الموقف الإطلاقي والكلي. أما القراءة الثانية فيغلب عليها من الناحية النفسية حالة الثقة والاقتدار، ومن الناحية الفكرية يغلب عليها التمسُّك بقاعدة ”جلب المنفعة وكسب المصلحة“، ومن الناحية المنهجية يغلب عليها الموقف النسبي والحس التفكيكي.
أما الجانب التطبيقي، فيمكن الإشارة إلى جملة من المفاهيم الوافدة، لكننا سنكتفي بالإشارة إلى مفهومين مُهمِّين أثارا جدلًا واسعًا، هما: مفهوما الديمقراطية والحداثة.
بالنسبة إلى مفهوم الديمقراطية، فعند النظر في سيرة الفكر الإسلامي المعاصر تجاه الديمقراطية، يمكن الكشف عن ثلاثة أطوار متغيِّرة فكريًا، جاءت متعاقبة زمنيًّا. في الطور الأول تغلَّب النظر الكلي إلى الديمقراطية بوصفها تُمثِّل مذهبًا فكريًّا واجتماعيًّا ينتمي كليًّا ومرجعيًّا إلى الثقافة الأوروبية، ويتحدَّد في مجالها الفكري والتاريخي. وعلى هذا الأساس تشكَّل الموقف الرافض كليًّا للديمقراطية، وظهر متجلِّيًا مادةً وبيانًا فيما أطلقنا عليه القراءة الأولى.
وفي طور آخر، تحوَّل النظر إلى الديمقراطية من كونها تُمثِّل مذهبًا فكريًّا واجتماعيًّا غربيًّا، إلى كونها تُمثِّل آليات وتدبيرات وتنظيمات وخبرات إنسانية مفيدة ونافعة في إدارة وتدبير المجال السياسي العام، وأصبح بالإمكان فصل هذا الجانب وتفكيكه عن الجانب الفكري والاجتماعي. وعلى هذا الأساس تشكَّل الموقف المؤيِّد للديمقراطية، وظهر متجلِّيًا مادةً وبيانًا فيما أطلقنا عليه القراءة الثانية أو ما بعد القراءة الأولى.
وفي طور ثالث، وبتأثير القراءة الثانية والانتظام في سياقها، اتَّجه الموقف إلى البحث عمَّا سُمِّي بالديمقراطية الدينية أو الديمقراطية الإسلامية أو ديمقراطية المجتمعات المسلمة التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمعات الإسلامية وما لها من عناصر ومكوِّنات خاصة بها دينيًّا وأخلاقيًّا وفكريًّا وتاريخيًّا.
وعلى هذا النسق جرت طريقة التعامل مع مفهوم الحداثة، ففي الطور الأول غلب النظر الكلي إلى الحداثة بوصفها تُمثِّل مذهبًا فكريًّا ينتمي كليًّا ومرجعيًّا إلى الثقافة الأوروبية، وعلى هذا الأساس اتَّجه الموقف إلى الرفض التام، وترتَّب عليه عدم قبول المقارنة والاقتران بين الإسلام والحداثة، وظهر هذا الموقف متجلِّيًا مادةً وبيانًا في القراءة الأولى.
وفي طور آخر، حدث تحوُّل في الموقف، وأصبح من الممكن الاقتراب من الحداثة بوصفها تُمثِّل مكتسبات العلم، ومنجزات الحضارة، وخبرات الفكر الإنساني، وترتَّب على هذا الموقف إمكانية المقارنة والاقتران بين الإسلام والحداثة، وتجلَّى هذا الموقف مادةً وبيانًا في القراءة الثانية أو ما بعد القراءة الأولى.
وبتأثير هذه القراءة الثانية والانتظام في سياقها، اتَّجه الفكر الإسلامي إلى البحث عن حداثة إسلامية، وفي هذا النطاق جاء كتاب الدكتور طه عبدالرحمن الموسوم بعنوان: ”روح الحداثة.. المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية“ الصادر سنة 2006 م.
وهكذا تعدَّدت المواقف وتباينت تجاه الديمقراطية وتجاه الحداثة في ساحة الفكر الإسلامي، في ظل هذه القراءات التي تعدَّدت وتباعدت بعدما كانت منحصرة في قراءة واحدة. وما ننتهي إليه أن القراءة الأولى في الغالب هي قراءة ناقصة وخائفة وغير متوازنة، وتفتقد إلى النضج والتماسك، الأمر الذي يقتضي نقد هذه القراءة أو بالاصطلاح الذي نختاره ”نقد القراءة الأولى“. وتساعدنا هذه النظرية في تفسير العديد من المواقف، وتحليل العديد من الاتجاهات في ساحة الفكر الإسلامي المعاصر.
إضافة إلى ذلك، فإن هذا المسلك لا حرج على الإطلاق في اختياره، فهو من موجبات الحكمة التي هي ضالة المؤمن، تصديقا لما روي عن النبي الأكرم ﷺ قوله: ”كلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها“. ومن موجبات استماع القول لاتباع أحسنه، تصديقا لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [سورة الزمر، آية 18]. ومن موجبات السير في الأرض والنظر في شؤون الخلق، تصديقا لقوله تعالى: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾ [سورة العنكبوت، آية 20].
وتكاد هذه النماذج أن تكون متقاربة في مسلكها العام، ولا تعارض بينها ولا تصادم، وما ينبغي الالتفات إليه أن هذه النماذج تقف عند حدود الشرط التاريخي والوضع الحضاري الراهن لأمتنا والذي تختل فيه الموازين الحضارية تقدما وتراجعا بين العالمين الإسلامي والغربي. بمعنى أن هذه النماذج تناسب المجتمعات في ظل وضعيات التراجع، بخلاف المجتمعات في ظل وضعيات التقدم. لذا فإن هذا الأمر يخصنا في الدرجة الأولى، نحن من يفكر فيه، ويتساءل عنه، وينشغل به، أما الغربيون فلا يدخل هذا الأمر في نطاق تفكيرهم. من هنا ينبغي أن يكون خيارنا على المدى البعيد هو خيار التقدم الذي يرفع عنا هذا الحرج، ويضعنا في مسار حضاري مختلف.
وأود أن أضيف في هذا الشأن قاعدة مهمة، تتحدد بهذا النحو: أن تكون مفاهيمنا حاكمة على المفاهيم المقتبسة، لا أن تكون المفاهيم المقتبسة حاكمة على مفاهيمنا. وفي هذه القاعدة يبرز الشرط الحضاري، فالأمة صاحبة الحضارة لا تسمح بأن تكون المفاهيم المقتبسة حاكمة على مفاهيمها.