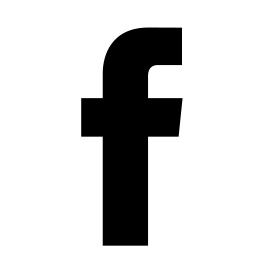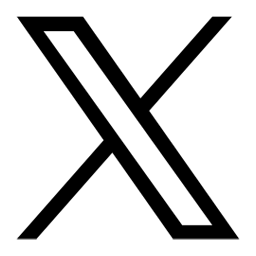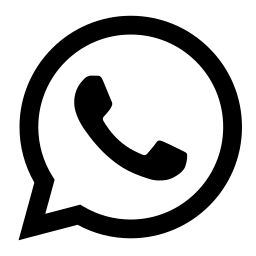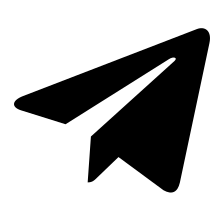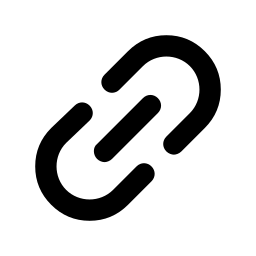جدل الحزن: بين نُضج الروح واستهلاكها
ليس الحزن انفعالًا عابرًا يُختزل في دمعةٍ أو انكسارٍ مؤقت، بل هو إحدى أكثر التجارب الإنسانية تعقيدًا وتداخلًا، حيث يتقاطع الوجداني بالوجودي، والنفسي بالأخلاقي، والفردي بالكوني. فالحزن، على حدّ تعبير فالتر بنيامين، ”ليس حالة نفسية فحسب، بل شكلٌ من أشكال المعرفة المؤلمة“. ومن هنا، لا ينصبّ السؤال على الحزن بوصفه ظاهرة، بل على وظيفته وحدوده: متى يكون معبرًا إلى النضج، ومتى ينقلب إلى قوة استهلاك صامتة تلتهم الذات من الداخل؟
إن هذا السؤال يستدعي مقاربة مركّبة، تستأنس بالفلسفة، وتستنطق علم النفس، وتستنير بالأدب، للكشف عن الحدّ الدقيق الذي يفصل بين الحزن الخلّاق والحزن المُهلك.
في التراث الفلسفي، لا يُنظر إلى الحزن دائمًا كعلامة ضعف أو خلل. فقد أكّد أرسطو، في الأخلاق النيقوماخية، أن الفضيلة لا تقوم على قمع الانفعالات، بل على تنظيمها وتوجيهها وفق العقل. ومن هذا المنظور، يكون الحزن ناضجًا حين لا يُلغِي الوعي، بل يُعمّقه، وحين لا يُشلّ الإرادة، بل يدفعها إلى إعادة النظر في المعنى والقيمة.
ويذهب سورين كيركغارد أبعد من ذلك، حين يجعل من الحزن والقلق الوجودي شرطًا لاكتمال الوعي بالذات. ففي المرض حتى الموت، يميّز بين يأسٍ واعٍ يدرك أسبابه ويواجهها، ويأسٍ غافل يتخفّى في الروتين والإنكار. فالأول، على قسوته، يحمل إمكان الخلاص، لأنه يُسمّي الألم ويضعه في أفق المعنى، بينما الثاني يستنزف الروح بصمت.
ويجد هذا التصور صداه العميق في الأدب. فدوستويفسكي، الذي جعل من الألم محورًا أنطولوجيًا، يكتب في الإخوة كارامازوف:
”الألم والمعاناة شرطان لوعيٍ واسع وقلبٍ عميق.“
إن هذا الحزن لا يُقصي الفرح، بل يُمهِّد له، لأنه يُحرّر الإنسان من وهم الاكتمال، ويضعه وجهًا لوجه أمام هشاشته الخلّاقة.
وفي الشعر العربي، يتجلّى هذا الحزن الناضج عند المتنبي، لا بوصفه شكوى، بل بوصفه وعيًا بالثمن الوجودي للسمو:
"على قدرِ أهلِ العزمِ تأتي العزائمُ
وتأتي على قدرِ الكرامِ المكارمُ"
فالعزم هنا لا ينفصل عن الألم، بل يتخلّق منه.
في المقابل، ثمة حزن يفقد قدرته على الإضاءة، ويتحوّل إلى اجترارٍ خانق يستنزف الطاقة النفسية والمعنوية. في علم النفس الإكلينيكي، يُفرَّق بوضوح بين الحزن الطبيعي والاكتئاب المرضي. فبحسب الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية «DSM-5»، لا تكمن الخطورة في الألم ذاته، بل في استمراريته، وتآكل الدافعية، وفقدان القدرة على التلذذ والمعنى.
ويُبرز آرون بيك، في نظريته المعرفية، أن الحزن المُستهلك يتغذّى على أنماط تفكير مشوّهة، حيث تُختزل الذات في خطأ، ويُختزل المستقبل في ظلمة، ويُعاد تفسير الماضي بوصفه سلسلة إخفاقات. هنا، لا يعود الحزن تجربة تُفكَّر، بل يتحوّل إلى هوية تُعاش، وإلى سجنٍ لغويٍّ ومعنويّ.
أما فلسفيًا، فيقدّم شوبنهاور نموذجًا للحزن حين ينفصل عن أفق الفعل. فالتشاؤم الراديكالي، حين يُختزل الوجود كله في إرادة عمياء ومعاناة دائمة، لا يُنتج حكمة، بل يُفضي إلى شللٍ وجوديّ. فالحزن الذي لا يفتح نافذة، ولا يسمح بتجاوز ذاته، يتحوّل إلى دائرة مغلقة، تُعيد إنتاج الألم دون ثمرة.
ويُجسّد هذا المعنى أبو القاسم الشابي حين يحذّر من الاستسلام:
"ومن لا يحبّ صعودَ الجبال
يعش أبدَ الدهرِ بين الحُفَرْ"
فالحزن هنا ليس في الألم، بل في الرضوخ له.
يمكن تلمّس الحدّ الفاصل بين الحزن المُنضِج والحزن المُستهلك عبر ثلاثة معايير متداخلة:
1. العلاقة بالمعنى:
الحزن الناضج يطرح سؤال ”لماذا؟“ ويحتمل التفكير والبحث، بينما الحزن المُستهلك يُغلق السؤال، ويحوّل الألم إلى صمتٍ كثيف.
2. العلاقة بالزمن:
الحزن الصحي يعترف بوطأة الحاضر دون أن يُصادر المستقبل، أما الحزن المرضي فيُجمِّد الزمن، ويحوّل اللحظة المؤلمة إلى قدرٍ أبدي.
3. العلاقة بالذات:
في الحزن الناضج، تبقى الذات فاعلة، قادرة على التأمل والتعبير، بينما في الحزن المُستهلك تصبح الذات موضوعًا للاتهام والعقاب المستمر.
ويُكثّف أبو العلاء المعرّي هذا التوتر الوجودي بقوله:
"غيرُ مُجدٍ في ملّتي واعتقادي
نوحُ باكٍ ولا ترنُّمُ شادِ"
فالمعرّي لا يُنكر الحزن، بل يفضح خواءه حين ينفصل عن الفعل والمعنى.
الحزن، في جوهره، ليس خللًا في التجربة الإنسانية، بل أحد شروط عمقها. غير أن قيمته لا تُقاس بحدّته، بل بقدرته على التحوّل. فالحزن الذي يُنضج الروح هو ذاك الذي يمرّ عبر اللغة، والتأمل، والاعتراف، ويُعاد صوغه في أفق أوسع من الذات الجريحة. أما الحزن الذي يستهلكها، فهو الذي يُغلق الدائرة على الألم، ويمنع عنه إمكان التحوّل.
وبين هذين الحدّين، يقف الإنسان في امتحان دائم:
إمّا أن يجعل من حزنه معبرًا إلى المعنى،
أو أن يسمح له بأن يغدو نهايةً صامتة لكل المعاني.