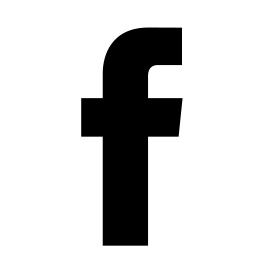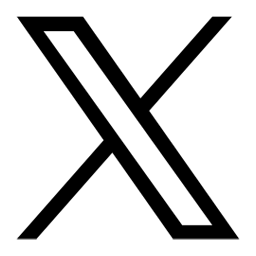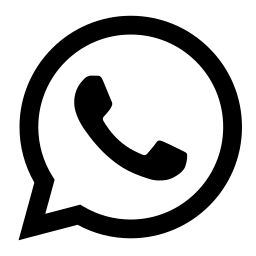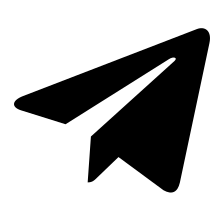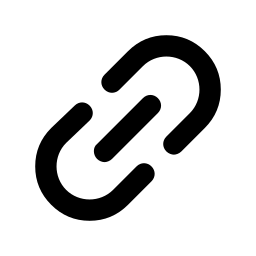داعش يعشش في أروقتنا
عندما ينتشر وباء في بلد فإنه لا يختار مكاناً دون غيره ولا يختار أشخاصا بعينهم دون غيرهم فهو يزور كل الأماكن ويطرق كل الأبواب؛ وما أن يجد لنفسه موطن قدم حتى يبدأ في تأسيس أول قاعدة له ليزرع فيها سمومه فينمو وينتشر بطريقة جنونية لا شبيه لها، هذا تماما ما تفعله «داعش»، هذا الوباء الذي ابتلت به الأمة وبات عليها أن تستنفر جميع طاقاتها بكل ما أوتيت من قوة وعلى جميع الأصعدة لمحاصرته قبل أن يفتك بمقدراتها فتكون له اليد العليا في الأمر والنهي لا قدر الله.
اليوم نحن أقرب الى هذا السيناريو من غيره وما نقرأ عنه ونسمع إلا قطرة في بحر؛ فتلك أستاذة جامعية لم تقها شهادتها العليا ولا علمها من أن يصل لها ذلك الوباء فتركت جامعتها وطلابها وراتبها الشهري الكبير لتلتحق بداعش وتحصل على صك لقصر لها في الجنة وعده إياها أميرها البغدادي والله اعلم ماذا تركت خلفها. وذلك طبيب استثمرت فيه الدولة مئات الآلاف من الريالات حتى أصبح طبيبا، لكن تلك الوظيفة لم تعني له الكثير مقارنة بحور العين اللاتي ينتظرن قدومة لمجرد انتهائه من قتل مجموعة من البشر الآمنين الذين فجر نفسه فيهم لمجرد إنهم رفضوا مبايعة أمير الظلام واستمروا في بيعتهم لنبي الرحمة محمد ﷺ ورسالته السماوية السمحة.
لم يخطر على بال أحد أن بمقدور هؤلاء الظلاميين أن يؤثروا حتى على الطبقة المتعلمة من أبنائنا، وهذا إن دل على شيئ إنما يدل على هشاشة تلك المناعة العقيدية التي يتمتع بها بعض من هؤلاء الشباب ممن ساقتهم أيدي الخبث إلى مصيدة الهلاك. نستخلص من ذلك أن هؤلاء التكفيرين مستمرين في نهجهم القاضي باستقطاب شريحة كبيرة ممن يتعاطفون معهم ويميلون لفكرهم لتنفيذ أيجندتهم المبنية على كره كل من لم يتبع سيرتهم ويخالف أعمالهم الشيطانية.
لم تخالج المواطن مخاوف كالتي تعصف بذهنه هذه الأيام بعد أن تمكنت تلك الدولة المشؤومة من استقطاب أعداد من أبنائنا المتعلمين، بأن تصل أدوات فكرهم الإجرامي إلى عقول مهندسينا وتقنيينا مما قد يعرض مصانعنا ومعاملنا لخطر التفجير. وكما يعلم الجميع بأن تلك المجمعات الصناعية كمعامل الغاز والبتروكيماويات لا تقل خطورة عن القنابل النووية في قدرتها التدميرية إن وصلت إليها أيدي الإرهاب وعبثوا وخربوا فيها كما يفعلون بأماكن أخرى ليست ببعيدة عنا. المخاوف لا تقف عند ذلك الحد بل تطال جميع مرافق الحياة للمواطن من مصانع الدواء ومعامل التحلية وأماكن العبادة ووسائل النقل البري والجوي وغيرها.
نتمنى أن لا يصل بنا الحال إلى ذلك لكن كما يقال «إذا فات الفوت لا ينفع الصوت». إن ما تقوم به المؤسسات الأمنية من ملاحقة أيدي الإرهاب أينما وجدت هو أمر في غاية الأهمية إلا أنه معالجة آنية للوباء. المواطن اليوم يطمح إلى ماهو أعمق من ذلك حتى يصل إلى درجة الإطمئنان؛ وذلك من خلال التوصل الى جذور المشكلة واستئصال جذورها حتى لاترجع الى النمو من جديد. هذا لا يمكن تحقيقه إلا بمعرفة ما يدور في مدارسنا وجامعاتنا وحتى مساجدنا حتى نضمن أن شبابنا يحمل فكرا معتدلا وسطياً لا يشوبه تطرف قد يدمر ما بنيناه وما نحلم أن تبنيه الأجيال القادمة. كل ذلك لن يتحقق إلا من خلال رص الصفوف والعمل على تبني الآخر على اختلافه وتنوعه.
اليوم الوطن بحاجة إلى استحداث وتأسيس برنامج أمن شامل تكون بدايته السيطرة والتحري على جميع منافذ وخيوط التواصل التي تمكن هؤلاء الإرهابيين من اختراق النسيج الوطني ليدمروا بنيته وتركيبته الطبيعية. أن يكون من ضمن ذلك البرنامج الأمني فرعا للسيطرة التصحيحية لأنه لا يمكننا بناء أمننا على قواعد هشة ملغومة بمن يتهادنون ويتعاطفون مع هؤلاء الظلاميين لنكتشف بعد فوات الأوان أن بعضا من هؤلاء الإرهابيين الذين أخلي سبيلهم قد رجعوا من جديد الى أدوات إجرامهم ليفتكوا بالأبرياء من مواطنين ورجال أمن. أما الفرع الثالث من البرنامج فيجب أن يكون وقائيا حتى نعمل على تقليل فرصة الإنتشار لذلك الوباء وهذا لا يمكننا تحقيقة دون تنقية جميع مؤسساتنا الأمنية منها والمدنية من كل من يثير النعرات المذهبية والطائفية ويروج لها بل يعمل على تنفيذها من خلال نفوذه في تلك المؤسسة دون حسيب أو رقيب.
نحن كمواطنين ومثقفين وكتاب كلمة ليحذونا الأمل الكبير في قيادتنا الحكيمة بأنها قادرة على حفظ هذا الوطن من شرور الحاقدين والمتربصين والذين لا يريدون له خيرا، وأننا بالعمل الجاد المتواصل سنبني هذا الوطن بعيدا عن الطائفية البغيضة التي تفرق بين أبناء الوطن الواحد وتنفر الأخ من أخيه. حفظ الله هذا الوطن وزاده قوة ومنعة وجعل كلمته هي العليا والسلام عليكم.