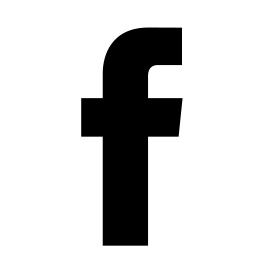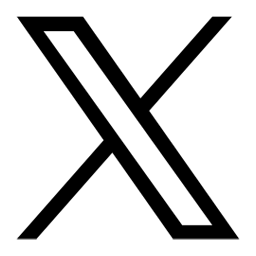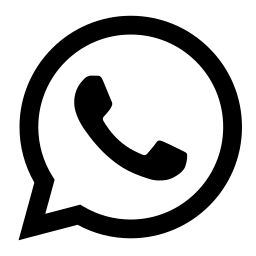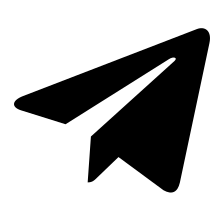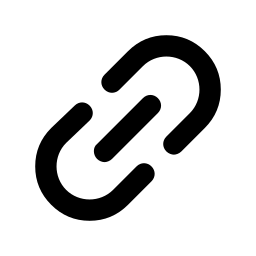من القمة يبدأ الانهيار
يؤكد الهواة والمهتمون بسباقات الخيول، وكذلك المحللون الفنيون لنتائج السباقات أن الحصان مهما بلغت قوّته وسرعته لا يمكنه الفوز ما لم يكن الخيّال الذي يقوده إلى الهدف متمرساً وذا دراية وقدرة عميقة على توجيهه بمهارة، وذلك لأن الحصان وإن امتلك القوة والسرعة يبقى بحاجة إلى من يقوده ويوجهه نحو الهدف.
وهكذا هو الحال في ميدان القيادة، فنحن لا نُغالي إن قلنا إن القائد والمنفذ يكملان بعضهما البعض، وأن النجاح في المؤسسات الخاصة والعامة لا يتحقق إلا بتكامل الأدوار بين من يملك الرؤية والتوجيه، ومن يمتلك القوة والقدرة على التنفيذ.
فالخيّال هنا تعبير عن القائد الذي يمتلك القدرة على التأثير في الآخرين وتوجيههم نحو تحقيق أهداف محددة، بينما الحصان تعبير عن الطاقات الكامنة في المرؤوسين أو المنفذين، فإذا أحسن القائد التخطيط والتوجيه انطلقت الطاقات بقوة نحو الإنجاز والفوز، أما إذا غاب التوجيه، أو اختلّ التوازن ضاعت الجهود، وتبعثرت الخطوات، بل وتوقفت المسيرة في منتصف الطريق.
ومن هنا قيل في المثل الشعبي المشهور ”الخيل من خيّالها“ فكما أن الخيل مهما بلغت من الأصالة والقوة تبقى بحاجة إلى فارس متمرس يحسن توجيهها، ويقودها نحو الانتصار، كذلك المؤسسات أو الشركات والفرق لا يبرز عطاؤها الحقيقي إلا بوجود قائد كفء قادر على استثمار طاقاتها وتوجيه جهودها..,ولعل أصدق تعبير عن ذلك ما قيل عن ”أن السفينة لا يغرقها البحر من حولها بل يغرقها ضعف الربان الذي يقودها“ في إشارة واضحة إلى أن التحديات والمصاعب مهما عظمت تبقى قابلة للتجاوز بوجود قيادة حكيمة وفاعلة.
ومن هنا يبرز التساؤل الجوهري التالي:
إلى متى تستمر ظاهرة تصدر غير المؤهلين للمناصب القيادية، في حين تُهمش الكفاءات التي تملك المؤهل والخبرة والرؤية والقدرة على التغيير؟ وهل بات الولاء للأشخاص جواز عبورٍ نحو القمة، بينما تُغلق الأبواب في وجه الولاء للمهنة والرسالة، وكيف نُعيد تشكيل دور المرؤوسين ليكونوا شركاء في النجاح والتطور بدلاً من مجرد تابعين ومنفذين؟
إنني أعتقد أن أسوأ ما يمكن أن تواجهه أي مؤسسة أو أي مشروع تجاري، سواء كان إنتاجياً أو خدمياً ليس النقص في الموارد أو الضعف في الميزانية أو التقلبات السوقية أو حتى الشح في الكوادر البشرية، وإن كانت هذه العوامل مهمة وضرورية، إلا أن الخطر الأكبر والأكثر فتكاً يتمثل في سوء إدارة العنصر البشري وتحديدا في تقديم العلاقات الشخصية والمحسوبيات كما يُقال على حساب الكفاءات والجدارة المهنية، وذلك لما لهذه الممارسات من آثار مدمّرة على أداء المؤسسات واستقرارها المستقبلي، والتي من أبرزها.
عندما يتولى غير المؤهلين مناصب قيادية أو تنفيذية مثل مدير عام أو مشرف مشاريع أو مسؤول موارد بشرية أو.. ما شابه من دون امتلاكهم المؤهلات الأكاديمية أو الخبرات العملية اللازمة، فإن المؤسسات غالبا ما تدخل في دوامة من العشوائية والفوضى الإدارية، لأن مثل هذه المناصب تتطلب فهما عميقا لمنهجيات الإدارة الحديثة وإلماماً بالأدوات التحليلية والتخطيطية والقدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على بيانات دقيقة، لا على علاقات شخصية أو اجتهادات عشوائية.
وهذا ما أكدته الدراسة الحديثة الصادرة عن منظمة العمل الدولية حيث أشارت إلى أن أكثر من 60% من الشباب العربي يرون أن التوظيف في القطاعين العام والخاص يعتمد على العلاقات الشخصية لا على الجدارة. أما في المملكة العربية السعودية، فقد ظهر تقرير صادر عن هيئة الإحصاء 2023 أن 37% من الباحثين عن العمل يحملون شهادات جامعية، لكن لم يحصلوا على فرص عمل في مقابل توظيف أشخاص أقل تأهيلا بفضل علاقاتهم العائلية أو الاجتماعية.
أو نجد موظفا يحمل مؤهلاً عاليا، ويمتلك سجلا حافلا من الإنجازات، لكنه يبقى في الظل لسنوات، بينما يصعد زميله الذي لا يحمل من المؤهلات سوى ”صلة قرابة“ أو علاقات شخصية إلى المناصب العليا ", ولذا من المهم على الشركات أو المؤسسات الإنتاجية أو الخدمية أن تعتمد على التقييم الشفاف المبني على الأداء والكفاءة، وأن تعمل على بناء صف ثانٍ من القادة المؤهلين بدلاً من الاعتماد على الاجتهادات الفردية أو الحلول المؤقتة عند الحاجة للقيادة
قد يثار تساؤل منطقي: كيف يمكن لمؤسسة أو لشركة أن تنجح في تحقيق أهدافها، بينما تُقصي الأكفاء وتمنح القيادة لغير المؤهلين؟
والجواب ببساطة ”لا يمكن“ لأن القرارات في الكثير من مؤسساتنا وللأسف الشديد تُبنى على المجاملات لا على المعايير، وعلى العلاقات لا على التقييم العادل. ولذا تجد مؤسسة تعيّن مديرا عاما بلا أي خبرة سابقة في القطاع الذي تقوده، فتضّيع الأولويات وتُهدر الميزانيات في مشاريع ارتجالية ثم تُعقد الاجتماعات مرة أخرى لا لمراجعة الأداء، وإنما لتبرير الفشل.
أو قد تجد شركة تُعيّن ابن أحد الشُركاء مشرفا عاماً على قسم حيوي؛ لأنه من العائلة رغم وجود موظف ماهر وخبير أمضى العشر أو الأكثر من السنوات في تطوير هذا القسم وتحسينه لتكون النتيجة تراجع الأداء وانهيار السمعة.
وهكذا يتحول مكان العمل إلى بيئة طاردة للعقول والمواهب، وطاردة للكفاءات والخبرات وللروح المهنية.., والأسوأ من كل ذلك نرى أن البعض من المؤسسات أو الشركات تبدأ في لوم الموظفين وتُحملهم الأخطاء، بينما الخطأ الحقيقي والأكثر فتكاً يكمن في من يتربع على القمة، وكما قيل في المثل الشعبي ”نعيبُ زماننا والعيبُ فينا وما لزماننا عيبُ سوانا“ فكذلك هو حالُ بعض مؤسساتنا التي تلوم الظروف وتحمل الزمان والأفراد مسؤولية العيوب، بينما العيب الحقيقي يكمن فينا وفي سوء اختياراتنا وفي تمّكين من لا يستحق وإقصاء من يستحق.
لا شك أن ترسيخ ثقافة النفاق والشللية أو «المحسوبية أو المحاباة» والتي تعني تفضّيل الأفراد أو المجموعات بناءً على علاقات شخصية أو انتماءات خاصة مثل العائلة أو القبيلة أو الطائفة أو الصداقة أو غيرها في بيئات العمل يشكّل عائقاً حقيقياً أمام أي مسعى نحو التقدم والتطوير، كما لو أن المناصب الإدارية الحساسة في بعض المؤسسات تُمنح لأشخاص يفتقرون إلى الكفاءة أو الخبرة فقط لأنهم مقربون من الإدارة، أو تجمعهم علاقةُ شخصية مع أصحاب القرار، إذ إن هذه المؤسسات أو الشركات كثيرا ما تنحرف عن أهدافها الأساسية الأمر الذي ينعكس سلبا على أدائها التنظيمي، ويؤدي إلى ضعف مستوى التنسيق والإنجاز.
فكم رأينا من موظف متميز أُقصي من عمله؛ لأنه لا يُجيد التملق؟ وكم شاهدنا من مشروعات تعثرت؛ لأن من يُديرونها تم اختيارهم بالواسطة لا بالكفاءة والخبرة؟ في المقابل نجد أن هناك من لا يمتلك إلا لساناً ناعماً ومجاملة مصطنعة يصعد في المناصب العليا ويُحتفى به، بينما الكفاءات تًهمّش وتُهمل!
إننا بهذا السلوك السيئ لا نخسر الأشخاص الأكفاء فحسب، بل نُساهم في خلق بيئة عمل طاردة للإبداع، ومدمرة للروح المهنية، ومثقلة بالظلم والإحباط.
ولذلك أعتقد من وجهة نظري الخاصة أن الحل يبدأ من إعادة تقييم الهيكل القيادي، وتفعيّل مبدأ المساءلة من القمة، وليس من القاعدة إذ لا يمكن تحقيق الإصلاح إلا حينما تعترف القيادة بمسؤولياتها، وتسهم في بيئة عمل عادلة تدعم التعاون والتطور بدلاً من إلقاء اللوم على الظروف أو الأشخاص في أخطاء لا يتحملونها.
تُثار من الحين لآخر نقاشات عميقة ومستفيضة حول أسباب ضعف الأداء المؤسسي، وغالبا ما يُلقى باللوم في هذه النقاشات على الموظفين «المرؤوسين» بوصفهم المصدر الرئيسي للمشكلة، إلا أن الحقيقة في اعتقادي تختلف عن هذا التصور مطلقا، إذ إن جذور المشكلة غالبا ما تكمن في النظرة الفوقية أو الاستبدادية التي يتبناها بعض المديرين تجاه مرؤوسيهم، أو قد تكمن المشكلة في ثقافة العمل القائمة على مبدأ ”افعل كما أقول“ لا في ضعف الأداء، ولذلك يُقال إن القيادة السيئة تُحطم أفضل الخطط، وأن الإدارة المتعالية تُطفئ جذوة الحماس حتى لدى أذكى الموظفين، تماما كما قيل في المثل الشعبي المشهور ”أن الشجرة تذبل من رأسها“ وأن السمكة العفنة لا تُكتشف عفونتها إلا عندما ننظر إلى رأسها "
صحيح أن للموظفين دوراً في تحقيق النجاح المؤسسي لكنهم ليسوا الطرف الوحيد المسؤول عن الفشل، وهذا ما أكدته الأبحاث والدراسات، ومنها ما أشارت إليه دراسة غالوب «المؤسسة المتخصصة في استطلاع الرأي وتحليل البيانات المؤسسية والقوى العاملة» إلى أن 85% من مشاكل الأداء تعود لأسباب هيكلية وإدارية وليس لضعف الموظفين.
85% من الموظفين حول العالم لا يشعرون بالانتماء لمؤسساتهم «غالوب 2023»
70%منهم يؤكدون أن أفكارهم لا تُسمع رغم أن 82% من الابتكارات الناجحة في الشركات الكبرى جاءت من موظفي الخطوط الأمامية «دراسة هارفارد». ولتغيير هذا الواقع نقترح اتباع الاستراتيجيات التالية:
أولا: منح صلاحيات حقيقية تتجاوز حدود التنفيذ الروتيني مثل ”بنك ساب“ السعودي الذي يسمح لموظفي الفروع بتعديل سياسات خدمة العملاء بنسبة 15% حسب احتياجات المنطقة.
ثانياً: الشراكة الملموسة أي تحويل المشاركة من شعارات إلى مكاسب مادية مثل شركة أرامكو السعودية التي تخصص 5% من توفيرات الأفكار المبتكرة كمكافآت للموظفين.
ثالثاً: المدير الشريك أي تحويل دور المدير من ”آمر“ إلى مدير ”ميسر“ مثل شركة نستله في الأردن التي خفضت معدل الاستقالات 40% بعد تطبيق برنامج ”المدير الشريك“.
وأخيراً...
إلى متى نظل ندفع ثمن تقديم العلاقات على الكفاءات؟
وإلى متى يبقى المرؤوسون طاقة كامنة تنتظر من يؤمن بها ويمنحها الفرصة؟
وإلى متى يبقى الواقع يؤكد أن 70% من فشل المؤسسات سببه قيادات غير كفؤة؟
وإن 9 من كل 10 موظفين مبدعين يشعرون بأنهم ضائعون في أنظمة تقتل الإبداع، وتُحبط الطموح؟
وإلى متى نظل نراوح مكاننا في دوامة من الفوضى الإدارية ونتجاهل الأصوات الصادقة التي تنادي بالإصلاح والتطوير؟
كفى تهميشاً للكفاءات، وكفى تأجيلاً للتغير فلنبدأ الآن، فالأمل لا يُبنى بالكلمات، بل بالقرارات الشجاعة