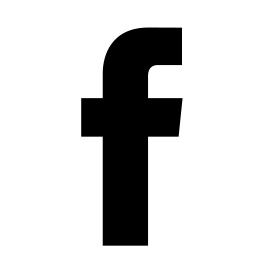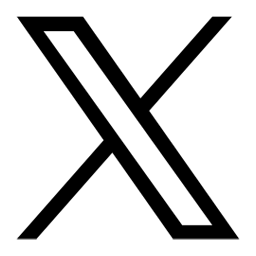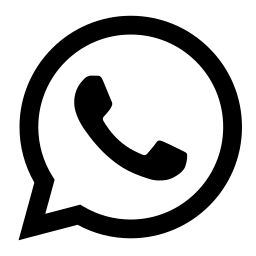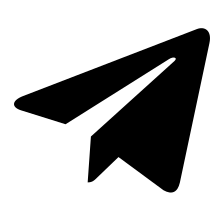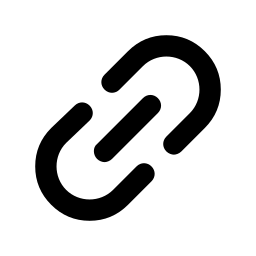التهذيب المجتمعي ليس ترفًا
التهذيب ليس مجرَّد لباقة لفظيَّة؛ بل هو انضباط داخلي يضبط ردود الفعل ويضبط طريقة الوجود بين النَّاس؛ وهو لا يُكتسب صدفة، وإنَّما تُزرع بذوره في الطفولة بالتربية والتلقين والملاحظة، وينمو مع الإنسان كلَّما شاهد سلوكًا نبيلًا أو تلقَّى توجيهًا رقيقًا.
حين يكون المرء مهذَّبًا، يجد تقبُّلًا واسعًا من محيطه، ويستقبل رأيه برحابة، حتَّى وإن خالفهم، وأمَّا من يفتقر للتهذيب، فيُقصى تلقائيًا من المجالس الراقية، ويُنظر إليه كحاجز في طريق التفاهم، ولو امتلك بعض الحق؛ لذلك، فإنَّ التهذيب المجتمعي لا يُعدُّ ترفًا، بل هو ضرورة تحفظ للإنسان احترامه، وتضمن لمجتمعه سلامة التواصل.
لم تَعُد السخافة شيئًا يُخفى أو يُستحى منها؛ ولكن أصبحت تُصوَّر وتُنشر وتُتداوَل وكأنَّها مادة ترفيهيَّة خفيفة، وهناك عشرات المقاطع القصيرة التي تنتشر يوميًّا لأشخاص من مجتمعنا - بعضهم في سن الرشد، أو ممن يُفترض أن يكونوا قدوة - وهم يسخرون من طبائع النَّاس، أو يتحدَّثون بطريقة سطحيَّة، أو يتصنَّعون الجهل والابتذال لإضحاك المتابعين.
ويظنُّ أصحابها أنَّهم يقدِّمون محتوى عاديًا أو مضحكًا، بينما المتابع الواعي لا يرى فيها سوى انحدارًا في الذوق، وافتقار واضح للتهذيب المجتمعي، والأدهى من ذلك أنَّ بعض هذه المقاطع تُغلّف بالسخرية من قيم المجتمع أو تُوجَّه لإثارة التعصُّب الرياضي، حتَّى بات البعض يستبيح الطعن في الآخر، أو إهانة المدن والمناطق، فقط لأجل التشجيع. وهذه المظاهر ليست مزاحًا بريئًا، وإنَّما هي مؤشرات خطيرة على اتِّساع الفجوة بين حرية التَّعبير والتهذيب في التعبير؛ فحين تُستخدم المنصات للإضحاك على حساب الأخلاق، فإنَّ المجتمع لا يضحك فعليًا؛ بل ينزف بصمت.
إنَّ التهذيب ليس فطرة خالصة، وهو خُلق يُعلَّم، ويُزرع، ويرتوي بالرؤية والسماع والمخالطة، وتبدأ أولى دروسه في حضن الأسرة، حين يرى الطفل كيف يتحدَّث أبواه، وكيف يختلفان وكيف يعتذران. وأمَّا في المدرسة، تترسخ القيم حين يرى المعلم يضبط نبرة صوته، ويُقدِّر سؤال تلميذه.
وفي المسجد، وفي السوق، وحتَّى في الطوابير، هناك لحظات يتعلَّم فيها الإنسان الفرق بين أن يكون مهذبًا، أو مجرَّد شخص لا يخرق القانون.
وقد يحدث أن تكون الأسرة قد أدَّت واجبها كما ينبغي، وربَّت طفلها على الأدب والاحترام؛ لكنه حين يكبر، ويخالط المجتمع، ويُفتن بالشهرة أو يُستدرج بثقافة السخرية، يبدأ بالتصرف وفق عقله وحده، أو هواه الضائع، فيُقصي ما تربى عليه
لصالح ما يلمع أمامه من انبهار وقبول لحظي.
وهنا تتجلَّى أهميَّة الرقابة الذاتية، والنماذج المجتمعيَّة المستمرة، لا أن يُترك الشاب يتعلَّم من المنصة بدل القدوة.
رأيت شابًا يهمُّ بالدخول إلى مجلس، فتوقّف عند الباب، وألقى السلام بهدوء، ثمَّ انتظر
أن يؤذن له بالجلوس، ولم يقاطع، ولم يتصدَّر، ولم يرفع صوته، ولم يكن يعرف كثيرين في المجلس؛ لكنهم جميعًا لاحظوا تهذيبه، وابتسموا له ترحيبًا؛ فالتعامل المهذَّب لا يطلب الصدارة، لكنه ينتزع الاحترام دون أن يتكلم كثيرًا.
وبعد دقائق، حين أُتيح له الكلام، قدّم رأيًا وجيهًا بلغة رزينة، فاستمع له الجميع من دون أن يعرفوا اسمه. وكان حضوره أخلاقيًا قبل أن يكون لفظيًا، وكان التهذيب هو الذي مهد لكلامه الطريق.
في زمن الضجيج، تبدو هذه التصرفات بسيطة؛ لكنها تحمل في داخلها أعمق أشكال التربية؛ فليس كل مهذب بحاجة إلى أن يُقال له: ”كن مؤثِّرًا“، هو يؤثر بالفعل من دون شعار؛ فالمجتمع لا يزدهر بالخطب وحدها؛ بل بهذه النماذج التي تزرع الاحترام كعادة، وتُمارسه كهوية، لا كتمثيل.
إنَّ التهذيب المجتمعي ليس ترفًا سلوكيًا كما يظنُّه البعض، وإنَّما هو صمَّام الأمان الذي يحفظ المجتمعات من التآكل الخفي، ومع كثرة السلوكيات الفوضوية التي نراها اليوم، يبدو أننا نبتعد تدريجيًا عن إرثٍ قيميٍّ تربَّى عليه هذا المجتمع الجميل.
ولا نقول: إنَّ التهذيب قد انقرض؛ لكنه بات في مواجهة تحدِّيات جديدة، تحتاج إلى يقظة جماعيَّة وتربية واعية.
والمؤسف أنَّ بعض ما كان يُستنكر قبل سنوات، أصبح اليوم يُبرر باسم الحرية، أو
يُصوَّر كطبيعة العصر، ومع هذا، لا يزال في الناس خيرٌ كثير، لكنه بحاجة إلى من يوقظه، لا من يسخر منه.
إنَّ أبسط سلوك مهذب - ابتسامة، اعتذار، إنصات - له قدرة على تصحيح مسار
مشحون وتحويل نقاشٍ حادٍّ إلى فرصة تفاهم. ويكفي أن يُهذَّب اللسان عن الوقيعة، والفعل عن التهور، حتَّى يبدأ المجتمع باستعادة توازنه القيمي من جديد.
فالرفعة لا تحتاج إلى سلطة؛ بل إلى تربية حقيقية.
فلنُعد للتهذيب مكانته، لا بالكلام وحده، ولكن بأن نكون نحن دعاته بالفعل قبل القول،
وبقدر ما نُهذِّب أنفسنا، نُهذِّب مجتمعنا.