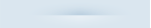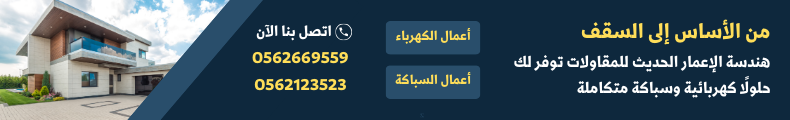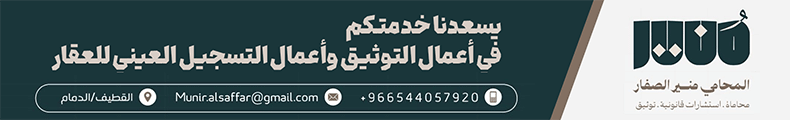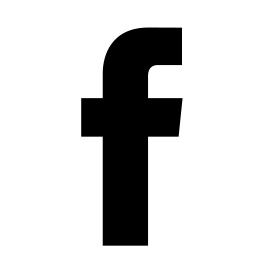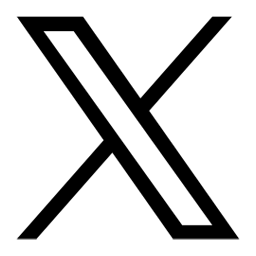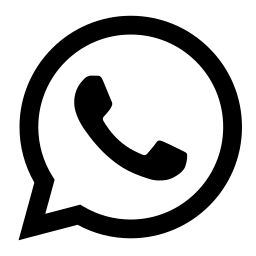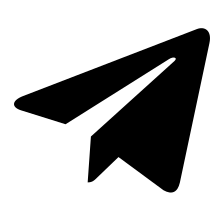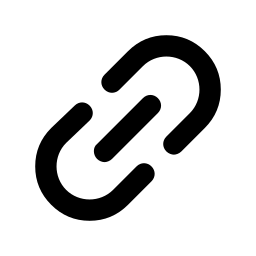العلمُ وأمُّه ومراتِبُه
أروي للقراء الكرام قصة سمعتها من والدي - رحمه الله - جاء فيها:
أنَّ أحدَ المؤمنين شدَّ رحاله متوجها إلى حوزة علمية بعيدة عن موطن سكناه، قاطعا مسافات، طاويا الفيافي والمهامه أياما حتى استقرَّ فيها للدراسة.
في ماضي الأزمان، كان المسافر ينقطع عن الأهل والأحباب؛ فلا اتصالَ، ولا رسالةَ، ولا راديو، ولا تلفازَ، ولا ناقلَ أخبار.
مكَثَ مَنْ نعنيه في غربته عشرين سنة متواصلة أو أكثرَ، وبعدها عزمَ على الرجوع إلى بلده. مرَّ في طريقه بصديق له فاستضافَه. سأله الصديق عن أحواله وسبب غيابه: ”أين كنتَ؟ وماذا فعلتَ في دنياك بعد طول هذا الغياب؟“
فردَّ عليه: ”كنتُ في طلب العلم“.
فقال الصديق: ”نِعْمَ ما فعلتَ! هذا جهاد تُثابُ عليه. ولكن، هل ختمتَ أمَّ العلم؟ فبدونها لا قيمةَ لما حصلَّتَه وتعلَّمتَه“.
استغربَ الضيف قائلا: ”وهل للعلم أمّ؟ لم أسمعْ بها من قبلُ. مَنْ هي؟“
فأجابَ الصديق: ”إنها ’الحِلْم’. لزاما عليك أن تتعلَّمَه ليكتملَ ما سعيتَ من أجله وضحَّيتَ في سبيله“.
فتوجَّهَ طالب العلم إلى حيث كان، ومكَثَ سنتين أخريين، ثم عاد. وصلَ بيته ليلا ودخله على حين غفلة، فإذا به يرى شابا نائما نوما عميقا بالقرب من زوجته. فأساءَ الظنَّ، واستشاطَ غضبا، وهمَّ بقتله، وأوشكَ على ارتكاب جريمة بشعة وسفكِ دمِ نفسٍ محترمة.
ولكنَّه تذكَّرَ القول المأثور: ”في التأني السلامة، وفي العجلة الندامة“. فتداركَ الموقف وتذكَّرَ أمَّ العلم، ’الحِلْم’، فقرَّرَ أن يتعاملَ بحِلْم. فأعرضَ عنه وقرَّرَ الانتظار حتى الصباح لينظرَ في الأمر وتُعرَف الحقيقة.
وبالفعل، عند الصباح اتَّضحَ أنَّ الشابَ هو ابنه الذي حملَتْ به أمُّه ليلةَ خروجه.
نقول، أولا: الله أعلم بصحة ما تقدَّمَ نقله، لكنَّه درس نأخذ منه عبرة بأهمية التأني وعدم الاستعجال، خصوصا عند الشدائد وفي الظروف الصعبة.
ثانيا: إننا بحاجة إلى علماءَ حُلَماءَ متواضعين. فما لم يتحلَّ الواحد منهم بالحِلْم والتواضع، فعِلْمُه هباء، لأنَّه يُنفِّرُ الناس ويُكرِّههم في لقائه.
بخلاف العالِم الخلوق الحليم، الذي يُشتاقُ إلى مجالسته ومحادثته وسؤاله، ويُستفادُ منه، ويُتَّخَذُ قدوة، ويُعلِّمُ بسلوكه أكثرَ مما يُعلِّمُ بدروسه.
بينما العالِم سريع الغضب، الانتقائي في تعامله، يُبتعَدُ عنه، ويكون السلام عليه مجاملة، والكلام معه بحذر وخوف، ويُحذَرُ من تصرفات سيئة غير محسوبة قد تصدرُ منه.
أيُقبَلُ مثلا أن يحملَ بيد شهادة عُليا وبالأخرى مِطْرَدةَ ذباب يكشُّ بها مَنْ لا يعجبه من الناس؟ ما فائدة ما بيمينه إذن؟
وأين هذا من قولِه تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: آية 159].
ومما رُوِيَ عن الإمام الصادق  قوله: ”كونوا لنا زينا، ولا تكونوا علينا شينا. قولوا للناس حُسْنا، واحفظوا ألسنتَكم، وكُفُّوها عن الفضول وقبيح القول“.
قوله: ”كونوا لنا زينا، ولا تكونوا علينا شينا. قولوا للناس حُسْنا، واحفظوا ألسنتَكم، وكُفُّوها عن الفضول وقبيح القول“.
ولأمير الشعراء أحمدَ شوقي أبيات في هذا المضمون:
إنما الأممُ الأخلاقُ ما بقيتْ *** فإنْ همُ ذهبَتْ أخلاقُهم ذهبوا
صلاحُ أمرِكَ للأخلاقِ مرجِعُهُ *** فقوِّمِ النفسَ بالأخلاقِ تستقِمِ
وبخصوص المستوى العلمي، فنحنُ العوامَّ يجبُ أن نُعطيَ المسميات الحوزوية لمستحقيها، بلا زيادة ولا نقصان، فلا نَظلِمُ ولا نُدلِّسُ، خاصة في أمور العقيدة وفتاوى العبادات، ولا نختار بناءً على الهوى أو الصداقة أو القُربى.
فألقاب مثل: «سماحة، علَّامة، فقيه، آية الله، مرجع» لها تبعاتها ومسؤولياتها، لذا يجبُ أن نرجعَ فيها إلى أصحاب الاختصاص الموثوقين المشهود لهم بالنزاهة، الذين يُقيِّمونَ كلَّ شخص بمرتبته. ثم نأخذُ عنهم ما يُقرِّرونَه ونخاطب العلماءَ بها.
أما المظهر الجذاب، ككِبَر العمامة، وبياض اللحية، واللسان الطلق، وحُسْن حديث المجالس، فكلها مظاهر قد تكون خادعة، ولا تقوم بها حجة، ولا يُبنَى عليها حكم، ولا تُؤهِّلُ صاحبَها لحمل الألقاب العلمية.
إنَّ الاعتمادَ على هذه المظاهر حساباته خاطئة، وينتج عنها أضرار في الفهم والتكليف والأحكام الشرعية، وصولا إلى مسائل التقليد المهمة.
فلنكنْ عُقلاءَ نضعُ الأشياءَ في مواضعها. وللأسف، أصبحنا نُطلقُ هذه الألقاب كيفما نشاء، نمنحها لِمَنْ نُحبُّ ونَصْرِفُها عَمَّنْ نَكْرَهُ.
ولو تحقَّقْنا وتتبَّعْنا وبانَ المُغطَّى، لَوَجَدْنا ربما مكشوفَ رأس هو أعلمُ ممن يرتدي العمامة، أو لباسَ دين يرتديه جاهل، أو صامتا هو أصدقُ من متكلم كاذب، أو مبتدئا يرى نفسَه أعلى شأنًا من أستاذ يُلقي البحثَ الخارج!