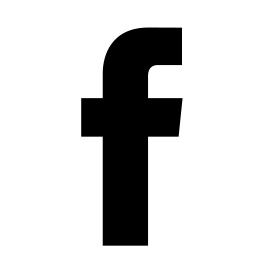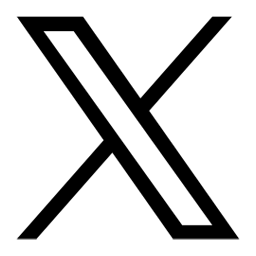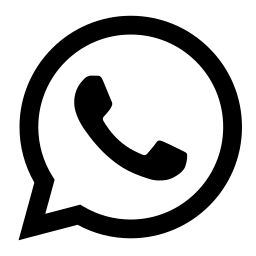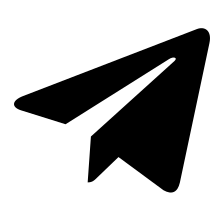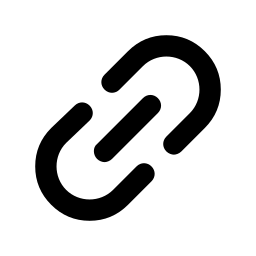أن تكون مختلفاً... ولكن على طريقتي!
أشد أنواع الغربة مرارةً هو العيش في مجتمع لا يعترف بهويتك، مهما كانت. حتى المجتمعات المتعددة ثقافياً، لديها أمراضها فيما يتعلق بالهويات التي تختلف عنها، هي غالباً تُرحّب بالاختلافات التي لا تهدد مصالحها أو قناعتها، لكنها تقاوم كل هوية تحمل رؤية أو سردية بديلة. بعض المجتمعات «المتحضرة» تدّعي احترام التعدد، لكنها تطلب منك أن تكون «مختلفاً على طريقتها» لا على طريقتك، تسمح لك بالوجود، بشرط ألا تُزعج التوازن القائم، أو تطرح أسئلة عميقة عن الانتماء والعدالة، ولذلك فقد تقضي عمرك وأنت تشعر بأنك مجرد «ضيف دائم وثقيل»، تحمل دوماً شعوراً بأنك وحدك المختلف، الآخر، الاستثناء، ويُطلب منك أن تشرح حالتك طوال الوقت.
ناضل الكاتب والأديب الأميركي من أصل أفريقي جيمس بالدوين، المولود 1924 في حي هارلم بنيويورك، منذ صباه للدفاع عن هويته المختلفة، وظنّ أن المجتمع الأميركي في منتصف القرن الماضي كان مستبداً تجاه السود؛ لأنه مجتمع حديث وليست له جذور تاريخية، لكنه حين انتقل إلى باريس بعمر الرابعة والعشرين، وجد أن جذر العنصرية راسخ في أوروبا التي هاجر منها الأميركيون، وأن معتقداتهم تعود في أساسها لتكوينهم الأوروبي... «لم يكونوا أميركيين بالمُطْلق، بل كانوا أوروبيين منبوذين، وجدوا أنفسهم في مواجهة قارة عظيمة لا تُهزم، يتجولون في أسواقها، مثلاً، ويرون الرجال السود للمرة الأولى»، هكذا كَتب.
في مقال له بعنوان: «غرباء في القرية»، نُشر لأول مرة في مجلة «Harper’s Magazine» عام 1953، وأُعيد نشره لاحقاً عام 1955، ضمن مجموعة مقالات بالدوين «Notes of a Native Son» «مذكرات ابن البلد»، يروي بالدوين تجربته الشخصية بوصفه رجلاً أميركياً أسود يزور قرية سويسرية نائية بيضاء بالكامل، أوائل خمسينات القرن الماضي، وفي هذه التجربة، يستكشف بالدوين الفجوة العميقة بين تجربة السود في أميركا وإدراك الأوروبيين للعِرق.
ماذا يعني أن تعيش أسود في عالم يهيمن عليه البيض؟ يُبرز بالدوين التباين الصارخ بين عالمه في أميركا، الذي يتميز بالعنصرية والتوترات العِرقية، وهذا العالم الأبيض النقي الذي لم ير فيه شخصاً أسود من قبل، فقد كان سكان القرية ينظرون إليه بفضول وحَيرة كأنه مخلوق آخر، بل يصل الأمر إلى توجيه الإهانات بحقه في الأماكن العامة، وكان الأطفال يصرخون مندهشين وهم يشيرون إليه في الشوارع: زنجي! زنجي!
يرى بالدوين أن الأميركيين البيض يشاركون الأوروبيين في إيمانهم العميق بالتفوق العِرقي والعنصري، هذه الفكرة تنبع من تجاهُل الدور الأوروبي في الاستعمار والعبودية؛ ما تسبَّب في تشكيل العالم الحديث، وألقى بظلاله على العلاقة مع السود؛ ولذلك لم يكن العِرق مجرد مسألة تتعلق بلون البشرة، بل كان بناءً اجتماعياً وفكرياً وتاريخياً معقّداً، ومع المدة ترسخت هذه القناعات، وتفشت عبر الأجيال الذين حملوها إرثاً من آبائهم، حتى أصبح التاريخ يلاحق الضحايا جيلاً بعد جيل. هنا يصبح الزمن جامداً لا يتحرك ولا قيمة له... الشباب الذين يولَدون من رحِم المدينة هم أنفسهم أبناء القرى والأرياف الذين تشرَّبوا ثقافة التفوق والاستعلاء والخصوصية، ونبذ المختلف، لذلك تتشكل المجتمعات الحديثة ببطء شديد وبعثرات لا تنتهي، وسائل الإعلام والتواصل تصنع ثقافة سطحية، وتبني وشائج هلامية، وتشكّل قبائل ومعارف وهمية وافتراضية، الحقيقة على الأرض أن الناس سرعان ما يتنافرون ويتباعدون.
في الستينات برز مصطلح «القرية العالمية» بسبب انتشار تقنيات وسائل الإعلام في أنحاء العالم، سكان القرية كانوا يحلمون بالأسرة الإنسانية، في ظل «تعايش عالمي»، حتى جاء الصحافي الأميركي توماس فريدمان ليعرّف المفهوم الغربي لهذا المصطلح بأنه مجرد «عالم مترابط على شكل قرية وسوق معولمة واحدة»... هل صُمِّمت هذه السوق ليربح فيها الغني الأبيض، ويتغنى الباقون بالعولمة؟! حسناً حتى هذه «العولمة» أصبحت عبئاً على عاتق زعيم العالم الحديث «ترمب»، فراح يقوّض بنيانها!