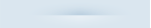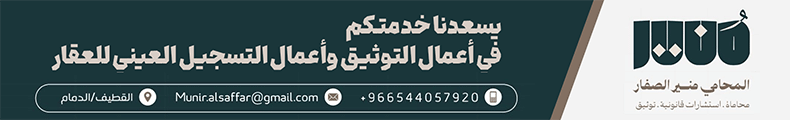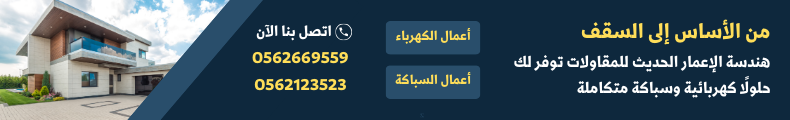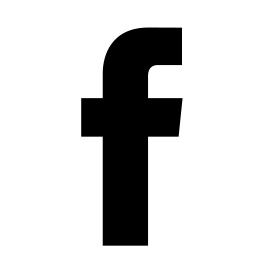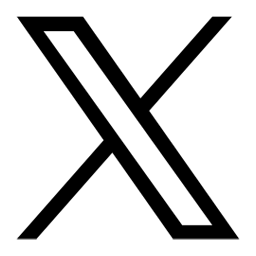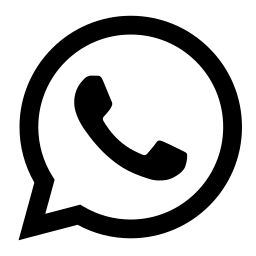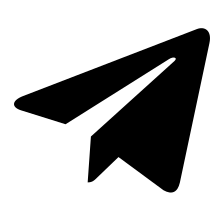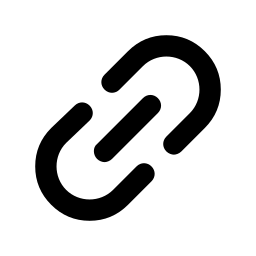الشيخ عبد الله الخنيزي: حكمة القاضي، وبصيرة العالِم، وإنسانية المصلح
في حياة الأمم، لا يُقاس أثر العظماء بكثرة أتباعهم ولا بعلو مناصبهم، بل بعمق التأثير الذي يخلّفونه في الضمائر، وصدق القيم التي يزرعونها في المجتمعات. وفي شرق المملكة، من أرض القطيف التي لطالما أنجبت رجال فكرٍ وعلمٍ واعتدال، يبرز اسم الشيخ عبد الله بن علي الخنيزي كواحد من أعلام الفقه والقضاء والإصلاح الثقافي، الذي جمع في شخصيته بين المعرفة الواسعة، والسلوك الرصين، والخطاب المتزن.
إن الحديث عن الشيخ الخنيزي لا يعني فقط استحضار سيرة شخصية، بل هو فتح نافذة على جيل من العلماء الذين حمّلوا أنفسهم مسؤولية التنوير الديني، والارتقاء بالوعي الاجتماعي، وبناء جسور الثقة بين العلم والمجتمع.
وُلد الشيخ عبد الله الخنيزي في عام 1350 هـ / 1931 م، وسط بيئة دينية علمية في بلدة القليعة، القطيف. نشأ في بيت والده، الشيخ علي بن حسن الخنيزي، أحد كبار علماء المنطقة، مما جعله ينهل من معين العلم منذ طفولته. درس مبادئ العلوم الشرعية، واللغة العربية، والمنطق، وعلوم القرآن على يد نخبة من علماء المنطقة، ثم رحل إلى النجف الأشرف، العاصمة العلمية للفقه الإمامي في العالم الشيعي، حيث تتلمذ على أيدي كبار الفقهاء، ونهل من علومهم بوعي الباحث لا بحفظ المقلد.
عاد الشيخ الخنيزي إلى القطيف في أوائل الثمانينات الميلادية، حاملاً معه رصيدًا علميًا عميقًا، وتجربة فكرية ناضجة، أهّلته لأن يكون من أبرز المرجعيات الدينية في المنطقة الشرقية.
في عام 1422 هـ / 2001 م، تم تعيين الشيخ عبد الله رئيسًا لمحكمة الأوقاف والمواريث بالقطيف، وهو المنصب القضائي الأعلى في القضاء الجعفري الرسمي بالمملكة. وقد مارس مهماته القضائية بروح العدل والضمير، متسلحًا بالعلم الشرعي، وفهم النظام، وحسّ المسؤولية الاجتماعية.
عُرف عنه أنه كان ميّالًا إلى الإصلاح قبل الحكم، والمصالحة قبل القطيعة، والرفق قبل الشدة. لم يكن القضاء لديه مهمة إدارية، بل رسالة قيمية، يسعى من خلالها إلى حفظ الحقوق، وصون العلاقات، وتقريب النفوس المتباعدة.
وقد تميّز عهده القضائي بقدرته على مواءمة أحكام الفقه مع متطلبات النظام القضائي الحديث، ما عزز مكانة القضاء الجعفري وثبّته كجزء فاعل في منظومة العدالة السعودية.
لم يكن الشيخ عبد الله الخنيزي فقيهًا فقط، بل كان كذلك أديبًا، كاتبًا، وشاعرًا. امتلك نَفَسًا أدبيًا رفيعًا، وأسلوبًا راقيًا في التعبير، استخدمه لنشر القيم، ومعالجة القضايا الفكرية، وإحياء اللغة في زمن عزّ فيه حضور الأدب الهادف.
من مؤلفاته البارزة:
• أبو طالب مؤمن قريش
• مداميك عقدية
• أدواؤنا
• الحركات الفكرية في القطيف
• زهرات «ديوان شعري»
• ألق من الذكرى «مقالات وتأملات فكرية»
تتنوع مؤلفاته بين الفقه، الفكر، السيرة، والأدب، وقد أسهمت في تشكيل مشهد ثقافي متزن، يخاطب العقل، ويوقظ الوجدان، ويعزز الانتماء الروحي للإنسان والمكان.
كان للشيخ الخنيزي حضور مؤثر في المشهد الاجتماعي المحلي، حيث مارس دور المُرشد والموجه والناصح. لم يكن منغلقًا داخل حوزته أو مكتبه، بل انخرط في المجتمع، مشجعًا على طلب العلم، داعمًا للمبادرات التعليمية، وحاضرًا في المناسبات العامة والخاصة، بروح الأب والناصح الحكيم.
كما سعى إلى تقريب وجهات النظر بين الأفراد والعائلات والجهات، وكان مرجعًا مقبولًا في حل النزاعات بعيدًا عن التعقيد أو التشهير، واضعًا مصلحة المجتمع فوق كل اعتبار.
لا تزال بصمات الشيخ عبد الله الخنيزي حاضرة اليوم في خطاب العديد من علماء القطيف وطلبة العلم، وفي المدارس الفكرية التي تربّت على يديه. فهو يمثل رابطًا بين جيل المؤسسين، وجيل النهضة الثقافية الجديدة التي نشأت في المنطقة الشرقية خلال العقود الأخيرة.
كما أن مؤلفاته تُدرّس وتُناقش، ومقالاته تُستلهم، ومواقفه لا تزال تُروى كنماذج على العدالة والتعقّل والرحمة في زمن كان فيه الانفعال أسهل من الحكمة.
إن سيرة الشيخ عبد الله الخنيزي تُعبّر عن نموذج نادر من العلماء الذين جمعوا بين صرامة الفقه، ورقّة الكلمة، وعدل القضاء، ودفء الإصلاح. لم يكن عالمًا ينعزل في برجه العاجي، بل كان قريبًا من الناس، متواضعًا في حضوره، واسعًا في علمه، صادقًا في موقفه.
علمه لم يكن مجرد دراية، بل هداية. قلمه لم يكن أداة بلاغ، بل وسيلة بناء. ومنصبه لم يكن سلطة، بل تكليف أخلاقي يمارس به مسؤوليته تجاه مجتمعه.
في زمنٍ تتداخل فيه الأصوات، وتتشابك فيه المفاهيم، نحن بحاجة ماسة إلى تذكّر أمثال الشيخ عبد الله الخنيزي، لا بوصفهم رموزًا من الماضي، بل مصابيح هادئة ترشد الحاضر نحو التوازن، والوعي، والعدالة.
سيرة هذا العالم الجليل ليست تاريخًا يُروى، بل منهج حياة، وأثر يُحتذى به في العلم، والعمل، والمجتمع.