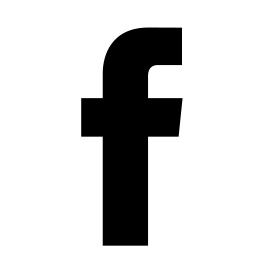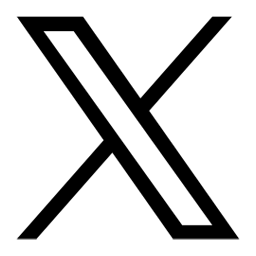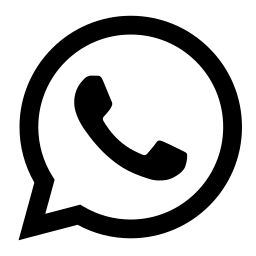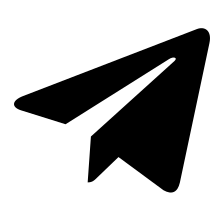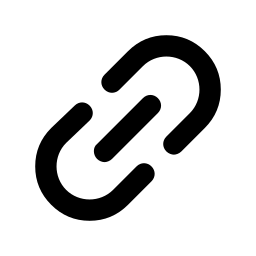إيليا يبتسم
«كن بلسماً إن صار دهرك أرقما وحلاوةً إن صار غيرك علقماً»
إيليا أبو ماضي.
في مساءٍ بهيج، وفي دار المشرافي، ذلك الصالون الثقافي الذي أصبح علامة ثابتة ومضيئة في المشهد الأدبي في المنطقة، وتحت مظلة جمعية الأدب المهنية التي باتت تؤسس بوضوح لدور نوعي في رعاية الأدب والأدباء، وضمن رؤية وزارة الثقافة المنسجمة مع مشروع رؤية المملكة 2030، التي لا تفصل بين التنمية والفكر، ولا بين المستقبل والخيال.. قدّمتُ ورقة بعنوان «سرديات البهجة: كيف يكتب الأدب حكاية السعادة؟»، وهي محاولة لتأريخ الفرح في الخطاب الأدبي، وتتبّع تجلياته عبر النصوص الأدبية.
لكن إيليا أبو ماضي، الشاعر الذي لا يغيب طويلًا عن مساحات البهجة، حضر متأخرًا وبعد نهاية الورقة، لا بجسده، بل عبر سؤال طرحه أحد الأدباء الضليعين بالشعر واللغة قائلًا:
لماذا لم تتطرقي إلى إيليا أبو ماضي؟ ذاك الشاعر الذي ارتبط اسمه بالفرح والتفاؤل واللغة البيضاء.
هل حقًا نسيتُ إيليا؟ الشاعر الذي قال:
أيّها الشاكي وما بك داء
كن جميلاً ترَ الوجودَ جميلا"
لم يكن السؤال مجرد ملاحظة نقدية، بل استدعاء حقيقي لشاعرٍ لطالما وقف في صفّ البهجة، وعارض كآبة العالم بمفردات ناعمة، ووعي عميق.
وعدتُ الأديب بأن أعود إلى إيليا وأكتب عنه، ولم يكن وعدًا عابرًا. شعرت أنني مدعوة، لا لكتابة مقال، بل لتسديد دين أدبي.
فشاعر مثل أبو ماضي لا يُذكر على الهامش، بل هو المتن. لم يُذكر في ورقتي، لكنه كان بين السطور، في نبرة صوتي، في اختياراتي اللغوية، وفي قراري أن أكون - بوضوح - في صف البهجة، لا في طابور الحزن الممتد..
وإذ أكتب الآن عنه، أشعر أنه لا يزال يبتسم خلف بيت قاله، ولم ينتبه له كثيرون:
«فاضحك فإنّ الشهب تضحك والدجى
متلاطمٌ، ولذا نحب الأنجما»
ثم يُردف:
«قال: البشاشة ليس تسعد كائنًا.. يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغمًا»
«قلت: ابتسم ما دام بينك والردى.. شِبر، فإنّك بعد لن تبتسمَا»
ربما لم أستدعِ إيليا في ورقتي، لكن.. هو من استدعاني إلى هذا النص.
وللحديث بقية يا صديقي.