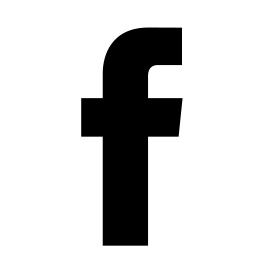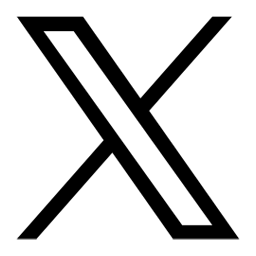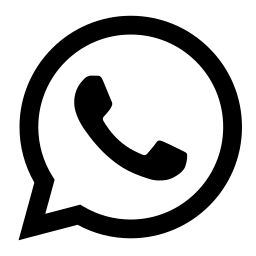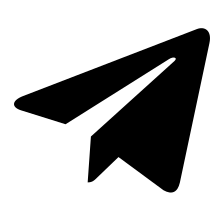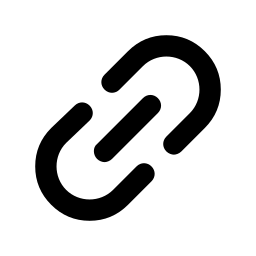الدكتور باقر العوامي… ذاكرة القطيف وضميرها الطبي
في مساءٍ ثقيلٍ على القطيف، أُطفئ قنديلٌ من قناديلها المضيئة، ورحل الدكتور باقر العوامي بعد عمرٍ طويلٍ حافل بالعلم والطب والعطاء. لم يكن رحيله مجرد خبر وفاة، بل كان زلزالًا في القلوب التي عرفت فيه الأب، والأخ، والرفيق، والإنسان الذي لا يكتفي بأن يمدّ الدواء، بل يغرس الأمل في النفوس.
كان الدكتور باقر العوامي طبيبًا، لكن تعريفه لا يقف عند حدود المهنة. لقد جعل من الطب رسالة، ومن العلم أداة رحمة، ومن كل مريض يمر بين يديه حكاية إنسانية تستحق أن تُعاش بصدق. لم يكن ينظر إلى الجسد بوصفه حالة سريرية، بل كان يرى فيه إنسانًا كاملًا يحتاج إلى كلمةٍ طيبة بقدر حاجته إلى وصفة علاج. كان يرى في الطفولة وطنًا مصغرًا، وفي وجع الأمهات مرآةً للضمير، وفي كل ابتسامة عافية دليلًا على أن الإنسانية نفسها أعظم علاج.
لم يكن حضوره مقتصرًا على غرفة العلاج أو قاعات الجامعة، بل تجاوز ذلك إلى المجتمع بأسره. كان صديقًا للمحتاجين، ناصحًا للجيل الجديد، ووجهًا من وجوه البذل والعطاء. فكما أن يده كانت تكتب الوصفات الطبية، فإن قلبه كان يكتب وصايا الأمل. حمل همّ القطيف كما يحمل الأب همّ أبنائه، وظلّ يذكّر الناس أن الصحة مسؤولية مشتركة، وأن العلم بلا إنسانية جثة بلا روح.
لم يكن الدكتور باقر العوامي مجرد طبيب يمارس مهنته اليومية، بل كان باحثًا ومجددًا. من أبرز بصماته:
•تأسيس المكتبة الطبية في القطيف بجهدٍ مبارك وبأيادٍ خيّرة من آل جواد، لتصبح مرجعًا للطلاب والباحثين.
•مساهمته في إدخال الزمالة العربية لطب الأطفال، التي فتحت أبواب التخصص أمام أطباء الشرقية، وكانت باكورة مرحلة جديدة في التعليم الطبي.
•ريادته في المشاريع الوقائية مثل مقترح فحص ما قبل الزواج، الذي صار فيما بعد مشروعًا وطنيًا حمى آلاف الأسر من الأمراض الوراثية.
•بحثه الرائد في مسح أكثر من تسعةٍ وعشرين ألف مولود، الذي صار مرجعًا للأطباء والباحثين، ودليلًا على أن الطبيب إذا صدق يمكن أن يكون مؤرخًا للصحة وصانعًا للمستقبل.
كل من عرف الدكتور باقر يدرك أن إنسانيته كانت تسبق علمه. كان يطلّ على المريض بابتسامةٍ أوسع من الألم، ويمد يده لا ليكتب وصفةً فقط، بل ليمنح طمأنينةً تُعيد للمريض يقينه بالشفاء. لقد آمن أن الطب قبل أن يكون علمًا هو فن الإصغاء للروح. ولذلك، لم يكن غريبًا أن يرى فيه الناس أبًا رحيمًا قبل أن يروه طبيبًا ناجحًا.
ورحيل الدكتور باقر يستحضر غيابًا آخر لم يبرأ منه قلبه يومًا: غياب رفيقة عمره التي سبقته إلى دار البقاء قبل أربع سنوات. لقد عاش بعد رحيلها ندبةً مفتوحة، وكأن نصفه الآخر قد أُخذ منه. واليوم، شاء القدر أن يجمعهما من جديد في دارٍ لا فراق فيها، حيث الأرواح تلتقي بعد أن افترقت الأجساد. قصتهما معًا شاهد على أن الحب حين يصدق يتجاوز حدود الموت، وأن العطاء حين يتكامل بين قلبين يترك أثرًا خالدًا في الأبناء والمجتمع.
لأبنائه الذين فقدوا الوالدين معًا، أنتم امتداد ناصع لجذورٍ طيبة. أنتم الثمرة التي تذكّر بهما في كل حين، والقناديل التي تواصل رحلتهما في الأرض. لقد غرسا فيكم المحبة والإيمان، وعلّماكم أن العلم رسالة، وأن الرحمة جوهر الإنسان. فكونوا على العهد، واحملوا إرثهما كما يُحمل النور في عتمة الطريق.
إن رحيل الدكتور باقر العوامي ليس غيابًا، بل انتقالٌ من حضورٍ في الجسد إلى حضورٍ في الذاكرة والوجدان. هو قنديل القطيف الذي لم ينطفئ، بل أُطفئ الجسد وبقي النور. وما تركه من أثر طبي، إنساني، وبحثي، سيظل شاهدًا على أن الطبيب حين يصدق في رسالته، يصبح تاريخًا حيًا وذاكرةً لا تموت.
وما أجمل أن يرحل الإنسان وقد ترك وراءه علمًا يُنتفع به، وأثرًا خالدًا، وأبناءً وأحبّة يواصلون رسالته.
رحم الله الدكتور باقر العوامي ورفيقة عمره، وجمع روحيهما في نورٍ لا يخبو، وجعل من ذكراهما نبراسًا للأجيال القادمة.