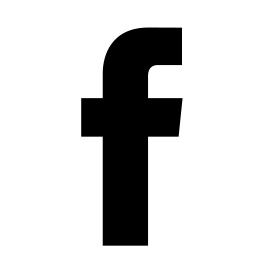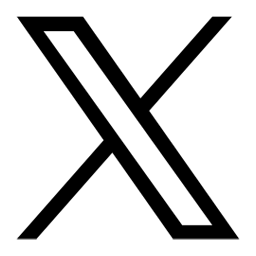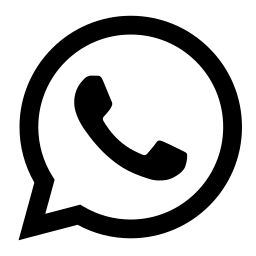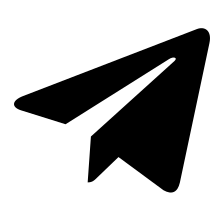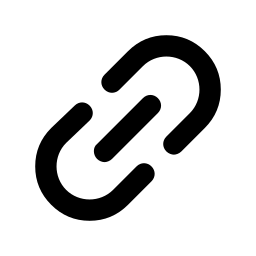في نقد ثقافة الاختيار المجتمعي
في المجتمعات كما في السفن، ليس كل من أمسك بالدفة يُعد رباناً، وليس كل من جلس على الكرسي يُعد قائداً، فالقيادة ليست لقباً يرفع ولا مقعداً يُزين، بل هي بصيرة تسبق القرار، وحكمة تحرس الخطوات، وعدل يقيم الموازين. غير أن واقعنا كثيراً ما يخلط بين القشرة والجوهر، فنرى المقاعد تُمنح لمن يعلو صوته لا لمن يصفو عقله، وتُزين الكراسي بمن يجيد الحضور لا بمن يحسن التدبير. وهكذا تتحول القيادة إلى شكلٍ لامع يخفي فراغاً داخلياً، فلا تنهض بها المجتمعات، ولا تستقيم بها الموازين.
إن لحظة الاختيار هي الامتحان الحقيقي لأي جماعة، فهي المرآة التي تعكس وعيها ونضجها وإدراكها لمسؤولية أن تسلم زمامها لشخص واحد. فإذا كان الاختيار سليماً مضت الخطوات ثابتة، وإذا كان هشاً تعثرت المسيرة، وفتحت الأبواب على الفوضى والانقسام. وكم من منصب مُنح بوصفه جائزة أو تطييب خاطر، لا تكليفاً بالأمانة، فكان الثمن باهظًا، مشاريع تتوقف، مبادرات تتعطل، وجهود صادقة تُهدر لأن من وُضع على الكرسي لم يكن مؤهلاً لحمله.
ولعل أشد ما يكشف هذا الخلل أنه يتكرر في صورة الحياة اليومية، في أصغر الدوائر كما في أكبرها. ففي الجمعيات الخيرية، التي يُفترض أن تكون ساحات للعطاء، كثيراً ما نجدها ساحة خصام حين يتصدر من يرى في المنصب وجاهة، فيختفي الهدف الأساس، خدمة الناس. وفي المجالس العائلية يُنصب الأكبر سناً وكأنه الأعرف والأعدل، بينما قد يكون الأصغر خبرة أو أرحب صدراً أو أوعى بالتحديات. فتنقسم الأسرة بدل أن تتماسك، ويغيب العدل حيث كان يجب أن يحضر.
وفي المدارس، حيث تتشكل القيم الأولى، يُرفع شأن الطالب المشاغب ويُنظر إليه على أنه ”صاحب شخصية قيادية“، بينما يُترك المجتهد أو المتفوق في الظل. وهنا تبدأ البذرة الأولى للانحراف، حين يتعلم الطفل أن الضجيج يغلب العقل، وأن الفوضى أقصر طريق للاعتراف. وإذا كبر وهو يحمل هذه الفكرة، نقلها معه إلى الجامعة والعمل والحياة، وأعاد إنتاج النموذج ذاته الذي عانى منه غيره.
أما في بيئات العمل، فالصورة أكثر وضوحاً وقسوة، كم من موظف مخلص بقي في مكانه لأنه لا يجيد المداهنة، وكم من آخر ارتقى لا بجهده بل بقرابته أو بثناء جوفاء يتقنه. وعندها يختل التوازن، يتحول المكتب إلى ساحة نزاعات، وتنهار الفرق، وتضيع المشاريع، فلا تخسر المؤسسة وحدها، بل يخسر العاملون حماسهم وإيمانهم بأن العدل ممكن، ويستقر في أذهانهم أن العمل الجاد لا يكفي، وأن الوصول مرهون بغيره.
حتى في أبسط صور حياتنا الاجتماعية، تتجلى هذه الثقافة. ففي لجان الأحياء أو المبادرات التطوعية، قد يُرفع من يكثر جداله في الاجتماعات، بينما يُقصى من يملك الخبرة العملية والحلول الواقعية، فيضيع وقت الناس في سجالات، بينما تبقى الشوارع على حالها، والمشاكل كما هي. وفي الأنشطة الشبابية أو المناسبات العامة، نرى أحياناً القيادة تُمنح لمن يسعى وراء صورة أو مقطع فيديو، فيتحول النشاط من خدمة جماعية إلى منصة شخصية.
وحين نمد النظر إلى الفضاء الرقمي، تتضح المأساة بألوان صارخة، فالأضواء تتجه إلى من يجيد الجدل الفارغ أو يثير الضحك السطحي، بينما يتوارى أصحاب الفكر والجد. وحين نسأل بحيرة، لماذا تراجع الذوق العام. يكون الجواب أننا نحن من صنع ذلك، نحن من رفع هذه النماذج، نحن من صفق لها وتركنا العقول الحقيقية في الظل.
إن المشكلة ليست في الكرسي بقدر ما هي في الأيدي التي تضع عليه من لا يستحقه، إنها أزمة مجتمع يفضل المظهر على الجوهر، والصوت العالي على العقل الهادئ، والقرابة على الكفاءة، وما يزيد الأمر خطورة أننا نغطي هذا الخلل بعبارات مثل ”حسن نية“ أو ”مجرد تجربة“، بينما هو في الحقيقة تسليم مصير جماعة إلى يدٍ لا تعرف وزنه.
والتاريخ، حتى في أبسط مستوياته، يعلمنا أن المشكلات الكبرى لا تنشأ فجأة، بل تبدأ حين يُوضع الشخص غير المناسب في الموقع الحساس، ومنذ تلك اللحظة تبدأ الانهيارات الصغيرة، حتى تصل إلى السقوط الكبير، ثم لا يبقى للناس سوى البكاء على الأطلال والتساؤل بدهشة، كيف حدث هذا؟ بينما الحقيقة أن الإجابة واضحة، نحن من باركنا الاختيار الخاطئ منذ البداية. لكن النقد وحده لا يكفي. فالمجتمعات لا تنهض بلوم الماضي، بل بتصحيح الحاضر، والخروج من هذه الدائرة يبدأ من التربية الأولى، أن نعلم أبناءنا أن القيادة ليست امتيازاً بل مسؤولية، ليست وجاهة في المناسبات بل خدمة للآخرين، ليست رفعة على الناس بل انحناءً لخدمتهم. يبدأ من المدارس، حين نكفّ عن مكافأة المشاغب على حساب المجتهد، ونربي الأطفال على أن القيادة صبر، وإنصات، وقدرة على جمع المختلفين. يبدأ من العمل، حتى نكافئ الكفاءة لا القريب، والإخلاص لا التملق. ويبدأ من حياتنا الاجتماعية، حين نضع معايير واضحة للاختيار: الخبرة، النزاهة، الحكمة، لا مجرد الحضور أو المكانة الشكلية.
الطريق ليس سهلاً، لكنه ممكن. فكما صنعنا بأيدينا نماذج مشوهة بالتصفيق، يمكننا أن نصنع نماذج صادقة بالتقدير الصحيح. وكما رفعنا السطحي حتى غطى على العميق، يمكننا أن نعيد الاعتبار لصوت الحكمة والمعرفة. إن النجاة ليست حلماً بعيداً، بل خيار يبدأ منا جميعًا، من أصغر قراراتنا إلى أكبرها.
فهل نملك الشجاعة لنراجع أنفسنا؟ أن نوقف دوامة التصفيق للسطحي، وأن نعيد تعريف القيادة بما هي عليه حقاً: وعي قبل سلطة، عدل قبل وجاهة، خدمة قبل مكسب. فإذا فعلنا، أمكننا أن نمنح الدفة لربان يعرف البحر وخرائطه، لا لمن يلوح أمام الركاب. وعندها فقط نستطيع أن نقول إننا اخترنا الطريق الذي يستحق أن نسير فيه.