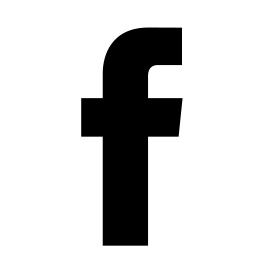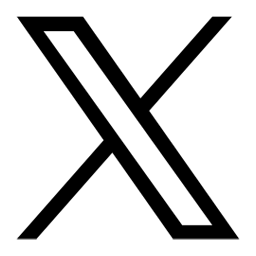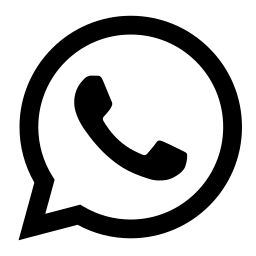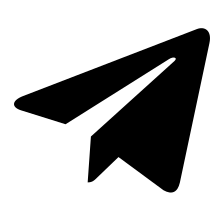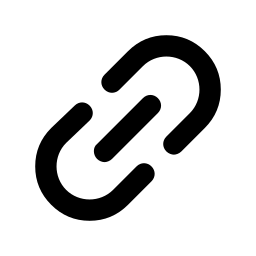الشَّقراء
تقول روزا:
مرت سنتان ونصف على زواج فاطمة من حيدر..
مرت ثلاث سنين منذ عُثِر على حيدر مصابا بكدمات متفرقة في أنحاء جسمه على بعد عدة أميال من بئر الزمكان إياه... كانت فاطمة وتسنيم قررتا المغامرة بالذهاب للبحث عنه، باستخدام منظار مكبر لكي يتفحصا المنطقة عن بعد وأن لا تجازفا بالاقتراب أكثر من اللازم، المشكلة هنا هي أنهما لا تعرفان ما هي المسافة الآمنة من البئر، لكنهما ذهبتا على كل حال..
وجدتا حيدر فاقدا للوعي.. وحين أفاق بعد حوالي نصف ساعة من تحفيزه، كان منهكا ولم يكن يتذكر أي شيء مما حدث له، كان مصابا بكدمات متفرقة في أنحاء جسمه وقد فقد بعض الوزن فبدا مهزولا... أما صديقه فما يزال مفقودا.. وقد حاول أهله اتهام حيدر بتوريطه في تلك المغامرة غير المحسوبة، لكن لم يوجه له أي اتهام رسمي أو تثبت عليه تهمة ما..
كان يشعر بالدوار وفقدان الذاكرة القصيرة خلال الأسبوع الأول بعد عودته، كما بدا أنه كان يعاني من الكوابيس، لكن تلك الأعراض خفت خلال الأسابيع التالية واختفت تماما بعد شهرين، هذا ما أخبرتني به تسنيم وفاطمة.
تسنيم لم تعترف لوالديها بمغامرتها للبحث عن حيدر، بل ادعت أن بعض المتنزهين وجدوه صدفة، ومن ثم اتصلوا بها بعد أن وافق روبوت الطوارئ في مركبتهم على مسحه جينياً ومعرفة هويته بعد تقييم حالته الصحية، كان رقمها مسجلا في بياناته كرقم طوارئ.
لم يتوقف أحد كثيرا عند طريقة عودته، بما أنه عاد بعدما أوشكوا على فقدان الأمل بالعثور عليه...
لكن كل هذا قد مر عليه زمن طويل.
فاطمة أكملت دراسة الهندسة بما أنها تزوجت مهندسا، لكنها تركت العمل بعد أن رزقت بطفلها الأول، وما زالت تقول أنها كانت تتمنى لو أنها درست علم الأحياء البحرية بدلا من ذلك، لكنها سعيدة على كل حال.
كانت قد رأت لارا حين زارتني لأول مرة بعد تعارفنا فقالت لي بدهشة: ”هذي حقيقية؟“
كانت تجن حبا في ابنتي لارا، كان عمر لارا سنتين، وقالت فاطمة أنها تبدو كلعبة.
- ”هل هي حقيقية فعلا؟ يبدو كأنها تعمل بالبطاريات“.
- ”يبدو أنك تزورينني من أجلها لا من أجلي، انتظري حتى يأتي وقت النوم وستفكرين بإخراج البطاريات كي تتوقف عن إزعاجك“.
لا بد وأنها تفهم شعوري الآن.
سمعتُ كذلك بأن المتحف الذي أخبرتني سوزان أنه قد أغمي عليها حين زارته ذات مرة من زمان قبل تعارفنا قد تم إغلاقه... يقال أنه سيئ التهوية ونظام التكييف فيه قد يضر بصحة الناس، خاصة المهاجرين من تيتان والمريخ. حين أفاقت سوزان ذكرت بأن شيئا ما أخافها.. لكنها لم تتذكر ما هو. فقط تتذكر أنها كانت تشعر بضيق في التنفس طوال مدة الزيارة.. وأنها - على الرغم من ذلك - استمتعت بها.. خبر إقفال ذلك المكان راق لراحيل التي وصفته بأنه ”زفت“، لا أعرف من أين تأتي راحيل بتلك المصطلحات! كل ما لا يعجبها البتة هو ”زفت وزفت وأزفت منه ما شفت“، الحق أنها تستعمل الكثير من المفردات التي لم أسمع أحدا غيرها يتفوه بها قط، وكثيرا ما أطلب منها شرح معناها لكنها دائما تفسر الماء بالماء... اسمها نفسه يبدو لي وكأنه ينتمي إلى عالم الأحافير.. لكن لا تخبروها - من فضلكم - أنني قلت ذلك.
تسنيم تعتقد بأن حضارة غير بشرية قد سبق وأن زارت الأرض، حضارة من خارج الكواكب التي تدور حول نجمنا، لكنهم رحلوا، ولم يعد باستطاعتهم العودة... ربما يتمكنون من إرسال بعض الرسائل، أو التلميحات، لكنهم لن يأتوا.. وأنه قد وُجدت عندهم معتقدات دينية تحرم غزو الفضاء والكواكب المأهولة! إن أردت رأيي فهي تكاد لا تعرف شيئا عن المعتقدات الدينية للبشر لكي تتفلسف حول معتقدات حضارات غير بشرية! أعتقد أن تعاملها مع الربوتات والذكاء الاصطناعي طوال الوقت قد سبب لها شيئا من الخبال... وجعلها لا تفرق كثيرا بين الاحتمالات والافتراضات وبين الواقع! أو بين الخيال والتاريخ، لكن فضلا لا يخبرنّها أحدكم أنني قلتُ ذلك.. إنها مجنونة قليلا لكنها تظل صديقة جيدة وطيبة.
لكن كفاني حديثا عن الآخرين.. ولأحدثكم قليلا عن نفسي.. مع أن علي أن أحذر بأن حياتي ليست بذلك التشويق.
أنا أعيش بداخل مبنى كبير مغلق ليس به نوافذ، ومغطى بالكامل من الخارج بألواح لحصد الطاقة الشمسية. باستثناء أجزاء مدروسة بعناية لتعطيه طابعا معماريا مميزا.. أجزاء تتعلق بفتحات التهوية والتكييف، بالإضافة إلى مانع صواعق على رأسه صمم ليتناسب مع البناء.. يبدو بالخارج كتحفة معمارية خلابة.
أما من الداخل فهو مصمم ليشبه مدن تيتان قدر المستطاع، ولك أن تخمن أن جميع سكانه هم من العائدين من تيتان.
به ثلاثون وحدة سكنية مع مجمع تجاري يمكنك التجول به أو الطلب عن بعد، بالإضافة إلى عدد لا بأس به من المطاعم والمقاهي، ورياض أطفال، وأنا لا أخرج من هذا الصرح الضخم سوى حوالي مرتين في الأسبوع، مرة للاجتماع بصديقاتي أو زيارة إحداهن فيما لو فوتت اجتماعهن الأسبوعي عند ساحل البحر، والثانية لها طابع عائلي لزيارة أقاربنا أو التنزه مع زوجي وأطفالي في هذا المكان أو ذاك..
لا أكره الشمس، لكنني لا أتعرض لها إلا في أوقات محسوبة، وبالقدر الذي ينصح به الطب المتخصص للعائدين من الفضاء.
لم يضايقني قط أن أعيش في كوكب مُضاء، مع أنه كان من المتوقع من شقراء مثلي أن تخشى الشمس.
أعمل في حضانة للأطفال تقع بداخل المبنى آنف الذكر بالقرب من الوحدة السكنية التي أعيش بها... اسمها ”الفراشات الزرقاء“.
نعم، تخمينك صحيح، لقد تعرفت على فاطمة حين جاءت لتسجيل أخيها الصغير هاشم في الحضانة التي أعمل بها... ثم تشاجَرت معي حين أخبرتها أن الحضانة تخص أولاد العائدين من تيتان، كانت زلة لسان، كنت أقصد أنها مخصصة لسكان المبنى الذي تقع فيه الحضانة. لكنها انفعلت، يبدو أنها كانت لا تصدق أن تتكبر تيتانية على مريخية، قالت أنها أقرب دار حضانة للأطفال إلى بيتها.. ثم غَضِبَت أكثر حين أشرتُ للطفل على أنه ابنها... صاحت بي بأنها أخبرتني مرتين بأنه أخاها الأصغر وأنني لم أصغِ باهتمام إلى أي شيء قالته. لقد قبِلت الطفل في الحضانة على كل حال، وانتظرت توبيخ أو تدخل إدارتي لإلغاء قبوله.. لكن لم يحدث شيء.
حملتُ هاشِم بعد مغادرة فاطمة، والذي أشار إلى لوحة كبيرة - لا بد وأنها تبدو عملاقة بالنسبة له - قائلا بحماس: ”دا دا“، اللوحة كانت صورة ثلاثية الأبعاد للمجموعة الشمسية مع رسم قلب فوق كل من الأرض والمريخ وزحل... أُنظر إلى نفس اللوحة من زاوية أخرى وسوف تتغير إلى صورة كذلك ثلاثية الأبعاد وعالية الوضوح لرائد فضاء في بدلة رواد الفضاء الحديثة، والتي كلما رأتها الطفلة مَيّ، عمرها سنتين، أشارت إليها قائلة: ”بابا“.
جدران الحضانة مصبوغة بلون مشمشي بَهيّ، وكراسي الأطفال برتقالية اللون، مع عدد من أرائِك الصوفا المريحة بأحجام تناسب الأطفال الصغار بأشكال الحيوانات موزعة هنا وهناك، وبساط ليلكي كبير في المنتصف، يوجد ركن مصمم كفصل دراسي، وركن للألعاب، وركن سينما يعرض أفلاما علمية للأطفال مرة كل أسبوع، لكنني لا أعتقد أنهم يفهمون منها شيئا، تلك الأفلام تناسب فئة عمرية أكبر قليلا لو أردت رأيي، لا تريده؟ هذا لا يهم، طالما أن الفِلم يريحني من صَخبهم لفترة ما..
قصة اليوم هي ما حدث في أحد الأيام في تلك الحضانة..
سمِعت من بعيد صراخ الأطفال، وكأن شجارا عنيفا قد احتدم بينهم.
عنيفا؟ إنها كلمة كبيرة بالنسبة إلى أطفال في سنهم الصغير جدا، ولكن أقسم أن هذا ما خطر ببالي، كنت أساعد طفلا تعلم لتوه استعمال الحمام، حين سمعت صياحه، هرعت مهرولة إلى ركن الألعاب، لأجد سرمد، وهو صبي في الثالثة من عمره، يمسك لعبة ويضربها في الحائط بغضب جنوني، كانت واحدة من تلك الأرانب التي تلبس التوكسيدو السوداء، وهي مصنوعة باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد بإشراف الذكاء الصناعي وبلا تدخل بشري يذكر.... تذكرون سرمد؟ الطفل الذي شد شعري حين جاءت أمه لتسجيله في الحضانة قائلا: ”لماذا شعرك أصفر؟“.
كان سرمد يصيح في الدمية: ”أنتَ شرير“، أخذتها منه فأخذ يضربني ويبكي وهو يردد: ”خطر... خطر“، خطر؟ متى تعلم هذه الكلمة؟ لكنني ذعرت حين نظرت إلى عينيّ الدمية، والتي كانت تنظر إلى عينيّ بتحدي!
كأنها عيون شخص حقيقي بالغ، حتى الربوتات المتطورة جداً لم أر أبداً في عيونها مثل هذه النظرة.
ذعرت فوقعت اللعبة من يدي، فأخذ سرمد يركلها مردداً: ”أُترك مس روزا وشأنها“.
حملت الطفل وأخرجت من الثلاجة بعض الجيلي الذي ما إن رآه حتى نسيَ كل شيء عن الدمية، ثم انشغلت ببعض الأطفال الذين جاءوا يطالبون بنصيبهم من الجيلي بدورهم، راج أوقع نصيبه على الأرض وبكى.... لكنني ما أن فرغت وتفرغت قليلا حتى شعرت ببعض القلق وعدم الراحة إذ رأيت تلك اللعبة مرمية على الأرض، هل توهمتُ نظرَتها المتحدية تلك؟ قررت أن أضعها في ركنٍ بعيد خلف باقي الدُّمى فلم أكن لأتركها على الأرض على كل حال، ولا أريد أن يلعب بها طفل آخر.. يكفيني مشاكل.
التقطها.. بدت لي لعبة عادية جدا.. مملة جدا.. مكررة جدا... سوف تختفي من السوق قريبا بلا شك.
كانت دمية بدائية تماما مقارنة - مثلا - بالطائرة المسيّرة التي كانت تلعب بها تشو لي أو الروبوت الذي كان يلعب به بيدرو.. حتى لعبة لويس التي لا أدري ما هي بالضبط تبدو أكثر تعقيدا من هذه..
كان لديهم نصف ساعة من اللعِب الحُرّ قبل أن تبدأ حصة تعليمهم الحروف الأبجدية، لقد تأخرنا قليلا على الدرس، لكننا لا نهتم كثيرا بالوقت هنا.. إنها مجرد حضانة للأطفال الصغار كما تلاحظ...
بينما كنت في طريقي لوضع الدمية إياها فوق الرَّف، قمت - لا أدري لمه - بهزها وإذا بصوت يخرج منها قائلا: ”هللل تَسممعني؟ ههل...؟“.
كان الصوت خافِتا فقربت أذني فأعادت اللعبة الجُملة بصوت مرتفع آلمني حتى أنني صرخت: ”أَي!“.
أجفلَت طِفلة عمرها أقل من سَنة من صرختي فبكت، وضعتُ الدمية على طاولة قريبة وذهبت لتهدئتها.
ثم عدت للدمية ورفعتها متفحصة.
ولا أعرف لماذا فعلت ذلك، فقد كلمتها بصرامة وكأنني أكلم شخصاً عاقِلا، أو أحاول حماية أطفالي منه، قلت: ”والآن.. ماذا عِندنا هنا؟“.
- ”شَغِّلي الهولوقرام“.
ماذا؟ أي هولوقرام؟ هذه ليست لُعبة مُزَودة بهولوقرام ولا بأي شيء.. ليسَت فيما أعلم من الدمى عالِية التِقنية، ضَربتها على ظهرها مرتين فخَرَج مِن عينيها شُعاع إسقاط كَتَب كَلاماً على الجِدار المُقابل.
ذُعِرت وكِدت أُسقِطها من يدي، لولا أنني تمالكتُ نفسي.
كانت الكلِمات تقول: ”أنا لستُ إنساناً ولا روبوت، أنا أرسِل لكِ هذا التحذير من أطرافِ المجرة، قَومي كانوا هنا منذ دَهرٍ طويل، لقد وجدوا طريقة للعودة، عليكم إطفاء جميع أقمارِكم الصناعية من أجل سلامتكم، إنها تساعِدهم على تحديد موقعكم، أكرر، قد ينتهي الأمر بكارثة تهدد وجودكم، أطفِئوا الأقمار“، سقَطت الدمية من يدي واختفت الرسالة.
بعد أن أفقتُ من الصدمة أخذت الدمية وهززتها وضَربتها لكن لم يخرج منها أي صوت سوى أغاني الأطفال المعتادة، ثم عاتَبتني زميلة لي - اسمها زحل - لأن الأطفال رأوني فبدؤوا يضربون الدمى بدورهم.
هل أخبرها بما حدث؟
لن تصدقني، لن يصدقني أحد.. وسأبدو كمصابة بِجنون الارتياب، ما رأيك أنت؟