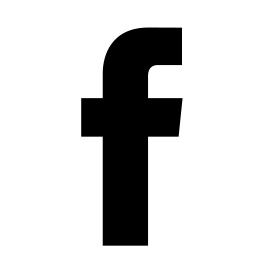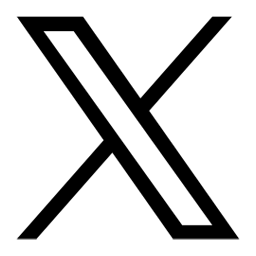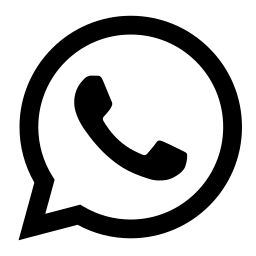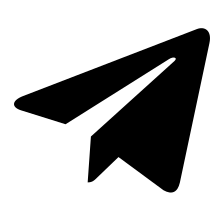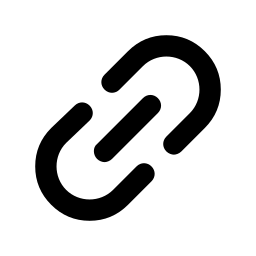تهاني الصبيح: تمثلات الذات والمرأة ورسالة الوجود في فضاء الشعر العربي

حين يصبح الحرف معراجًا: رؤية في شعر تهاني الصبيح
في قلب الأحساء، حيث النخيل يحرس الذاكرة، والماء ينحت في الطين ملامح الخلود، وُلد صوت شعري حمل في نبراته أنفاس الأرض وحنين السماء. هناك، بين فسائل صغيرة غُرست في تربة العطاء، ارتفعت شجرة اسمها تهاني حسن عبد المحسن الصبيح، لتصير إحدى علامات الشعر النسائي في الجزيرة العربية، وصوتًا يتجاوز الجغرافيا نحو فضاءات أرحب.
لم تكن تجربتها الشعرية مجرد بوحٍ أنثوي أو صدى لموروث عابر، بل كانت مشروعًا وجوديًّا متكاملًا، حمل في طياته أسئلة الحرية والهوية، وجسّد جدلية الحنين والاغتراب، فاستحقت أن تُلقَّب بـ خنساء هجر، وأن تُقرأ نصوصها بوصفها ميثاقًا إنسانيًّا يتجاوز حدود النوع والجنس، ليصير النص ذاته هو الهوية.
• في ديوانها الأول فسائل، زرعت البذور الأولى للقصيدة، وطرحت أسئلة الذات والهوية، كما لو أنها تُمهّد لأرض خصبة بالرموز والمعاني.
• وفي ديوانها الثاني وجوه بلا هوية، ارتفعت الأصوات لتواجه الغياب، فكان النص صرخة ضد التهميش، وإعلانًا عن أن الإنسان يُعرّف بإنسانيته قبل أي انتماء آخر.
• أما ديوانها الثالث ما تنكّر من عرش بلقيس، فقد جاء أكثر نضجًا وعمقًا، يعيد قراءة التاريخ والرموز من منظور أنثوي واعٍ، ويضع المرأة في قلب النص بوصفها شاهدة على الذاكرة وحارسة للمعنى.
لقد منحتنا تهاني الصبيح نموذجًا للشعر الذي يوازن بين الموروث والحداثة، بين المكان والكونية، بين الذات والآخر. وفي هذا التوازن يكمن سرّ حضورها، وسبب بقاء نصوصها حيّة، قابلة للاستدعاء والتأويل، وقادرة على أن تكون مرجعًا لجيل جديد من الأصوات الشعرية النسائية.
إنها ليست مجرد شاعرة تكتب قصائد، بل امرأة تصنع هوية بالكلمة، وتفتح للقصيدة العربية فضاءً يتسع للأنثى كذات فاعلة، للحنين كقوة مبدعة، وللرمز كجسر يصل الأرض بالسماء.
نؤكد أن شعر تهاني الصبيح سيظل فسيلة تنمو في أرض الأدب العربي، وتظل وجوهها، وبلقيسها، وهاجرها، وجميع رموزها، إشارات متجددة على أن الكلمة إذا خرجت من القلب، فإنها تبقى حيّة ما بقي الزمن.
هذه القراءة محاولة للاقتراب من عوالم تهاني الصبيح الشعرية، عبر تأمل سيرتها وبداياتها، ثم الغوص في ثيماتها الكبرى: الحنين، المرأة، المكان، الروح، مع تقديم مقاربات نقدية تكشف عمق تجربتها وتنوّع أدواتها.
ولدت الشاعرة والأديبة تهاني حسن عبدالمحسن الصبيح في مدينة الخبر بتاريخ 13 أكتوبر 1975، ونشأت في بيئة أحسائية عريقة تحتضن النخيل والموروث والشعر. من طفولتها حملت عشق الأبجدية، وولع الكلمة، وكان بيتها الأول حاضناً لأحلامها الأدبية. وجدت دعماً كبيراً من والدها - رحمه الله - الذي كان يرى في النساء عماد الوطن وحضارته، فساندها، وحفّزها على القراءة، وشجعها على شراء الكتب ومطالعتها، وأعطاها الثقة لتقرأ بصوت مسموع وتواجه الجمهور بثبات.
أمها كانت رفيقة الروح، تدعو لها وتحيطها بالحنان، ومعلماتها شجعنها واحتضن موهبتها. بهذه الركائز، نشأت بين عناية الله ورعاية الأسرة، وصارت شاعرة تبحث عن ذاتها في عوالم اللغة.
في المرحلة المتوسطة، بدأ الشاعر يسكنها بقوة، إذ شعرت بشيء يجرها إلى ديوان الشعر، فتكثفت قراءاتها لدواوين مختلفة المدارس، وأخذت تكتب نصوصاً وصفتها بـ ”العرجاء“، تسقط مرة وتنهض أخرى، حتى اشتد عودها ونبتت أغصانها، وصارت قصائدها تنبض بالحياة وتُقرأ على المنابر.
حققت تهاني الصبيح تميزاً علمياً منذ بداياتها، حيث حصلت على المركز الأول لجائزة الأمير محمد بن فهد للتفوق العلمي في المرحلة الثانوية عام 1995، وكانت الأولى على دفعتها. هذا الإنجاز لم يكن مجرد تفوق دراسي بل كان اعترافاً مبكراً بجدارتها ونبوغها.
اختارت أن تسلك طريق التعليم لتكون معلمة للمرحلة الابتدائية، فتجمع بين رسالتين ساميتين: رسالة التربية، ورسالة الأدب. كانت ترى في التعليم امتداداً للشعر، وفي الشعر وسيلة لترسيخ القيم والمعرفة التي تنقلها لأجيال المستقبل.
أصدرت تهاني الصبيح عدة مؤلفات، تنوعت بين الشعر والرواية، منها:
• وجوه بلا هوية «رواية»: معالجة جريئة لقضايا اجتماعية تتعلق بالطبقية والزواج.
• فسائل «ديوان شعري»: عملها الأول في الشعر، الذي فتح لها أبواب الجوائز.
• وجه هاجر «ديوان شعري»: عملها الثاني، أهدته لوالدتها رحمها الله، وجاء مليئاً بالعاطفة والحنين.
• ما تنَّكر من عرش بلقيس «ديوان شعري»: عملها الثالث، يحتوي الديوان على أربعة وعشرين قصيدة تقريبًا.
حوار حول ما تنكّر من عرش بلقيس في المجلة العربية:
هناء هبة خولة، ووالدتك، عطفاً
على عنوان الديوان ما تنكر من عرش
بلقيس»، ما السر خلف الأسماء المؤنثة
في ديوانك، أهو انتصار للمرأة أم حنين
الذاكرة؟
أجابت: أظن أن إجابتي تملأ الاحتمالين وهو أن ورود الأسماء النسائية في الديوان هو انتصار للمرأة سيدة العزيمة والبأس والإصرار، المرأة التي ينحت صبرها ملامح
هاجر، ويزيد إصرارها بالسعي الطويل دون توقف أو تراجع، وتأتي فرحتها حين يُزمّ الماء وتنهمر عين الحياة، المرأة التي لم يشغلها مبرد الأظافر، ولم تتذكر وجهها ألوان المساحيق، المرأة الشامخة التي نمت على سواعدها أجيال، وتحررت من وعيها عقول المرأة القادرة على صناعة حضارة وبناء أمة، أما النبش في الذاكرة والتفتيش عن أسماء نسائية متجذرة فيها فهو أمر طبيعي، لأنه بمثابة الوقود الذي سيشعل فتيل النص، ويجعله قادراً على عبور ممرات الضوء، بعد اجتياز كل الدهاليز المظلمة في الحياة، وديواني «ما» تنكر من عرش بلقيس» هو تجل لوجوه نسائية لا تزال ملامحها تشي بالكثير.
حققت تهاني الصبيح حضوراً لافتاً في المشهد الأدبي، وحصدت جوائز مهمة، أبرزها:
•المركز الأول لجائزة الأمير محمد بن فهد للتفوق العلمي 1995.
• المركز الثاني في مسابقة السفير حسن عبدالله القرشي «مصر 2018» عن ديوانها ”فسائل“.
•المركز الثاني في مسابقة اليوم الوطني السعودي 2018 برعاية نادي تبوك الأدبي.
هذه الجوائز رسخت مكانتها كواحدة من أبرز الأصوات النسائية السعودية، وأكدت أن صوتها قادر على أن يتجاوز حدود المحلية إلى فضاء عربي أوسع.
• ترجم لها في معجم السرد بالأحساء
• ترجم لها في معجم شعراء الأحساء المعاصرين في الفترة «1401 - 1430 هـ الصادر عن / نادي الاحساء الادبي
• ترجم لها في كتاب معجم أعلام النساء في المملكة العربية السعودية للكاتبة اللبنانية غريد الشيخ محمد
• التعريف بسيرتها الذاتية ضمن مجموعة من الأديبات السعوديات في كتاب «ومضات سيرية «للأستاذة الدكتورة نوال السويلم
انتُخبت عضواً في مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي خلال الفترة من 2011 - 2019، وكانت أول سيدة تنتخب في هذا الموقع على مستوى المملكة. خلال عضويتها، أشرفت على النشاط النسائي، وأطلقت برنامج رعاية الموهوبات، الذي كان بمثابة المظلة الثقافية لفتيات وضعن أقدامهن على عتبة الكتابة، فصارت تجلس معهن مرتين في الشهر، وتمنحهن مفاتيح الإبداع، وتفتح لهن الطريق نحو عالم الأدب. كذلك، هي عضو جميعة أدب المهنية بالمملكة العربية السعودية.
لم تقف حدودها عند الأحساء أو السعودية، بل امتدت مشاركاتها إلى عواصم عربية وعالمية:
• مهرجان الشارقة للشعر - الإمارات.
•مهرجان الرمثا للشعر العربي الفصيح - الأردن «2019».
• المركز العالمي للدراسات العربية - باريس.
• مهرجان الخنساء للشعر الفصيح - عمّان.
•مهرجان حوران للشعر العربي - إربد «الأردن».
• أمسيات أدبية في البحرين ومصر والسعودية.
من أبرز محطاتها الثقافية مشاركتها في قافلة النخيل التي نظمتها أكاديمية الطائف بالتعاون مع هيئة الثقافة والأدب. وصفتها بأنها أجمل محطة ثقافية في حياتها، لأنها اختصرت الوطن في قصائد شعر، وأعادت لها قيمة الشاعر عند العرب الأوائل. رأت في هذه القافلة فرصة لتتعلم معنى التواضع من قامات شعرية كبرى، وأدركت أن الشعر لا يزال يحمل قيمة إنسانية وجماعية عظيمة.
بهذا الحضور، جسدت تهاني الصبيح صورة الشاعرة السعودية التي تمثل وطنها وترفع راية الإبداع النسائي في كل محفل.
لقبت بـ ”خنساء هجر“ يوم وقفت على منصة سوق عكاظ بالطائف وألقت قصيدتها أمام جمهور عربي عريض. كان ذلك في بداياتها، وحينها صفقوا لها بحرارة ومنحوها اللقب، الذي تبنته بفخر واعتزاز، معتبرة إياه لقباً وطنياً حتى النخاع. ومنذ تلك اللحظة، صارت تفاخر بأنها خنساء المملكة، تستحضر بذلك التراث الأنثوي الكبير للشعر العربي، وتعيد تقديمه في ثوب حديث.
منذ خطواتها الأولى في عالم الأدب، أعلنت تهاني الصبيح أن الشعر هو ملاذها الأرحب والأكثر صدقاً. ورغم أنها خاضت تجربة السرد في روايتها الأولى «وجوه بلا هوية»، التي تناولت قضية الفوارق الطبقية في الزواج مؤكدة أن المحبة هي الجسر الأسمى الذي يوحّد البشر، إلا أنها رأت لاحقاً أن الرواية كانت محطة عابرة في مسيرتها. فهي تعترف بصراحة نادرة: «كنت مخطئة حين كتبت الرواية، لأنني لم أدرك أن الشعر هو دهاليز المعنى البعيد».
بهذا التصريح، تكشف أن الشعر بالنسبة لها ليس مجرد جنس أدبي يمكن أن يُضاف إلى رصيدها، بل هو قدر وجودي وفضاء تتماهى فيه الروح مع اللغة. القصيدة عندها ليست نصاً مطبوعاً على الورق، بل كيان حيّ، أمٌّ تشبهها وتشاركها العطر، وتضيء العمر كما يضيء الزعفران مفرق رؤوس الأمهات. إنها علاقة وجدانية بين الشاعرة وقصيدتها، علاقة حياة وميلاد متجدد.
ورغم ما تسميه بـ «الحصار الفكري والاجتماعي» الذي كبّل المرأة الشاعرة في الأحساء ردحاً من الزمن، لم تتوقف تهاني الصبيح عند تلك الحواجز. بل جعلت منها منطلقاً لتأكيد حضورها، متجاوزة قيود الأعراف التي حالت دون بروز أصوات نسائية كثيرة. فبينما اختارت بعض الشاعرات الصمت أو الاكتفاء بالكتابة في الظل، انطلقت هي بسرعة الصاروخ، تثبت أن الكلمة قادرة على كسر كل جدار.
لقد مثلت تجربتها إعلاناً واضحاً بأن المرأة ليست مجرد متلقية للأدب، بل صانعة له، وأن القصيدة ليست امتداداً لصوت ذكوري يحتكر المشهد، بل فضاء مفتوحاً لكل من يمتلك الشغف والقدرة على صياغة المعنى. وكأنها أرادت أن تقول من خلال حضورها: إن الشعر لا جنس له سوى الحرية.
إن كسرها للقيود لم يكن فعلاً أدبياً فحسب، بل فعلاً اجتماعياً أيضاً. فهي بخطابها الشعري واجهت فكرة الوأد المعنوي للمرأة الكاتبة، وأثبتت أن حضور الشاعرة ممكن بل وفاعل، إذا ما امتلكت الثقة والقدرة على اقتحام المنابر والوقوف جنباً إلى جنب مع الرجال في ساحات الأدب والثقافة. لقد كسرت الصمت الذي ظلّ يلف كثيراً من الأقلام النسائية، وأعادت رسم صورة الشاعرة بوصفها رمزاً للتحدي والإبداع.
وهكذا أصبح حضورها الأدبي شهادة على إرادة امرأة أحسائية اختارت أن ترفع صوتها، وأن تجعل من الشعر جواز عبورها إلى فضاءات أرحب، حيث تلتقي الحرية بالهوية، والذات بالإنسانية، في نصوص تحمل من القوة بقدر ما تحمل من الرقة.
وقد مثّلت مشاركتها في سوق عكاظ لحظة فارقة، حيث ألقت قصيدتها أمام جمهور عربي غفير، فنالت التصفيق والتتويج بلقب «خنساء هجر». لم يكن هذا مجرد تكريم شعري، بل اعتراف علني بأن المرأة قادرة على اقتحام المنابر وكسر القيود. ثم جاء حضورها في مهرجانات عربية مثل الشارقة للشعر، والرمثا بالأردن، والمركز العالمي للدراسات العربية بباريس، ليؤكد أن صوتها تخطى حدود الوطن ليصير جزءاً من المشهد الثقافي العربي.
أما دخولها مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي «2011 - 2019» كأول امرأة منتخبة، فقد كان بمثابة كسر آخر لجدار طالما حجب المرأة عن القيادة الأدبية. بهذا الإنجاز، لم تكتفِ بتمثيل ذاتها، بل مثلت جيلاً كاملاً من النساء السعوديات اللواتي وجدن في تجربتها برهاناً أن الشعر يمكن أن يكون جواز عبور إلى فضاءات الحرية والمشاركة الفاعلة.
إن كسرها للقيود لم يكن موقفاً عابراً، بل جوهر تجربتها كلها. فهي في كل نص وأمسية وظهور، تؤكد أن الإبداع لا يعرف حدوداً، وأن المرأة حين تحمل قلمها تصبح صوتاً لوطن بأكمله. لقد رفعت صوتها بوصفها شاعرة أحسائية سعودية، وأثبتت أن الشعر ليس فقط فنّاً، بل أيضاً رسالة تحرر وصوت حرية.
في قصيدتها «وتر»، تعبّر عن انطلاق الروح نحو فضاء الإبداع، وكأنها تؤكد أن الحرية تبدأ من أول حرف:
وترٌ أنا فلتعزفي الوترا
ولتسكُني الإلهام لو حضرا
أما في قصيدتها «ريح يوسف»، فإن الشوق والحنين يتحولان إلى نداء كوني، لا تحدّه قيود المكان أو الزمن:
يا ريح يوسف من يجاري لهفتي
لو للحنين مسافةٌ ونطاقُ؟
وفي «ذاكرة الطين» نلمس استعارتها الحرية من المطر والخصب، حيث تجعل اللقاء شلالاً يفيض بلا عوائق:
وأنا التي استسقت وأنت سحابها
تهمي ودمعي في لقاكَ غزيرُ
هذه النصوص تكشف أن الحرية عندها ليست شعاراً اجتماعياً فحسب، بل هي تجربة شعرية وجودية. الحرية تتحول إلى نهر، وإلى ريح، وإلى وتر موسيقي، لتصبح القصيدة نفسها مرادفاً للانعتاق والانطلاق
إن مسيرة تهاني الصبيح هي رحلة شعرية بحثت عن الانعتاق منذ بداياتها، فواجهت الحصار الاجتماعي والفكري، وتخطت حدود المكان لتصعد نحو فضاءات عربية ودولية. روايتها «وجوه بلا هوية» كانت بداية سؤالها عن الإنسان والعدالة، لكن الشعر هو الذي جسّد حريتها الحقيقية، لأنه الفضاء الذي وجدت فيه ذاتها وصوتها.
قصائدها لم تكن مجرد نصوص أدبية، بل بيانات شعرية عن الحرية: فهي الوتر الذي يعزف، والريح التي تهب، والسحاب الذي يفيض. في هذه الصور تتجلى فلسفتها العميقة، حيث تتحول الحرية إلى قدر وجودي لا ينفصل عن الشعر، ويتحوّل الشعر بدوره إلى مرآة للحرية
تجربة الشاعرة تهاني الصبيح ليست مجرد مسار إبداعي، بل هي رحلة تحرر ووعي. منذ خطواتها الأولى وهي تعلن أن الشعر هو وطنها الأوسع، وأن الكلمة هي جناحها للتحليق. في قصائدها، تتجسد الحرية رمزًا ومعنى: فهي وترٌ يعزف، وريح يوسف تهب بالشوق، وذاكرة طين تفيض بالمطر. هذه الصور ليست زخارف جمالية، بل بيانات شعرية عن الانعتاق والبحث عن المعنى.
لقد جعلت من الشعر مرآة للحرية، ومن الحرية هوية للشعر. وبذلك تميزت نصوصها بقدرتها على الجمع بين العاطفة والرمز، بين الموروث والحداثة، بين الذات والإنسانية جمعاء. فقصائدها لا تقف عند حدودها الشخصية، بل تنفتح على القارئ لتمنحه فرصة أن يرى ذاته فيها.
إن تهاني الصبيح اليوم تمثل نموذجًا للمرأة السعودية التي كسرت الحصار ورفعت راية الإبداع عاليًا، لتؤكد أن الشعر لا يمكن أن يكون إلا حرًا، وأن الحرية لا تكتمل إلا حين تتحول إلى قصيدة تُنشدها الأرواح وتتناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل.
تجلّى إبداع تهاني الصبيح في ديوانيها الشعريين «فسائل» و**«وجه هاجر»**، وهما محطتان أساسيتان في مسيرتها الأدبية. الأول جاء ليؤكد حضورها في المشهد الشعري السعودي والعربي من خلال لغة صافية وصور متجددة، بينما حمل الثاني طابعاً شخصياً عاطفياً أهدته لوالدتها رحمها الله، فغلب عليه الحنين والرثاء العميق الممزوج بالرمزية الوجودية.
قصائدها تنبض بالرمزية والصور المتدفقة، فلا تأتي الصورة عندها مجرد زخرف بلاغي، بل بنية دلالية تفتح النص على مستويات متعددة من التأويل. النص عندها أشبه بمرآة تتقاطع فيها الذات مع الجماعة، والبوح الفردي مع الرمز الكوني.
في قصيدتها وتر تقول:
وترٌ أنا فلتعزفي الوترا
ولتسكُني الإلهام لو حضرا
هنا يتحول الشاعر ذاته إلى وتر، أي إلى أداة موسيقية تعزف على قيثارة الوجود. الصورة تتجاوز بعدها العاطفي لتصبح استعارة عن معنى الكتابة نفسها، حيث يُختزل الشاعر في فعل العزف، وتتحول القصيدة إلى موسيقى روحية تتردد في أذن القارئ.
وفي ذاكرة الطين نجد بعداً وجودياً متجلياً:
وأنا التي استسقت وأنت سحابها
تهمي ودمعي في لقاكَ غزيرُ
هذه الصورة تجمع بين البعد الوجداني والبعد الرمزي؛ فالعلاقة بين الأنا والآخر تُصوَّر من خلال ثنائية الأرض والمطر، العطش والسحاب، الدمع واللقاء. وهنا يتحول الحنين الشخصي إلى استعارة عن رحلة الإنسان في البحث عن الارتواء الروحي واليقين.
أما في ريح يوسف، فتقول:
يا ريح يوسف من يجاري لهفتي
لو للحنين مسافة ونطاقُ؟
يوسف في هذا السياق ليس مجرد رمز قرآني، بل يتحول إلى استعارة عن الشوق الإنساني الكوني، وعن الحنين الذي يتجاوز الفرد ليصبح شعوراً إنسانياً عاماً. الريح التي تحمل أثر يوسف تصبح رمزاً لانتقال الذاكرة والرغبة عبر الزمن والمسافة، وكأنها جسر يربط الماضي بالحاضر.
إن هذه النصوص تكشف عن لغة متينة محكمة السبك، قادرة على الجمع بين البساطة والإيحاء. فهي لغة مألوفة في مفرداتها لكنها عميقة في صورها ودلالاتها، تحمل في طياتها قدرة على النفاذ إلى الوجدان وتحريك الفكر في الوقت ذاته.
التجربة الشعرية عند تهاني الصبيح أيضاً مشبعة بالموروث الديني والتاريخي؛ فهي تستدعي يوسف وهاجر وزمزم لا لتكرر الحكاية، بل لتعيد إنتاجها شعرياً في سياق معاصر. الموروث يتحول عندها إلى رمز مفتوح يضيء أسئلة الغربة، والحنين، واليقين، والحرية.
إلى جانب ذلك، توازن الصبيح بين التجربة الذاتية والهم الجمعي. فهي حين تكتب عن فقدها الشخصي أو عن حنينها الخاص، تجعل النص أفقاً يتسع لتجربة القارئ أيضاً، فيرى القارئ ذاته في مرآة نصوصها. بهذا، يتحول شعرها إلى جسر يربط بين الأنا والآخر، بين الفرد والمجتمع.
تجربتها الشعرية أيضاً تجربة تجديدية؛ فهي وإن ظلت وفية للشعر العمودي من حيث البنية، إلا أنها تُدخل عليه صوراً ورؤى حديثة، فتجعله ينبض بالمعاصرة دون أن يفقد أصالته. هذا المزج بين التقليد والابتكار هو ما يمنح قصائدها قدرة على التواصل مع الأجيال المختلفة.
بهذا، يمكن القول إن تجربة تهاني الصبيح ليست مجرد محطة فردية في المشهد الشعري السعودي، بل هي إضافة نوعية تثبت أن الشعر النسائي قادر على أن يكون صوتاً فلسفياً وجمالياً ووجودياً في آن واحد، وأن المرأة الشاعرة تستطيع أن تعيد صياغة الموروث بلغة جديدة، تفتح النص على أفق الحرية والدهشة والبحث الدائم عن المعنى.
ديوان «فسائل» كان بمثابة الإعلان الأول عن صوت تهاني الصبيح الشعري. العنوان ذاته يحيل إلى معنى النمو والبداية، حيث الفسيلة رمز للحياة الجديدة، وللانتماء إلى جذور راسخة في الأرض. في هذا الديوان، تتجلى لغة البدايات المفعمة بالأمل والاندفاع، وتسيطر عليه صور الطبيعة والنماء والتجذر في المكان الأحسائي. موضوعاته تميل إلى التأمل في الوطن، والذاكرة، والعاطفة الإنسانية، مع حضور واضح للموروث والرمز الديني الذي يثري النص ويمنحه عمقاً.
أما ديوان «وجه هاجر»، فقد جاء أكثر نضجاً من حيث التجربة والأسلوب. إذا كان «فسائل» يحمل ملامح النمو والانطلاق، فإن «وجه هاجر» يعكس الحنين والفقد، وقد أهدته الشاعرة لوالدتها رحمها الله، فغلب عليه طابع الرثاء المشبع بالرمزية. هاجر هنا ليست فقط رمزاً دينياً، بل استعارة عن الغربة والحنين والرحيل، وعن الأمومة بوصفها طاقة وجودية خالدة. في هذا الديوان، يتعمق الجانب الوجداني والوجودي، وتظهر نزعة فلسفية أوضح، حيث تتحول التجربة الشخصية إلى تأمل عام في قضايا الحب، الغربة، واليقين.
من الناحية الأسلوبية، نجد أن «فسائل» يبرز العفوية والاندفاع الشعوري، مع ميل أوضح إلى الإيقاع العمودي التقليدي، بينما «وجه هاجر» يتسم بـ رصانة لغوية أكبر، واعتماد متزايد على الرمزية والاستعارة الممتدة. هنا تظهر قدرة تهاني الصبيح على المزاوجة بين بساطة العبارة وعمق الدلالة، بحيث يغدو النص قابلاً للقراءة على مستويات مختلفة.
إذن، يمكن القول إن ديوان «فسائل» هو جذور التجربة، بينما ديوان «وجه هاجر» هو ثمار النضج. الأول يعبّر عن بدايات شاعر يبحث عن صوته، والثاني يكشف عن شاعرة ناضجة استطاعت أن تحوّل فقدها الشخصي إلى نصوص تحمل أبعاداً وجودية ورمزية عميقة. وبينهما تتشكل الهوية الشعرية الكاملة لتهاني الصبيح، التي تجمع بين الانتماء إلى التراث والبحث عن حداثة تعبيرية تجعل من الشعر رحلة إنسانية كونية.
قصائد تهاني الصبيح مشبعة بالرموز، فهي لا تكتفي بالتعبير المباشر، بل تبني نصوصها على شبكة من الدلالات المستمدة من الموروث الديني، والتاريخي، والشعبي. شخصيات مثل يوسف وهاجر وزمزم تتحول عندها إلى صور شعرية متجددة تعبّر عن قضايا إنسانية كبرى: الغربة، الحنين، اليقين، والبحث عن المعنى.
• يوسف في نصوصها ليس فقط نبي الجمال والحلم، بل استعارة عن الشوق الإنساني العابر للزمن، وعن الحلم الذي يرافق الإنسان رغم عتمة السجن والتيه. حين تقول:
«يا ريح يوسف من يجاري لهفتي»، فإنها تجعل من يوسف رمزاً للحلم البعيد الذي يظل يسكن الروح، ويستحضر الوفاء وسط الغياب.
• هاجر تتحول في شعرها إلى أيقونة للغربة والصبر. في ديوان وجه هاجر، تعيد إنتاج القصة القرآنية لتصبح رمزاً لكل إنسان يبحث عن ماء اليقين في صحراء الحياة. بكاؤها في الصحراء لا يُقرأ فقط كحدث تاريخي، بل كصورة أنطولوجية عن العطش الروحي الذي لا يرتوي إلا بالسعي.
• زمزم، بدوره، يتجاوز كونه عين ماء مباركة، ليصبح رمزاً للتجدد والارتواء الداخلي. هو عندها استعارة عن الطمأنينة التي تُفجَّر بالسعي، وعن اليقين الذي يروي الروح وسط قلق الحياة.
وليس الموروث الديني وحده ما يشكل خلفية نصوصها، بل أيضاً الأمثال الشعبية والصور الأحسائية المحلية. فهي ابنة بيئتها التي تمزج بين النخيل والصحراء، بين الورد والقرى، لتجعل من تفاصيل المكان رموزاً شعرية. فالنخلة قد تظهر بوصفها رمزاً للثبات والكرامة، والصحراء استعارة عن الغربة، والمطر رمزاً للتجدد والانبعاث.
إلى جانب الرموز، تستند نصوصها إلى تقنيات بلاغية مثل التشبيه والاستعارة. التشبيه يمنح الصور وضوحاً وقوة، بينما الاستعارة تفتح النصوص على عوالم رمزية أوسع. مثال ذلك قولها في ذاكرة الطين:
«وأنا التي استسقت وأنت سحابها»، حيث يتحول الآخر إلى سحاب، والذات إلى أرض عطشى، في صورة كثيفة تختصر تجربة الحب والحنين والبحث عن اليقين.
كما أن التناص مع القرآن الكريم والحديث الشريف يثري نصوصها بمنحها عمقاً روحياً ولغوياً. فهي تستعير من النص المقدس لا لتكراره، بل لتوظيفه في سياق معاصر يربط الماضي بالحاضر، والمقدس باليومي. وهذا التناص يمنح قصائدها بعداً وجودياً، لأنها تستدعي الرموز الدينية لتجيب عن أسئلة إنسانية: الغربة، الفقد، الحب، الحرية.
بهذا، يتحول شعر تهاني الصبيح إلى جسر بين الموروث والحداثة. الموروث ليس أثراً جامداً، بل طاقة حية توظفها لتفسير التجربة المعاصرة. والرمز عندها ليس زخرفاً جمالياً، بل مفتاح دلالي يفتح النصوص على معانٍ جديدة، ويجعل القارئ يشارك في عملية التأويل.
في النهاية، يمكن القول إن قصائدها ترسم خارطة رمزية حيث يتحول الحب إلى نهر يغمر، والحنين إلى غيم يظلّل، والقصيدة إلى جسر يعبر به القارئ نحو المعنى. هذا البعد الرمزي يمنح شعرها قدرة على أن يعيش طويلاً، لأنه يترك مسافة بين النص والقارئ، مسافة هي مجال التأمل والدهشة والتجدد،
تصرح تهاني الصبيح بجرأة أن النقد في المشهد الأدبي السعودي لا يرقى دائماً إلى مستوى النصوص، بل إنه في كثير من الأحيان يخضع لمنطق العلاقات الشخصية والمجاملات أكثر مما يستند إلى أدوات علمية أو منهجية نقدية دقيقة. هذا الموقف يكشف عن وعيها العميق بمشكلة ضعف المؤسسة النقدية في العالم العربي عموماً، والسعودي خصوصاً، حيث يطغى الانبهار بالحدث الأدبي أو بشخصية المبدع على قراءة النصوص قراءة متأنية تكشف عن بنياتها الجمالية والفكرية.
وترى أن تجربتها الشعرية - رغم حضورها في المحافل المحلية والعربية - لم تُدرس بعد دراسة نقدية معمقة تكشف أبعادها المختلفة، سواء من حيث بنيتها الجمالية أو رموزها أو بعدها الفلسفي. فهي تدرك أن حضورها الجماهيري والجوائز التي نالتها لا تكفي لترسيخ اسمها أدبياً إذا لم يرافقها تفكيك نقدي جاد يضيء منجزها ويضعه في سياق الحركة الشعرية السعودية والعربية.
تطمح إلى أن تجد ناقداً يتعامل مع نصوصها بجدية، بعيداً عن المجاملات التي قد تُلمّع النصوص شكلياً لكنها تحجب نقاط القوة والضعف معاً. بالنسبة لها، النقد ليس تهديداً، بل فرصة لإعادة ترتيب الأدوات الشعرية، ومساءلة الذات، والانطلاق بروح جديدة نحو فضاءات أرحب من الإبداع. إنها ترى في النقد مرآة لا بد أن ينظر فيها الشاعر، لا ليبحث عن المديح، بل ليختبر صلابة نصوصه وقابليتها للاستمرار.
كما تعي أن غياب النقد الجاد قد يترك النصوص في دائرة الاستهلاك اللحظي، حيث يتفاعل معها الجمهور في المهرجانات والأمسيات، ثم تُنسى دون أن تُثبت مكانتها في الذاكرة الأدبية. من هنا، تؤكد حاجتها إلى دراسات أكاديمية وأطروحات جامعية تعالج شعرها من زوايا متعددة: التناص، البعد الوجودي، الجمالية اللغوية، والرمزية.
رؤيتها للنقد تتجاوز ذاتها أيضاً؛ فهي لا تتحدث عن تجربتها وحدها، بل تشير إلى أزمة عامة في المشهد الأدبي السعودي، حيث ما زال النقد في أحيان كثيرة أسير الذائقة الشخصية أو الانطباعات السريعة. وهي تؤمن أن الحركة الأدبية لا تكتمل إلا بثلاثة أضلاع: المبدع، المتلقي، والناقد، فإذا ضعف ضلع النقد اختل التوازن وأصبح النص أسيراً لقراءة مبتورة.
بهذا الموقف، تكشف تهاني الصبيح عن نضج فكري يوازي نضجها الشعري، فهي لا تبحث عن الاعتراف المجامل، بل عن النقد الحقيقي الذي يفتح النصوص على احتمالات جديدة. إنها باختصار ترى النقد جزءاً من رحلة الإبداع، لا مجرد تقييم خارجي، بل حواراً داخلياً مستمراً بين النص والقارئ والناقد، يتيح للشعر أن ينمو ويتجدد مع الزمن.
ترى تهاني الصبيح أن الحرية هي الشرط الأول لولادة الشعر، إذ لا يمكن للقصيدة أن تتنفس في فضاء مكبّل. الشاعر عندها طائر يحلّق بجناحين من حب ورحمة، ويصبح صدى لمن لا صوت له، وحارساً لقيم الجمال والنقاء. لذلك فهي تعتبر أن الحرية ليست مطلباً خارجياً فحسب، بل حالة داخلية تنبع من وعي الشاعر بدوره ومسؤوليته.
وقد عبّرت عن ذلك بوضوح حين قالت: «الشاعر لا يولد إلا حراً». هذا التصريح يكشف عن إيمانها بأن الحرية شرط إبداعي وجودي، وأن النص المقيد لا يمكن أن يكون شعراً حقيقياً مهما بلغ جمال صياغته.
أما في مسألة الهوية، فهي ترفض تماماً تقسيم الأدب إلى ذكوري وأنثوي، معتبرة أن النص هوية مستقلة بذاته، وأن القصيدة لا تُختزل في جنس كاتبها. تقول في أحد حواراتها: «القصيدة روح الشاعر وتجليات أفكاره وصوره، ولا تنتمي إلى جنس أو تصنيف». بهذا الموقف، تحرر النصوص من التصنيفات الضيقة، وتعيد الاعتبار للقصيدة كعمل فني مفتوح على جميع القراء.
حتى في نصوصها، يتجلى هذا الوعي بالحرية والانتماء الإنساني. ففي قصيدتها وتر تقول:
وترٌ أنا فلتعزفي الوترا
ولتسكُني الإلهام لو حضرا
هنا يظهر الشاعر في صورة وتر موسيقي، لا رجل ولا امرأة، بل أداة إنسانية للعزف والإبداع. وفي ديوان وجه هاجر، حين تستدعي رمز هاجر، فهي لا تستحضرها كأم فقط، بل كرمز كوني للغربة والصبر، مما يجعل الهوية الأنثوية عندها منفتحة على معانٍ إنسانية أوسع.
بهذا المعنى، يمكن القول إن الحرية والهوية عند تهاني الصبيح ليستا شعارات، بل فلسفة كتابة، تجعل شعرها مساحة انعتاق من القيود، ومنصة للبوح الإنساني الشامل الذي يعانق المختلف والمتعدد.
•فدوى طوقان: رأت الحرية من زاوية نضالية مرتبطة بالوطن والاحتلال، فجعلت شعرها مساحة مقاومة وصوتاً سياسياً يعبّر عن معاناة الشعب الفلسطيني. الحرية عندها حرية جماعية قبل أن تكون فردية، وهو ما جعل قصائدها تنبض بالرفض والتحدي.
• نازك الملائكة: ارتبط مفهوم الحرية لديها بالتجديد الشعري. حررت القصيدة العربية من الوزن التقليدي وأطلقت حركة الشعر الحر. عندها الحرية تعني التحرر من قيود الشكل وبناء أفق جديد للقصيدة.
• سعاد الصباح: وظفت الحرية في بعدها العاطفي والشخصي، فكان شعرها مساحة للتعبير عن الأنوثة والحب والذات، مما جعل هويتها الشعرية مشبعة بالبُعد الوجداني الفردي.
• تهاني الصبيح: تميزت بأنها جمعت بين هذه الأبعاد الثلاثة «الوطني، التجديدي، الشخصي» وأضافت إليها بعداً وجودياً فلسفياً. فهي ترى الحرية شرطاً أنطولوجياً للقصيدة، وترفض في الوقت نفسه أن يُحصر النص في هويته الجندرية. القصيدة عندها إنسانية شاملة، حتى وإن انطلقت من تجربة ذاتية أو نسائية
في نصوص الشاعرة تهاني الصبيح يتجلى الحس الأنثوي الرقيق ممتزجاً بالقوة الرمزية التي تمنح القصيدة عمقاً واتساعاً.
العاطفة عندها تتحول إلى صورة كونية، فالحب نهر يغمر الوجدان ويعيد تشكيل الروح، كما تقول: «وترٌ أنا فلتعزفي الوترا».
أما الغربة فتتجسد في صورة هاجر التي تعكس الرحيل والبحث عن الجذور، كما في ديوانها «وجه هاجر».
اليقين عندها مدار للتجلي الروحي ومنطلق لاتساع الأفق، كما نلمس في قولها: «وبلغتُ من فعل اليقين مداركاً».
قصائدها تمزج بين البوح الشخصي والرمز الجمعي، فتجعل التجربة الذاتية مرآة للهم الإنساني العام.
الاستعارات التي تستخدمها ليست مجرد زخرف لغوي بل مفاتيح لفهم المعنى العميق للنص.
خيالها الشعري خصب، يستعير من الموروث الديني والتاريخي، كما في قولها: «يا ريح يوسف من يجاري لهفتي».
وفي موضع آخر، تستدعي رموز الكون لتفتح النص على آفاق كونية: «قلبٌ أنا حول المجرّة سافرا».
بهذا تصبح نصوصها فضاءً للتأمل في قضايا الحرية، والوجود، والحنين، والانتماء، فتغدو رحلة فلسفية وجدانية تتجاوز حدود اللحظة الفردية.
صورها الشعرية جسور بين الذات والعالم، وبين الماضي والحاضر، وبين التراث والحداثة، كما في «ذاكرة الطين»: «وأنا التي استسقت وأنت سحابها» حيث يتحول الحنين إلى صورة مطرية مشبعة بالرمز.
قصائدها تحاكي الروح بقدر ما تخاطب الفكر، وتستدعي القارئ إلى المشاركة الوجدانية والفكرية معاً.
هذا التمازج بين العاطفة والرمز يمنح نصوصها بعداً وجودياً يجعلها أبعد من مجرد كلمات موزونة، لتصبح مرآة لهويتها وامتداداً لوعيها الإنساني العميق.
1. الحس الأنثوي والبوح الوجداني
الحس الأنثوي في شعر تهاني الصبيح ليس مجرد انعكاس لعاطفة رقيقة، بل هو طاقة إبداعية قادرة على تحويل التجربة الشخصية إلى لغة إنسانية شاملة. الأمومة عندها تتحول إلى رمز للرعاية والوفاء والخلود، والحنين يصبح نافذة على الذاكرة الجماعية. فهي لا تكتب المرأة بوصفها كائناً هشاً، بل كياناً قادراً على منح الحياة واللغة معنى جديداً. هذا البوح الوجداني العميق يفتح النصوص على مساحات أوسع من العاطفة الفردية، ليجعلها تجربة مشتركة بين الشاعرة والقارئ، وبين الأنا والآخر. ومن هنا، تتشكل هوية شعرية تنبني على التوازن بين الرقة الأنثوية والقوة الوجدانية.
2. الرمزية والبعد الكوني
النصوص عند تهاني الصبيح تنسج شبكة من الرموز التي تحرر القصيدة من حدودها الزمنية والمكانية. فالنهر عندها ليس ماءً جارياً فحسب، بل رمز للحب والارتواء والخلود. والغيوم ليست مجرد ظاهرة طبيعية، بل استعارة عن الحنين المعلّق بين السماء والأرض. أما المرايا، فتصبح انعكاساً لرحلة الغربة الداخلية التي يعيشها الإنسان في بحثه عن ذاته. هذه الرمزية تفتح النصوص على بعد كوني يجعلها قابلة للتأويل المتعدد، وتمنح القارئ حرية الدخول إلى عوالمها من زوايا مختلفة. وبذلك يتحول شعرها إلى فضاء مفتوح للقراءة والتفسير، لا يكتفي بوصف الواقع بل يخلقه من جديد.
3. التناص مع النصوص المقدسة
من السمات الأكثر حضوراً في تجربة تهاني الصبيح الشعرية توظيفها الواعي والعميق للنصوص المقدسة، سواء القرآن الكريم أو الحديث الشريف أو الرموز التاريخية ذات البعد الديني. هذا التناص ليس زخرفاً سطحياً، بل هو بنية دلالية متجذرة في نصوصها، تجعل شعرها مشبعاً بالقداسة الروحية من جهة، وبالمعاصرة الفنية من جهة أخرى.
حين تستدعي شخصية يوسف، فهي لا تستحضر القصة القرآنية في بعدها التاريخي فحسب، بل تستلهم رمز الحلم والوفاء والجمال والصبر على البلاء. قولها: «يا ريح يوسف من يجاري لهفتي» يفتح النص على طبقات متعددة من المعنى؛ فالقارئ يتذكر قصة يوسف وامتحانه الطويل، لكنه في الوقت ذاته يتماهى مع اللهفة الإنسانية العاطفية التي تسكن النص، فيغدو يوسف رمزاً للشوق الكوني وللحلم الذي يتجاوز حدود الفرد إلى الجماعة.
كما أن استدعاءها لهاجر في ديوانها «وجه هاجر» يمثل عمقاً رمزياً مضاعفاً. هاجر ليست مجرد شخصية تاريخية، بل أيقونة للغربة، والبحث عن الارتواء في أرض الجدب، ورمز لصوت المرأة في مواجهة الصحراء والغياب. حين تجعل هاجر مرآة للغربة، فإنها في الحقيقة تستدعي رحلة وجودية يعيشها كل إنسان في مواجهة الوحدة والبحث عن الأمان. تقول في إحدى قصائدها:
«كانت بيَ الصحراء حين سمعتها
تبكي على الطفل الذي ملأ العرا
في غير ذي زرعٍ يزمزم حيرتي
ماءٌ بقدرِ السعي فجّره الثرى»
هذا المقطع يجمع بين الرمز الديني «زمزم» والتجربة الإنسانية، ليحوّل حكاية هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام إلى استعارة عن السعي الإنساني الدائم نحو الخلاص والارتواء.
أما زمزم، فيحضر في نصوصها بوصفه رمزاً لليقين والارتواء الروحي. زمزم هنا ليس ماءً فحسب، بل هو منبع الطمأنينة والإيمان وسط قلق الحياة، ومجاز للثبات في مواجهة التيه. بهذا التحويل، تنتقل الرموز من سياقها الديني إلى سياق شعري يتسع للمعنى ويحتوي القارئ المعاصر.
التناص عند تهاني الصبيح لا يقف عند حدود النقل أو الاستدعاء المباشر، بل يقوم على إعادة إنتاج الرمز وإدخاله في شبكة من الصور الشعرية الجديدة. فهي توظف هذه الرموز لتؤكد أن المقدس ليس مجرد ماضٍ ساكن، بل طاقة دائمة تتجدد في النص الشعري وتستجيب لأسئلة العصر. وبهذا يتحول شعرها إلى حوار حيّ بين الماضي والحاضر، بين ما هو خالد في الذاكرة الروحية، وما هو متجدد في التجربة الإنسانية اليومية.
ولعل أبرز ما يميز هذا التناص أنه يحقق في نصوصها أكثر من وظيفة:
• وظيفة جمالية: إذ يمنح النص عمقاً وثراءً في الصورة والمعنى.
• وظيفة رمزية: إذ يحول الرموز الدينية إلى إشارات إنسانية تتجاوز الانتماء الفردي.
• وظيفة وجودية: إذ يفتح النصوص على أسئلة الحنين واليقين والغربة، ويجعلها مرايا للتجربة الإنسانية في أبعادها الكبرى.
ولنا أن نلاحظ أن هذه التقنية تعكس ثقافة الشاعرة القرآنية والروحية، وتكشف في الوقت ذاته عن وعيها بدور الشعر كجسر يصل المقدس باليومي، والتراث بالحداثة، والذاكرة بالمعاصرة.
بهذا المعنى، يصبح التناص مع النصوص المقدسة عند تهاني الصبيح ليس مجرد سمة أسلوبية، بل هو ركيزة لهويتها الشعرية، ومنبع أصيل يمدّ نصوصها بطاقة روحانية وجمالية تجعلها قريبة من القارئ المؤمن، وفي الوقت نفسه مفتوحة على القارئ الإنساني الباحث عن المعنى في أي مكان وزمان.
واحدة من أبرز سمات شعر تهاني الصبيح توظيفها العميق للتناص مع القرآن الكريم والحديث الشريف والرموز التاريخية والدينية. فهي لا تستحضر النصوص المقدسة كاقتباس حرفي أو محاكاة شكلية، بل تعيد إنتاجها في سياق معاصر يمنحها حياة جديدة ويجعلها جزءًا من النسيج الشعري.
فيوسف عندها يتحول من نبي الحلم والوفاء إلى رمز إنساني خالد للشوق والحنين الذي يتجاوز حدود الزمن والمكان. في قصيدتها «ريح يوسف» تقول:
يا ريح يوسف من يجاري لهفتي
لو للحنين مسافةٌ ونطاقُ؟
هذا البيت لا يكرر القصة القرآنية، بل يستحضر رمز يوسف كمعادل للشوق الروحي الذي يسكن كل إنسان.
أما هاجر، فهي عندها ليست مجرد شخصية تاريخية مرتبطة بسياق السيرة، بل أيقونة للغربة والصبر والبحث عن المعنى. في ديوانها «وجه هاجر» نجد هذا المزج العميق بين الرمزية الدينية والتجربة الإنسانية:
الغربة هاجر تسكن المرايا
والماء زمزم يسيل من عيون الروح
هنا يتحول زمزم إلى ماء رمزي يروي ظمأ الروح، وتتحول الغربة إلى مرآة للذات، بما يجعل النص ينفتح على تأويلات وجودية معاصرة.
كما أن استدعاءها لزمزم، رمز اليقين والارتواء في المخيال الإسلامي، يجعل النصوص تستحضر معنى الثبات الروحي وسط صحراء الاغتراب. فزمزم في قصائدها ليس بئرًا ماديًا، بل رمزًا للينبوع الداخلي الذي يهب الحياة للنفس التائهة.
وليس بعيدًا عن ذلك، تستحضر الصبيح رموزًا قرآنية أخرى مثل المطر والسحاب والريح، فتمنحها أبعادًا روحية عميقة. ففي «ذاكرة الطين» تقول:
وأنا التي استسقت وأنت سحابها
تهمي ودمعي في لقاكَ غزيرُ
فهنا يصبح السحاب رمزًا للرحمة، واللقاء مطرًا يغسل جراح الغياب، وهو تناص غير مباشر مع صورة المطر في القرآن كآية للخصب والإحياء.
بهذا التوظيف، يتحول النص الشعري عندها إلى مساحة حوار بين الماضي والحاضر، بين المقدس واليومي. النصوص المقدسة لا تبقى محصورة في إطارها التاريخي، بل تدخل في نسيج التجربة الفردية والجماعية، فتمنح شعرها بعدًا روحيًا يتجاوز الجمالية إلى الدلالية.
إن قوة هذا التناص تكمن في أنه لا يفرض على القارئ قراءة دينية أو عقائدية، بل يفتح أمامه فضاءً متعدد التأويلات، يجمع بين الموروث الروحي العريق والحساسية الجمالية الحديثة. وبهذا تبرهن تهاني الصبيح على أن النصوص المقدسة ليست مادة تراثية جامدة، بل طاقة رمزية متجددة تعيش في الوجدان الجمعي وتُعيد صياغة الحاضر.
في الشعر العربي الحديث والمعاصر، كان التناص مع النصوص المقدسة - خصوصاً القرآن الكريم - حاضراً عند كثير من الشعراء والشاعرات، لكن كل منهم وظفه بطريقة مختلفة بحسب تجربته ورؤيته.
•نازك الملائكة: وظفت النص القرآني بشكل رمزي أكثر منه روحي، فكانت تستعير من ألفاظه وصوره لتصوغ خطاباً شعرياً وجودياً أو احتجاجياً، لكن النص عندها ظل أقرب إلى الجانب اللغوي والفني منه إلى الإيحاء الروحي المباشر.
• فدوى طوقان: استحضرت الرموز الدينية في سياق المقاومة والوطن، فجعلت من قصة يوسف أو من آيات الصبر والعذاب رموزاً لمعاناة الشعب الفلسطيني وصموده. عندها يتحول التناص إلى أداة سياسية ووسيلة لتأكيد الهوية الوطنية.
• سعاد الصباح: استخدمت التناص بوصفه رافداً عاطفياً أو جمالية زخرفية، تستحضر به الإيقاع القرآني لتعزيز موسيقى النص، لكنها لم تتعمق كثيراً في إعادة إنتاج الرمز أو تحويله إلى رؤية فلسفية وجودية.
أما تهاني الصبيح، فتوظيفها للتناص يختلف في ثلاث نقاط أساسية:
1. الروحانية الوجودية: لا تكتفي باستدعاء الرموز المقدسة لغايات جمالية أو سياسية، بل تجعلها أفقاً للتأمل في قضايا الحب والغربة واليقين والحنين. يوسف عندها ليس مجرد رمز للصبر أو الجمال، بل استعارة للشوق الإنساني الكوني. هاجر ليست مجرد أم أسطورية، بل رمز لرحلة الاغتراب التي يعيشها كل إنسان.
2. التأنيث العميق للرمز: بخلاف كثير من الشاعرات اللواتي استعملن الرمز الذكوري «يوسف، موسى، عيسى»، تعطي تهاني مركزية لرمز هاجر بوصفها أنثى تواجه الصحراء وحدها. بهذا، تستعيد صوت المرأة في النص المقدس وتعيد إنتاجه في سياق شعري حديث يمنح الأنثى دور البطولة.
3. الجمع بين القداسة واليومي: في نصوصها، يتحول المقدس إلى لغة معاصرة تلمس القارئ في حياته اليومية. زمزم عندها ليس فقط ماءً مباركاً، بل رمزاً لليقين في مواجهة القلق اليومي، وللارتواء وسط صحراء الروح. بهذا يتحول النص إلى حوار حيّ بين القارئ وذاكرته الدينية من جهة، وبين قضاياه المعاصرة من جهة أخرى.
إذن، فرادة تهاني الصبيح تكمن في أنها تمزج بين قداسة الرمز وكونيته الوجودية، فتجعل التناص المقدس عندها ليس مجرد استدعاء للذاكرة، بل طاقة دلالية مفتوحة تتجدد في كل قراءة
4. المزج بين التراث والحداثة
شعر تهاني الصبيح متجذر في التراث الأحسائي والعربي، لكنه لا يبقى أسيراً له أو حبيساً في قوالبه التقليدية. النخيل، الصحراء، القوافل، الماء، والمكان الحساوي بتفاصيله اليومية، كلها مفردات تتكرر في نصوصها، لكنها لا تظهر بوصفها صوراً جامدة أو مقتبسة من الماضي، بل تُعاد صياغتها بلغة حديثة وصور مبتكرة تجعلها تنبض بالحياة من جديد. فهي تدرك أن الشعر لا يمكن أن يقطع صلته بالجذور، إذ الجذور هي ما يمنحه ثباتاً وعمقاً، لكنه في الوقت ذاته مطالب بأن يتجدد ليواكب تحولات العصر وأسئلته الجديدة.
هذا المزج يظهر في قدرتها على استحضار رموز تراثية - كهاجر وزمزم ويوسف - ومنحها معنى يتجاوز سياقها الأصلي، لتصبح استعارات عن الغربة واليقين والحب. كما أنها توظف الموروث الشعبي الأحسائي: النخلة رمزاً للخصب والعطاء، القوافل رمزاً للرحيل والبحث، الصحراء رمزاً للاتساع والاختبار. غير أن هذه الصور لا تأتي على هيئة ترديد ماضوي، بل بصياغة عصرية تستوعب الحداثة وتعيد تفسيرها في ضوء الراهن.
ولعلنا نلمس ذلك بوضوح في ديوانها «وجه هاجر» حين تستحضر صورة الأم هاجر رمزاً للصبر والاغتراب لتقول:
الغربة هاجر تسكن المرايا
والماء زمزم يسيل من عيون الروح
وفي قصيدتها «ريح يوسف» تستدعي رمز يوسف لتجعله استعارة عن الحنين الكوني:
يا ريح يوسف من يجاري لهفتي
لو للحنين مسافةٌ ونطاقُ؟
أما في «ذاكرة الطين» فتعود إلى صورة المطر التي ارتبطت بالخصب في المخيال العربي القديم، لكنها تعيد صياغتها بصورة وجدانية حديثة:
وأنا التي استسقت وأنت سحابها
تهمي ودمعي في لقاكَ غزيرُ
بهذا الشكل، يتشكل نصها كجسر بين الماضي والحاضر، يجمع بين الحنين إلى الأمس والتطلع إلى الغد. إن استدعاءها للموروث يمنح شعرها أصالة، بينما قدرتها على إعادة صياغته تمنحه فرادة معاصرة. وبذلك تحقق نصوصها معادلة دقيقة: الوفاء للذاكرة الثقافية من جهة، والانفتاح على آفاق التجديد من جهة أخرى. هذه المعادلة هي ما يجعل شعرها قادراً على مخاطبة القارئ العربي المعاصر دون أن يفقد جذوره، وقادراً أيضاً على مخاطبة الأجيال المقبلة باعتباره نصاً يعيش في الزمن لا خارجه.
قصائد تهاني الصبيح ليست مجرد بوح عاطفي يتكئ على الانفعال اللحظي، بل هي مشروع تأملي مفتوح على الأسئلة الوجودية الكبرى. في نصوصها يلتقي الشعر بالفلسفة ليشكلا معاً رؤية شاملة للذات والكون والحياة. هي شاعرة لا تكتفي بالتصوير أو التعبير، بل تحاول أن تجعل من القصيدة أداة معرفة ووسيلة لفهم معنى الوجود.
حين تكتب عن الحرية، فإنها لا تنظر إليها بوصفها مطلباً اجتماعياً فقط، بل كحالة وجودية لازمة لولادة الشعر. الحرية عندها هي الشرط الأول لوعي الذات بذاتها، وهي الطاقة التي تتيح للقصيدة أن تحلّق بعيداً عن القيود. لذلك تصرّح: «الشاعر لا يولد إلا حراً»، لتجعل من فعل الكتابة ذاتها شكلاً من أشكال الانعتاق.
أما الحنين، فيتحول في قصائدها من مجرد ذكرى عاطفية إلى سؤال فلسفي حول علاقة الإنسان بجذوره وذاكرته. الغربة عندها ليست غياب مكان أو فقد أحبة، بل هي حالة أنطولوجية يعيشها الإنسان في مواجهة الزمن والتيه. لذلك نجدها تستدعي رموزاً مثل هاجر أو زمزم لتجعل من الحنين بحثاً عن ارتواء الوجود، وعن يقين يبدّد العطش الروحي.
وفي حديثها عن اليقين، نجدها لا تطرحه كإيمان جامد أو عقيدة نهائية، بل كمدار للتجلي الروحي. اليقين عندها ليس إغلاقاً للأسئلة، بل انفتاحاً عليها من زاوية أعمق، حيث يتحول النص الشعري إلى مسار للتسامي والارتقاء. عندما تقول: «وبلغتُ من فعل اليقين مداركاً»، فهي تكشف عن لحظة تصالح داخلي تجعل الشعر معبراً نحو أفق أرحب من الطمأنينة.
هذا البعد الفلسفي يجعل نصوصها أشبه بـ مرايا للوجود، يقرأ فيها القارئ أسئلته الخاصة. فهي لا تكتب عن ذاتها وحدها، بل تضعنا جميعاً أمام أسئلة: ما معنى أن نحب؟ ما معنى أن نغترب؟ ما معنى أن نبحث عن يقين وسط الفوضى؟ هنا تتجاوز حدود التجربة الفردية لتصبح صوتاً إنسانياً عاماً.
النزعة الوجودية في شعرها تتجلى كذلك في صورها الشعرية؛ فهي لا ترى في المطر مجرد ماء، بل رمزاً للتجدد والتطهير. ولا ترى في النهر مجرد مجرى مائي، بل استعارة للحب الذي يغمر ويحيي. حتى الشمس والقمر والغيوم تتحول إلى رموز فلسفية تعبّر عن الصراع بين النور والظلام، بين الظهور والغياب، بين الحضور والعدم.
بهذا المعنى، فإن شعرها ليس ترفاً لغوياً أو زخرفة بلاغية، بل موقف من الحياة، وإرادة لفهم الوجود، وسعي لإضفاء معنى على التجربة الإنسانية. إنها تكتب بوعي أن الشعر يمكن أن يكون فلسفة أخرى، لكن بلغة الوجدان والصور، لا بلغة المنطق والمفاهيم.
إن التقاء الشعرية بالفلسفة في نصوصها يجعل القارئ يعيش التجربة على مستويين: متعة جمالية في الصور واللغة، وتأمل عقلي في الدلالات والأسئلة. ومن هنا يتضح أن تهاني الصبيح قد نجحت في صياغة شعر فلسفي وجداني، يُصالح بين الحس المرهف والعقل المتأمل، ويمنح نصوصها قدرة على الاستمرار في الذاكرة، لأنها لا تخاطب العاطفة وحدها، بل تخاطب الفكر والروح معاً.
مثال تطبيقي: قصيدة ”ريح يوسف“
في قصيدتها ريح يوسف تقول:
يا ريح يوسف من يجاري لهفتي
لو للحنين مسافةٌ ونطاقُ؟
هنا تتحول شخصية يوسف القرآنية إلى استعارة وجودية عن الحنين الإنساني الكوني. يوسف لم يعد مجرد رمز قرآني للجمال أو الوفاء، بل صار رمزاً للبحث عن الطمأنينة وسط الغياب والتيه. الريح التي تحمل أثر يوسف ليست ريحاً تاريخية، بل ريح الروح التي تبحث عن خلاصها في مواجهة قلق الزمن.
ثم تضيف:
كالغيمة الحبلى يكدّسني الهوى
وعلى ذبول الوالهين أُراقُ
هذه الصورة تجعل من العاطفة طاقة كونية: الغيمة التي تحمل المطر هي رمز للشاعر ذاته، المليء بالوجد، القادر على الانسكاب فوق أرض العاشقين الذابلة. هنا يتحول الحب إلى خلاص جماعي، لا مجرد تجربة شخصية، وكأنها تقول إن الشعر نفسه هو مطر يروي عطش الأرواح.
وبهذا المثال، يتجلى البعد الفلسفي الوجودي في نصوصها؛ فهي لا تكتب عن ذاتها وحسب، بل تجعل من النص مجالاً لتجربة إنسانية عامة، تُسائل الوجود، وتبحث عن اليقين، وتحوّل الحب والحنين إلى أدوات لفهم معنى الحياة.
مثال تطبيقي: قصيدة ذاكرة الطين
تقول تهاني الصبيح:
وأنا التي استسقت وأنت سحابها
تهمي ودمعي في لقاكَ غزيرُ
في هذا البيت، يتحول الحنين إلى صورة مطرية تتجاوز حدود البوح العاطفي لتصبح رمزاً فلسفياً عن حاجة الإنسان للارتواء الروحي. الاستسقاء هنا ليس مجرد طلب للماء، بل بحث عن معنى، عن يقين يروي عطش الكائن في صحراء وجودية. السحاب رمز للآخر/المطلق، بينما الأنا الشاعرة هي الأرض العطشى الباحثة عن الخصب.
ثم تقول:
كانت بيَ الصحراء حين سمعتها
تبكي على الطفل الذي ملأ العرا
في غير ذي زرعٍ يزمزمُ حيرتي
ماءٌ بقدرِ السعي فجّرهُ الثرى
هذا المقطع من أعمق ما كتبته تهاني الصبيح، إذ يجمع بين الرمز الديني «زمزم وهاجر» والبعد الوجودي. الصحراء هنا ليست مجرد مكان جغرافي، بل حالة أنطولوجية تعبّر عن الخواء والغياب والتيه. بكاء الصحراء يتحول إلى استعارة عن معاناة الإنسان في مواجهة العدم، بينما زمزم يرمز إلى اليقين الذي لا يُمنح اعتباطاً، بل يُفجَّر بقدر السعي.
إنها رؤية فلسفية تقول لنا: الحياة لا تعطي ارتواءها إلا لمن يسعى، والمعنى لا يُكتشف إلا لمن يغامر في دروب القلق والتيه. بهذا، تتحول قصة هاجر وإسماعيل عليهما السلام من حدث ديني إلى استعارة عن المصير الإنساني كله: رحلة عطش، ثم سعي، ثم يقين يفجر ماء الحياة.
قصائد تهاني الصبيح ليست مجرد بوح عاطفي أو سرد وجداني، بل هي أيضًا رحلة بحث عن أسئلة وجودية كبرى: ما معنى الحرية؟ ما جدوى الحنين؟ كيف يتحول الحب إلى خلاص؟ إن نصوصها تتحول إلى مرايا للتأمل الفلسفي، حيث يوضع القارئ أمام قلقه الوجودي الخاص، فيجد في الكلمات صدىً لأسئلته التي قد يخشى البوح بها.
في شعرها، لا يظهر الحنين كحالة نفسية عابرة، بل كوجود دائم يعيد تشكيل العلاقة بين الذات والعالم. تقول في «ريح يوسف»:
يا ريح يوسف من يجاري لهفتي
لو للحنين مسافةٌ ونطاقُ؟
فالحنين هنا ليس مجرد توق إلى شخص أو مكان، بل حالة وجودية تتجاوز حدود الجغرافيا والزمن، لتصبح تجربة إنسانية شاملة.
أما اليقين عندها، فيأتي بوصفه مدارًا للتجلي الروحي، لا مجرد إيمان تقليدي. في إحدى نصوصها تقول:
وبلغتُ من فعل اليقين مداركاً
حتى التباسي رغم ريبته… درى!
هنا يتحول اليقين إلى فعل، وإلى مدار يفتح أمام الذات أفقًا للتجاوز، حيث يصبح الشك نفسه طريقًا إلى المعرفة.
الغربة أيضًا تأخذ بعدًا فلسفيًا في ديوانها «وجه هاجر». فهاجر ليست مجرد شخصية تاريخية، بل استعارة عن الاغتراب الإنساني والبحث الدائم عن المعنى:
الغربة هاجر تسكن المرايا
والماء زمزم يسيل من عيون الروح
بهذا التوظيف تتحول الغربة من تجربة شخصية إلى سؤال إنساني مفتوح عن الهوية والانتماء والوجود.
الشعر عند تهاني الصبيح يصبح محاولة لفهم العالم، والتصالح مع أزماته، وفتح أفق للمعنى وسط الفوضى. فهو ليس ترفًا جماليًا، بل ممارسة فلسفية تسعى إلى ملامسة جوهر الإنسان. وهذا ما يجعل نصوصها تتجاوز الحدود الجمالية إلى فضاء الأسئلة الكبرى، حيث تلتقي الشعرية بالفلسفة في نص واحد.
إن هذا البعد الوجودي يجعل شعرها قريبًا من المتلقي المعاصر الذي يبحث عن معنى في زمن التحولات، ويمنح نصوصها قدرة على البقاء لأنها تطرح أسئلة أبدية لا تنتهي، أسئلة عن الحرية، الحب، الغربة، واليقين.
خلاصة الأمثلة:
في ريح يوسف، يتحول الشوق الفردي إلى استعارة عن الحنين الكوني.
وفي ذاكرة الطين، تتحول الغربة الصحراوية إلى سؤال عن الوجود، ويصبح زمزم رمزاً فلسفياً عن معنى السعي والإيمان.
بهذه الأمثلة، يتضح أن البعد الوجودي والفلسفي عند تهاني الصبيح ليس مجرد فكرة أو نزعة، بل ممارسة شعرية متكررة في نصوصها، تجعل قصائدها مرايا للتجربة الإنسانية العميقة، حيث تلتقي اللغة الشعرية بالأسئلة الكبرى
6. البنية الجمالية واللغة
لغة تهاني الصبيح مشغولة بدقة ووعي، فهي لا تترك المفردة عابرة، بل تصوغها كما ينحت الفنان حجراً أو كما يختار الخطاط شكل الحرف. المفردة عندها ليست وسيلة محايدة، بل كائن حيّ يحمل ظلالاً ومعاني متعددة. لذلك نلمس في نصوصها حرصاً على اختيار الكلمة التي تؤدي الدور الجمالي والدلالي معاً، فلا زيادة ولا ترهل، بل اقتصاد لغوي يجعل النص متماسكاً ومفتوحاً للتأويل في الوقت ذاته.
في بناء صورها الشعرية، تعتمد على التشبيه والاستعارة والطباق، لكنها توظفها بوعي حتى لا تتحول إلى تزيين زائد يثقل النص. التشبيه عندها يفتح أفق الصورة، والاستعارة تجعل المعنى يتجاوز حدوده الظاهرة، والطباق يمنح النص حيوية الإيقاع وتوتر المعنى. فعندما تقول: «وترٌ أنا فلتعزفي الوترا»، فهي لا تكتفي بالبوح الشخصي، بل تجعل من نفسها أداة موسيقية، أيقونة للحن يتجاوزها إلى القارئ، فتتحول الذات إلى رمز للوجود الموسيقي نفسه.
جمالياتها لا تأتي من الزينة اللفظية، بل من الصفاء التعبيري؛ فهي قادرة على أن تمنح الكلمة أكثر من دلالة، بحيث يقرأها القارئ في أفق عاطفي، وآخر فلسفي، وثالث رمزي. من هنا، تصبح النصوص متعددة الطبقات، قابلة للتأويل في ضوء خبرة القارئ وثقافته.
البنية الشعرية في نصوصها تتسم بالانسجام بين الإيقاع الداخلي والبعد الدلالي. فهي لا تعتمد على الإيقاع الخارجي وحده - الوزن والقافية - بل تصنع موسيقى داخلية من خلال التكرار، والتنغيم، وتوزيع الجمل الشعرية. هذه الموسيقى الداخلية تمنح النصوص انسياباً سلساً يلامس الأذن والوجدان معاً، وفي الوقت نفسه تعمّق المعنى.
ومن هنا، يمكن القول إن شعرها يجمع بين البساطة والعمق: البساطة في انسياب اللغة وسهولة التلقي، والعمق في تعدد الدلالات والرموز التي تحملها الكلمة. وهذا التوازن هو سرّ الدهشة في نصوصها؛ إذ إن القارئ يجد نفسه أمام لغة مألوفة من حيث البنية، لكنها تفتح معاني جديدة غير متوقعة.
بلاغتها تتجلى أيضاً في قدرتها على تحقيق الانسجام البنائي؛ فهي لا تضع الصورة الشعرية منفصلة عن سياقها، بل تجعلها جزءاً عضوياً من بنية النص. فالصورة ليست زينة تُضاف، بل حلقة في سلسلة الدلالات التي يبنيها النص منذ بدايته حتى نهايته. على سبيل المثال، في قصيدتها ذاكرة الطين، نجد أن صورة الصحراء، والدمع، والماء، كلها ليست عناصر منفصلة، بل نسيج متكامل يعكس رحلة الاغتراب والسعي نحو اليقين.
بهذا الأسلوب، تصبح البنية الجمالية في شعرها منسجمة ومتماسكة، تجعل النصوص قادرة على إثارة الدهشة حتى بعد إعادة قراءتها مرات عديدة، لأن كل قراءة تكشف عن طبقة جديدة من المعنى أو البنية.
أمثلة تطبيقية على البنية الجمالية:
• في قصيدة ريح يوسف، تقول:
يا ريح يوسف من يجاري لهفتي
لو للحنين مسافة ونطاقُ؟
نجد هنا أن الاقتصاد اللغوي واضح، فبكلمتين أساسيتين: ”ريح“ و”يوسف“، تستحضر الشاعرة رمزاً قرآنياً، ومشهداً وجدانياً، وصورة شعرية مكثفة تحمل أبعاداً نفسية وروحية وفلسفية معاً.
• وفي وجه هاجر، تقول:
كانت بيَ الصحراء حين سمعتها
تبكي على الطفل الذي ملأ العرا
هنا نجد أن الصورة ليست مجرد وصف للمكان «الصحراء» بل جزء من نسيج رمزي ودلالي أوسع: الصحراء = الغربة، البكاء = الحنين، الطفل = الامتداد. وبذلك تتداخل المفردات في بنية واحدة متماسكة تحمل أبعاداً جمالية وفلسفية.
• وفي ذاكرة الطين:
وأنا التي استسقت وأنت سحابها
تهمي ودمعي في لقاكَ غزيرُ
الصورة هنا تتجلى في انسجام تام بين الإيقاع الداخلي «الترابط الصوتي بين ”استسقت/سحابها/تهمي/غزير“»، وبين الدلالة الوجدانية «البحث عن الارتواء الروحي».
لغة تهاني الصبيح مشغولة بدقة ووعي، فهي لا تترك المفردة عابرة، بل تنحتها كما ينحت الفنان الحجر ليصوغ منها لوحة متكاملة. تعتمد في بناء صورها على التشبيه والاستعارة والطباق والجناس، لكنها لا تقع في فخ الإفراط البلاغي الذي يثقل النص. جمالياتها تقوم على الاقتصاد اللغوي والصفاء التعبيري، حيث تحمل الكلمة أكثر من معنى وتفتح أفقًا للتأويل.
في قصيدتها «وتر» مثلًا، نرى الاقتصاد اللغوي في أبهى صوره:
وترٌ أنا فلتعزفي الوترا
ولتسكُني الإلهام لو حضرا
بيتان قصيران يختزلان هوية الشاعرة كاملة، ويجعلان من الكلمة مفتاحًا للدخول إلى عالمها الشعري.
كذلك نلمس في نصوصها قدرة على الجمع بين الإيقاع الداخلي والبعد الدلالي، بحيث لا يكون الوزن والقافية مجرد قوالب شكلية، بل وسيلة لإبراز المعنى وتعميقه. في «ذاكرة الطين» تقول:
وأنا التي استسقت وأنت سحابها
تهمي ودمعي في لقاكَ غزيرُ
هنا يتناغم الإيقاع مع الصورة، حيث يتدفق النص كالمطر، ليجعل القارئ يعيش تجربة الحنين والانهمار معًا.
أما في قصيدة «ريح يوسف»، فإن اللغة تنفتح على بعد رمزي عميق، حيث تتحول الريح إلى استعارة للحنين الكوني:
يا ريح يوسف من يجاري لهفتي
لو للحنين مسافةٌ ونطاقُ؟
هذا البيت يجمع بين البساطة التعبيرية والعمق الدلالي، ويكشف عن براعتها في صياغة نص يلامس الروح دون أن يفقد رشاقته الشعرية.
بلاغة تهاني الصبيح لا تقوم فقط على الصور الكبرى، بل أيضًا على التفاصيل الدقيقة. فهي قادرة على جعل مفردة مثل المطر أو الغربة أو الوتر مركزًا لبنية نص كامل، بحيث يتولد من الكلمة الواحدة شبكة من الصور والمعاني.
إن نصوصها تتسم بقدرة نادرة على الجمع بين البساطة والعمق، وبين السلاسة والدهشة. القارئ يدخل النص بسهولة، لكنه كلما أمعن فيه اكتشف طبقات جديدة من الدلالة. وهذا ما يجعل لغتها قادرة على أن تكون في آن واحد قريبة من القلب وملهمة للعقل.
بهذا الأسلوب، تتجلى بلاغتها في الجمع بين جمال الإيقاع وقوة المعنى، بين صفاء العبارة وعمق الرمز. وهي بذلك تؤكد أن الشعر ليس زخرفًا لغويًا، بل لغة أخرى للحياة، قادرة على إعادة تشكيل العالم بالكلمة
7. جدلية الذات والآخر
النصوص عند تهاني الصبيح تنطلق من الذات، لكنها لا تبقى حبيسة الأنا الفردية. فهي تبدأ من التجربة الشخصية لتتحول إلى تجربة إنسانية عامة، تجعل القارئ شريكاً في التلقي والتأمل. ذاتها ليست منغلقة، بل هي نافذة تنفتح على الآخر، تلتقط همومه وتشكلها في صور شعرية تجعل النص مرآة مشتركة بين الكاتب والقارئ.
الوطن حاضر في شعرها باعتباره مرآة للانتماء والذاكرة الجماعية، لكنه يظهر من خلال تجربة ذاتية صادقة. المرأة عندها ليست مجرد ذات أنثوية، بل رمز للحرية والصمود في وجه التقاليد والقيود. والإنسان، بكل تناقضاته وأحلامه وآلامه، حاضر باعتباره جوهر التجربة الشعرية. هذه العناصر تجعل من شعرها نصوصًا تعيش في الفضاء الجمعي دون أن تفقد جذورها الذاتية.
في ديوانها «وجه هاجر»، الذي أهدته إلى والدتها، يتجلى هذا البوح الوجداني الصادق، حيث يختلط الحنين بالفقد، والحب بالصبر، ليصبح النص مرثية للذات وللآخر في آن واحد. تقول:
الغربة هاجر تسكن المرايا
والماء زمزم يسيل من عيون الروح
هذا النص يجمع بين رمزية الأم هاجر كأيقونة للغربة، وحنين الابنة إلى والدتها، مما يفتح النص على فضاء وجداني متعدد الأبعاد.
كما نجد في قصيدتها «ذاكرة الطين» بعدًا وجدانيًا عميقًا يجعل من العلاقة العاطفية صورة كونية:
وأنا التي استسقت وأنت سحابها
تهمي ودمعي في لقاكَ غزيرُ
فالمرأة هنا ليست مجرد ذات محبة، بل روح عطشى تجد ارتواءها في الآخر، لتتحول العلاقة الإنسانية إلى استعارة عن الخصب والوجود.
وفي «وتر» يظهر هذا الحس الأنثوي حين تقدم نفسها بوصفها طاقة تنتظر التفعيل:
وترٌ أنا فلتعزفي الوترا
ولتسكُني الإلهام لو حضرا
هنا تنكشف الأنثى كصوت شعري يحمل إمكان الإبداع، لكنه لا يكتمل إلا بالتشارك مع الآخر، مما يجعل النص أكثر انفتاحًا على القارئ.
بهذا البوح الوجداني، لا تعزل تهاني الصبيح تجربتها الأنثوية في إطار ضيق، بل تجعل منها مرآة لرحلة إنسانية عامة. فهي تُصوِّر الحنين والأمومة والحب والاغتراب كطاقة شعرية شاملة، تجعل الأنثى رمزًا للحرية والصمود والخلود، وتؤكد أن الأنوثة في الشعر ليست مجرد حضور جسدي، بل بُعد روحي ووجودي.
هذا التوازن بين الذات والآخر يخلق نصوصًا متجذرة في التجربة الفردية لكنها مفتوحة على الهم الجمعي. القارئ يجد نفسه في صورها وانفعالاتها، ويرى همومه الخاصة منعكسة في كلماتها، فيتحقق الشعر عندها بوصفه نصًا للحوار والتلاقي، لا نصًا للانعزال والانكفاء. وهنا تكمن قوة شعرها: تحويل الأنا إلى فضاء نحن، والبوح الفردي إلى صدى جماعي.
على متن غيمة تتهادى: تهاني الصبيح وأفق المرأة الأحسائية:
هذه القصيدة إحدى نصوص ديوانها الثالث - ما تنَّكر من عرش بلقيس - ألقتها الشاعرة بمناسبة يوم المرأة العالمي.
على متن غيمة تتهادى
غَنَّتْ لَهَا الْأَحْسَاءُ مِلْءَ ظِلَالِهَا
وَتَوَشَّحَتْ كُلُّ النَّخِيلِ بِشَالِهَا
فإذا مَشَتْ، مَشَتْ المَحَابِرُ خَلْفَهَا
واسْتَنْطَقَ التَّارِيخُ خَطْوَ رِمَالِهَا
وَدَنَا لَهَا أُفْقٌ لِتَقْطِفَ نَجْمَةً
بَيْضَاءَ تَجْعَلُهَا عَلَى خَلْخَالِهَا
غَرَسَتْ جُذُورَ الْعِلْمِ بَيْنَ عُرُوقِهَا
فَنَمَتْ غُصُونٌ مِنْ نَدَى صَلْصَالِهَا
وَتَسَرْبَلَتْ بِالشَّمْسِ مِثْلَ عَبَاءَةٍ
جَاءَتْ تَجُرُّ النُّورَ مِنْ أَذْيَالِهَا
وَبَنَتْ بُيوتَ الْعَاكِفِينَ وَظَلَّلَتْ
حَقْلاً مِنَ التَّقْوَى بِغَيْمَةِ مَالِهَا
فَأَتَى الْحَصَادُ بَيَادِراً مِنْ حِكْمَةٍ
وَتَوَزَّعَ الْإِدْرَاكُ بَيْنَ سِلَالِهَا
وَهِيَ الَّتِي اعْتَصَمَتْ بِحَبْلِ اللَّهِ
مَا انْفَلَتَ الرَّجَاءُ مِن انْعِقَادِ حِبَالِهَا
وَهْيَ ابْنَةُ الْأَحْسَاءِ حِينَ تَصَاعَدَتْ
وَتَكَثَّفَتْ مَزْهُوَّةً بِجَمَالِهَا
وَهْيَ ابْنَةُ الْأُدَبَاءِ لَوْ ظَمِأَتْ
مَعَانِيهَا
سَتَنْهَلُ مِنْ مَعِينٍ خَيَالِهَا
فَتَأَمَّلُوهَا وَهْيَ تَعْبُرُ صَرْحَهَا
الْمُمْتَدِّ فَخْراً بِامْتِدَادِ فِعَالِهَا
وَتَأَمَّلُوهَا وَهْيَ تَرْكَبُ صَهْوَةَ
التَّمْكِين
تَفْتَرِشُ الفَضَا بِرِجَالِهَا
مَا خَانَهَا الْإِبْدَاعُ وَهُوَ قَرِينُهَا
مِنْ بَيْن جَنْبَيْهَا جَرَى، وَخِلَالِهَا
مَا أَنْبَتَتْهَا الْأُمْنِيَاتُ وَإِنَّمَا
ثَبَتَ الْيَقِينُ عَلَى ذُرَى أَمَالِهَا
فَإِذَا تَوَافَدَتْ اللُّغَاتُ قَوَافِلاً
حَطَّتْ عَلَى فَمِهَا بُكَلِّ رِحَالَهَا
فَتَأَمَّلُوهَا وَهِيَ تَبْتَكِرُ الْحَضَارَةَ
وَالتَطَوَّرَ فِي خُطَى أَجْيَالِهَا
وتشَدُّهَا رُوحُ السَّمَاءِ فَمَا انْطَفَتْ
منْ قَوْسَتْهَا مِشْعَلاً كَهِلَالِهَا
قصيدة تهاني الصبيح تتحرك من صورة صغيرة بسيطة:
غيمة تتهادى في السماء، إلى فضاء ملحمي واسع يحتفي بالمرأة الأحسائية والمرأة عمومًا في يوم المرأة العالمي.
• الغيمة هنا رمز: فهي خفيفة ورقيقة، لكنها تحمل المطر والحياة، كما تحمل المرأة الرعاية والخصوبة والعطاء.
• كل بيت شعري يتفرع عن هذا المشهد الأول، ليبني سلسلة من الصور المتلاحقة: غيمة، نخيل، محابر، رمال، صلصال، شمس، هلال.
وهذا التراكم الرمزي يجعل القارئ ينتقل من الطبيعة إلى الحضارة، ومن الأرض إلى السماء، كما تنتقل المرأة نفسها من دورها المحلي إلى دورها العالمي.
الأحساء ليست مجرد خلفية جغرافية، بل تربة القصيدة:
• النخيل رمز الخصب والكرامة.
• الرمال رمز الامتداد والذاكرة العريقة.
• الصلصال يذكّرنا بخلق الإنسان، وبالارتباط الأول بين الأرض والوجود.
إذن، المرأة عند تهاني الصبيح ليست معزولة عن بيئتها، بل هي امتداد للأحساء نفسها: تتزيّن بالنخيل، وتخزن في عروقها ماء العيون، وتجعل من ترابها معراجًا إلى السماء.
في قولها: ”غَرَسَتْ جُذُورَ الْعِلْمِ بَيْنَ عُرُوقِهَا“، تظهر المرأة كأرض خصبة تغرس فيها بذور المعرفة.
• المحابر مشت خلفها: صورة بالغة القوة، فالمعرفة لم تعد مجرد أدوات جامدة، بل تحولت إلى تابع يسير خلف المرأة.
• الحصاد بيادر حكمة: وكأن ثمرة الزرع ليست قمحًا، بل حكمة. أي أن دور المرأة لا يقتصر على الأمومة البيولوجية، بل يشمل الأمومة الفكرية والثقافية.
تأتي الأبيات في مقطع ذروة: ”فتأملوها وهي تركب صهوة التمكين“، وهذه استعارة فارسية الطابع «الصهوة والفروسية»، لكنها في القصيدة موجهة للمرأة.
• هنا نجد انقلابًا على الصورة النمطية؛ فالمرأة لا تُقاد بل تقود، لا تُمنح بل تُعطي.
• ”تفتَرش الفضا برجالها“ لا تُظهرها في صراع مع الرجل، بل شريكة له في امتداد الفضاء الحضاري.
•الإبداع قرينها، واليقين سندها، والأمل جناحها، فهي ذات مشروع ورسالة، وليست مجرد ظل.
• ”اعتصمت بحبل الله“ يربط المرأة بالقداسة.
• ”وتشدها روح السماء فما انطفأت“ يمنحها بعدًا نورانيًا، فهي متصلة بالسماء كالهلال، تجدد نوره كل شهر، رمزًا للديمومة والتجدد.
•بهذا، تتحول المرأة من كيان فردي إلى كيان كوني، يجمع بين الأرض «الأحساء» والسماء «الهلال».
القصيدة مليئة بالرموز المركبة:
• الغيمة = العطاء والحماية.
• النخيل = الكرامة والجذور.
• المحابر = المعرفة والكتابة.
• الرمال = التاريخ الممتد.
• الخلخال = الزينة الأنثوية الممزوجة بالقداسة.
• الهلال = التجدد الروحي والنور الدائم.
بهذا تتشكل لوحة فسيفسائية تجعل المرأة نصًا جامعًا لكل رموز الوجود.
النص ليس مجرد شعر للاحتفال بيوم المرأة العالمي، بل هو إعلان عن هوية المرأة السعودية/الأحسائية:
• هي ابنة الأدباء، أي أن جذورها ثقافية لا تُروى إلا بالمعاني.
• هي ابنة المكان، أي أن كيانها مشبع بالأرض والمجتمع.
• هي ابنة الحضارة، فهي من تصوغ المستقبل وتبتكر الحضارة.
قصيدة تهاني الصبيح في يوم المرأة العالمي تُمثل:
• ملحمة أنثوية تربط بين الغيم والخلخال، بين الرمل والمحراب، بين النخلة والسماء.
• المرأة فيها ليست فردًا، بل أيقونة حضارية، تجمع بين العلم والإبداع، بين الروح والجسد، بين الأرض والسماء.
• النص مشبع بالرموز والخيال، مما يجعله أشبه ببيان شعري موجه إلى الأجيال، يؤكد أن المرأة ليست نصف المجتمع فحسب، بل هي المحرّك الأساسي لمسيرة التاريخ والحضارة.
تهاني الصبيح في مرآة رؤية عبدالله الشايب:
كتب المهندس عبدالله الشايب مقالة بعنوان ”نضيد الطلع مع الشاعرة تهاني الصبيح“، وصف فيها شخصيتها بأنها بقدر أفق الشعر وسمفونية الحياة. اعتبرها شاعرة مرتبطة بمرجعية المكان ”الأحساء“، مستحضرة الموروث ومتصاعدة نحو الجغرافيا الأوسع للوطن.
رأى أن شعرها العمودي ينبض برصانة البناء وطول النفس، وأن لغتها غنية بالتناص والاستعارة، وأنها تراجع مفرداتها بدقة لتلبي مقاصدها دون التباس. كما أشار إلى رثائها لوالدتها في ”وجه هاجر“ باعتباره ذروة وجدانية.
وأكد أن تهاني الصبيح أول سيدة منتخبة في مجلس إدارة نادي الأحساء الأدبي، وأنها مثال لتمكين المرأة في ظل رؤية المملكة 2030، وأن تجربتها تستحق دراسة نقدية معمقة.
تهاني الصبيح في قراءة حسين الجفال - حوار المجلة العربية:
”الشاعرة السعودية تهاني الصبيح لا تكتب من فرط هاجسها اللغوي لكنها تحلم بذاتها البعيدة التى تراها بعدسة مكبرة فى عين القصيدة، كأنها قادمة من أرض الخرافات بملامح ملهمة، قصيدتها تتحرك بأبعاد شتى دون - صخب أو فوضى - رغم انهمامها بالسردية في الشعر إلا أن رمزيتها عالية لذلك تخطف الأضواء بإلقائها الواثق وتتداعى بشموخها الواثق وتصدح بأنوثتها المنسابة بوعي حاذق هنا حوارية وليس مجرد حوار في محاولة لسبر أغوارها شاعرة أولاً ومثقفة وعرّابة ومتأمّلة أيضاً.“
إن تجربة تهاني الصبيح ليست مجرد مسيرة شعرية، بل هي شهادة على قدرة المرأة السعودية على كسر القيود وصناعة حضور بارز في المشهد الثقافي. من الأحساء إلى باريس، ومن سوق عكاظ إلى الشارقة، رفعت راية الشعر النسائي عالياً، وأثبتت أن الكلمة الحرة قادرة على تجاوز الحدود وصنع الأثر.
هي صوت يجمع بين الأدب والتعليم، وبين الموروث والحداثة، وبين التجربة الشخصية والرسالة الوطنية. قصائدها ليست مجرد نصوص للقراءة، بل هي شهادات وجودية عن الحرية والحب والانتماء.
تبقى الشاعرة تهاني الصبيح علامة فارقة في المشهد الأدبي السعودي، بما حملته من روح الإصرار والتجديد. هي ابنة الأحساء التي حولت القيود إلى أجنحة، وجعلت من الكلمة نافذة نحو الحرية والجمال. حضورها في المحافل العربية والدولية رسّخ صورة المرأة السعودية المبدعة الواثقة، وجعل من قصائدها ذاكرة جماعية ووجداناً ممتداً.
إنها صوت يجمع بين أصالة التراث ورؤى الحداثة، وبين الحنين واليقين، وبين الذات والوطن. ومع استعدادها لإصدار ديوانها الثالث، تبدو رحلتها الإبداعية في تصاعد مستمر، تحمل معها وعداً لجيل جديد من الشاعرات بأن الحرية والإبداع ممكنان مهما اشتد الحصار.