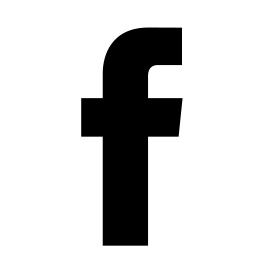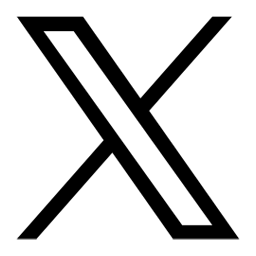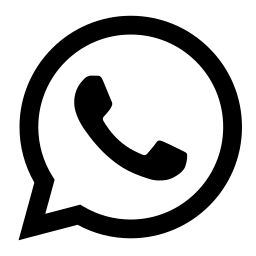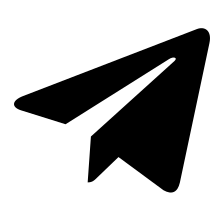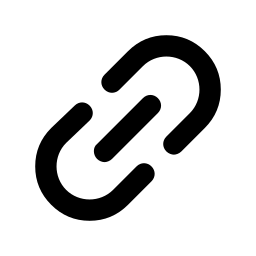صوت لا يُسمع… لكنه يُحكى
لم يكن ورد بحاجة لأن يسمع العالم، بل كان العالم بحاجة لأن يسمعه هو.
في زاوية هادئة من هذا العالم، وُلد ورد، لم تكن ضجة الممرضة، ولا همسات الأم، ولا بكاءه الأول، شيئًا يسمعه.
وُلد على هامش الضوضاء، لا يعرف أن هناك ما يسمى بـ الصوت.
كان يحدق كثيرًا، يبحث في الوجوه عن إشارات، عن تعابير، عن لغة ما تشبهه.
كان العالم كبيرًا، وصامتًا، لكنّه لم يشعر بالنقص، لم يكن يعرف أن هناك عالمًا آخر يسمعه الناس، حتى بدأوا يتحدثون عنه، لا إليه، الولد ما يسمع!
كيف سيتعلّم؟
هذه إعاقة، لازم له مدرسة خاصة.
في عيونهم، كان ناقصًا، وفي قلبه، كان كاملًا فقط.
كان في الرابعة، حين انتُزع من حضن أمه.
صمتُها كان يفهمه، دفؤها كان لغته الأولى، لكنهم قالوا له: لابد أن تندمج، لابد أن تتعلم قراءة الشفاه.
أُرسل إلى مدرسة داخلية بعيدة عن أسرته، بعيدة عن حضنها، عن عينيها.
أُجلس في صفٍ لا يشبهه.
المعلم يتكلم، والطفل لا يسمع، يحرك شفتيه كأنه يمثل مشهدًا بلا صوت، ويطلب منه أن يفهم.
لكن ورد لم يكن ممثلًا، ولم يكن الجمهور أيضًا.
كان تائهًا، لا يفهم لماذا عليه أن يتعلّم بلغة لا تخصّه، لا تُشبهه.
في الليل، كان يضع رأسه على الوسادة، يتمنى أن يحلم بلغة يعرفها، لكنه لم يستسلم.
كان يراقب، يتعلّم بالإشارة، بالصورة، بالحركة، كل شيءٍ من حوله صار لغة، حتى الصمت.
مرت السنوات، وكبر الطفل الصامت، صار شابًا يرفض أن يُسمّى معاقًا.
كان يصر على أن يُنادى باسمه، لا بتصنيفه، أنا لست عاجزًا، فقط أحتاج طريقًا آخر لأصل.
بدأ يسأل الأسئلة التي لا يحب المجتمع سماعها.
لماذا لا يتعلم أهلي لغتي؟
لماذا لا أجد معلمًا يُجيد لغة الإشارة؟
لماذا نُدرَّس كأننا ظلٌّ للطلاب الآخرين؟.
ثم جاء التحول
جامعة ”غالوديت“، الجامعة الوحيدة للصم في العالم،
هناك، كانت اللغة طبيعية،
المعلمون يشرحون بلغة الإشارة، الطلاب يتبادلون الآراء، يضحكون، يحلمون، يناقشون بلغتهم، لا حاجة للقراءة من الشفاه، ولا لسماع صوت لا يُسمع. هناك، لأول مرة، شعر ورد أنه لا يحتاج للشرح.
في غالوديت، تغيّر كل شيء.
بدأ ورد يتقن لغته الأم، لغة الإشارة السعودية، ولأول مرة، أحس أنه قادر على التعبير، لا فقط على الفهم.
بدأ يتعلّم الإنجليزية، ثم لغة الإشارة الأمريكية، ثم الدولية.
تعلم خمس لغات بلغة واحدة بعزم.
لم يكن الطريق سهلًا، كانت سنوات من التلقين، والإقصاء، ومحاولة ”تأهيله“ ليناسب نظامًا لم يُصمَّم له، لكنه رفض أن يكون جزءًا من النظام الذي لا يعترف به.
صار صوتًا لمن لا صوت لهم، يكتب، يحاضر، يُطالب، يعلّم.
يقولها بوضوح: لا أريد أن تتعاطفوا معي، فقط افهموني.
اليوم ورد ليس مجرد شخص ناجح، بل مرآة لكل طفل أصم ينظر إلى نفسه ولا يعرف بعدُ ماذا يمكنه أن يكون.
يقول لأهل كل طفل أصم:
تعلّموا لغته، اجعلوا البيت يتحدث بعيونه، لا بصراخكم علي.
ويقول للمجتمع: نحن لسنا معاقين، أنتم فقط لا تروننا جيدًا.
ويقول للطفل الأصم: أنت لا تحتاج للشفقة، ولا للتصنيف، بل للفرصة فقط.
لم يكن بحاجة لأن يسمع العالم، بل كان العالم بحاجة لأن يسمعه هو.
والآن، من خلف جدران الصمت، تتسلل كلماته، لا بصوته، بل بيده، وبقلبه، وبإنجازه.
لقد أثبت أن الصمت ليس عجزًا، وأن لغة الإشارة ليست بديلًا عن اللغة، بل لغة بذاتها، تحمل من الحياة ما لا تحمله الحروف.
قصة ورد ليست عن فقدان السمع، بل عن اكتشاف الذات، في عالمٍ لا يصغي، لكنه في النهاية بدأ يُنصت.
لم تتوقف رحلة ورد عند حدود التعليم أو الحقوق أو الدفاع عن لغة الإشارة، بل كانت لديه طموحات تتجاوز جدران القاعات الدراسية.
كان يحمل في داخله حلمًا بسيطًا في الشكل، عظيمًا في المعنى، أن يكون له مشروع، أن يُنشئ مكانًا يعكس ذاته، ويستقبل الناس كما هم، بلا أحكام بلا تصنيفات.
وفي أحد الأيام، وُلد الحلم من جديد، لكن هذه المرة على هيئة مطعم.
فتح ورد مطعمه الخاص، لم يكن مجرد مطبخ يقدّم الطعام، بل مساحة للذوق، والتواصل، والكرامة.
كان المكان أشبه برسالة حية تقول للناس: أنا لست فقط ذلك الطفل الأصم الذي تعلم بلغة مختلفة بل أنا رجل أعمال ناجح، أبني مستقبلي بيدي.
لم يكن المطعم مشروعًا ربحيًا فقط، بل كان منصة، وظف فيه من يشبهونه، منح الفرص للصم، دربهم، منحهم الثقة، وجعل من المكان مساحة يتحدث فيها الجميع بلغة مشتركة، لغة الاحترام.
الزبائن يأتون إليه، فيندهشون من روح الخدمة، من جودة الأطباق، ومن فكرة المكان.
هناك، لا تحتاج إلى أن ترفع صوتك بل فقط أن ترفع وعيك.
هكذا أثبت أن النجاح ليس صوتًا عاليًا يُسمع في القاعات، بل هو أثرٌ هادئ ككلماتٍ صامتة، تصنع فارقًا.
وفي مطعمه، كما في حياته،
استطاع أن يصنع من الصمت نكهة لا تنسى.