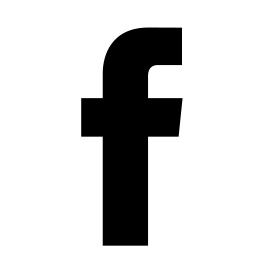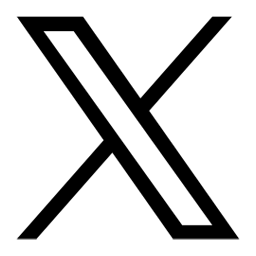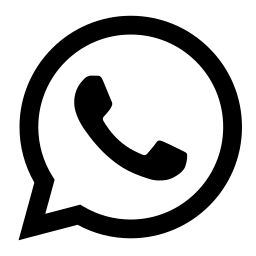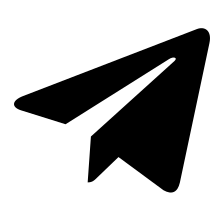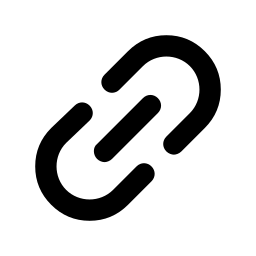سائق الحافلة
سائق الحافلة المدرسية المؤجَّرة هو عنوان حكاية يومية تتكرر مع صباح كل أسرة ترسل أبناءها إلى مدارسهم.
منذ الصباح الباكر ينطلق هؤلاء السائقون، فتارةً يزرعون الخوف في قلوب الطلاب الذين يحملونهم، وتارةً يُربكون حركة السير بسلوكياتهم وتهورهم. إنها مشكلة تؤرق الكثير من السائقين المحترمين، وتربك عامة الشوارع، والسبب في النهاية: محاولة إيصال الطلاب إلى مدارسهم في التوقيت المطلوب، ولو كان ذلك على حساب قوانين المرور وسلامة أبنائنا والمجتمع.
”أولادنا أكبادنا“ عبارة سمعناها منذ الصغر ولا تزال محفورة في قلوب كل أب وأم، فهي تختصر معنى التضحية والمحبة من أجل فلذات الأكباد. لكن المؤسف أن ما نراه اليوم من بعض سائقي هذه الحافلات المؤجَّرة تجاوز حدود التهور حتى أصبح ضربًا من الإجرام، لا رادع فيه ولا متعظ من الحوادث المرورية، ولا من الأرواح التي تُزهق، ولا من القصص المؤلمة التي نسمعها بين الحين والآخر؛ من نسيان طالب نائم داخل الحافلة حتى الموت، أو من الحوادث التي تحوّل رحلة التعليم إلى مأساة.
وما يحدث في واقع الأمر أن كثيرًا من هؤلاء السائقين وهم أنفسهم أصحاب الحافلات قد حوّلوا هذه المهنة إلى مشروع تجاري بحت، يكدّسون فيه الطلاب ويتوسّعون في الخطوط لأجل زيادة العائد المادي، غير مبالين بأن هذا التكديس يجبرهم على مخالفة النظام ويقودهم إلى التهور في الشوارع. وهنا تكمن الخطورة: حين تصبح الحافلة وسيلة ربح قبل أن تكون وسيلة نقل آمنة، وحين يتغلب الجشع على ضمير السائق، فيدفع الطلاب ثمنًا باهظًا من راحتهم وسلامتهم.
ومن يراقب سلوك بعض هؤلاء السائقين في الطرقات يدرك حجم الخطر؛ فالمشهد أحيانًا لا يختلف عن سباقات السرعة، حيث ترى الحافلات تتسابق جنبًا إلى جنب وكأنها في مضمار، غير آبهة بما تحمله من أرواح صغيرة داخلها. وتارةً يُشاهدها المارة وهي تقطع الإشارات المرورية من دون تردد، أو تتجاوز من المنعطفات والتقاطعات بتهور شديد، فتربك السائقين الآخرين وتعرّض الجميع للخطر. وهذه التصرفات ليست مجرد مخالفات عابرة؛ بل صورة يومية متكررة تكشف أن سلامة الطلاب والناس باتت آخر ما يفكر فيه هؤلاء السائقون.
وما يدفعهم لمثل هذا التهور لا يخرج عن أمرين: إما أنهم يحاولون إيصال الطلاب المتكدسين داخل الحافلة في الوقت المطلوب مهما كان الثمن، أو لأن بعضهم يريد أن يُنهي رحلته بسرعة ليجد أصدقاءه بانتظاره على صحن فول وكبدة، فلا يرغب أن يخسر موعد فطوره على حساب التزامه بسلامة أبنائنا.
وإذا كان أثر هذا التهور واضحًا في الشوارع وعلى السائقين الآخرين، فإن الأثر الأكبر يقع على الطلاب أنفسهم داخل الحافلة. فالطالب الذي يبدأ يومه بخوف وارتباك لن يصل إلى المدرسة مرتاح البال ولا حاضر الذهن. وكثير منهم يجلسون على المقاعد وهم متشبثون بها وكأنها طوق نجاة، يراقبون حركات السائق وانعطافاته بسرعة، فيكبر داخلهم الخوف من الطريق بدلًا من حماسهم للتعلم.
وعلى الرغم أن بعض الطلاب لا يُظهرون ما بداخلهم، إلا أن القلق ينعكس عليهم في الصف؛ فتراهم شاردين أو فاقدين للحماسة، وربما يصل الأمر أن يكرهوا الذهاب للمدرسة بسبب تجربة النقل المرعبة كل صباح.
وهنا يأتي دور أولياء الأمور؛ فالمسؤولية لا تقف عند دفع رسوم النقل فقط، وإنما تمتد إلى متابعة حقيقية: من هو السائق؟ وكيف يقود؟ وهل يهتم بسلامة الطلاب عند الصعود والنزول؟ وهذه أمور لا بد أن يلتفت إليها الأب والأم؛ لأن الاطمئنان على الأبناء يبدأ من لحظة خروجهم من البيت، قبل أن يصلوا إلى المدرسة.
وفي النهاية، قد لا يلتفت بعض سائقي الحافلات المدرسية المؤجَّرة لأي توعية أو إرشادات مرورية، وقد لا يقرأون مقالات ولا يسمعون نصائح من هنا أو هناك. وهؤلاء يرون الأمر مجرد عمل يومي ينتهي مع آخر رحلة. لكننا نحن كأولياء أمور لا يجوز أن نترك زمام الأمر كله بأيديهم؛ بل من واجبنا أن نتحقق بأنفسنا من شخصية السائق الذي ائتمنّاه على فلذات أكبادنا: هل هو واعٍ ومسؤول؟
وهل يقدّر حجم الأمانة؟
وهل يملك من العقل والرشد ما يجعله أهلًا لقيادة حافلة تحمل أبناءنا كل صباح؟
إن سلامة الأبناء لا تبدأ من قوانين المرور ولا من الحملات الإعلامية؛ بل تبدأ من قرار الأب والأم: وأن لا يسلِّموا أبناءهم لأي سائق لا يعرفونه جيدًا، أو لا يثقون في سلوكه وعقله. فالسائق قد ينسى نصيحة أو يتجاهل قانونًا، لكن نحن لا نملك ترف النسيان أو التجاهل حين يتعلق الأمر بأغلى ما نملك. ولعل ما يزيد خطورة هذا الملف أنَّه واقع يتكرر كل صباح على مدار العام الدراسي كله. فلنحرص ونراقب… لأن الأمانة لا تُمنح لكل من يطرق الباب، بل لمن يثبت أنه جدير بها.