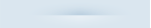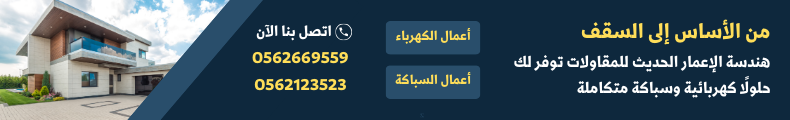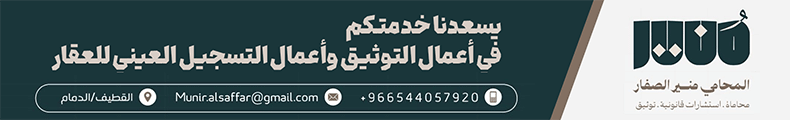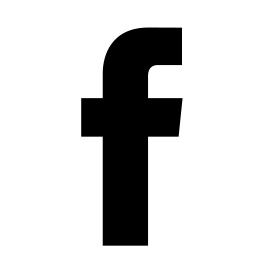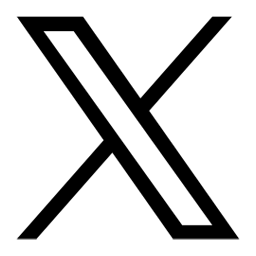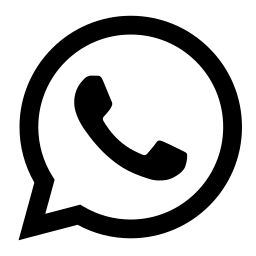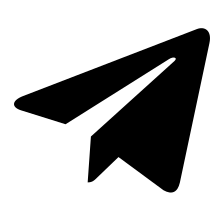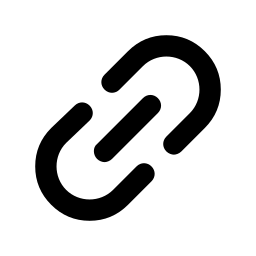آلية التعلم بين منهجية الطالب المتخصص وحرية القارئ والباحث
نعيش اليوم وسط ثورة معرفية متسارعة، تتعدد فيها طرق الوصول إلى العلم وإمكانية التعلم، حتى بات الإنسان يقف أمام سؤالٍ قديمٍ متجدد: ما هي الطريقة الأفضل للتعلم؟
هل هي طريق الدراسة الأكاديمية المنظمة بقواعدها ومناهجها الصارمة؟ أم هي حرية القارئ والباحث الذي ينهل من كل بحرٍ دون قيود أو جدران جامعة؟
بين هذين النهجين تبرز جدلية الفكر والمعرفة، ويختلف الناس في رؤيتهم للتعلم ذاته:
هل هو التزام بمنهجٍ واضح وخطواتٍ متدرجة؟ أم انطلاقٌ حرّ لا تحده إلا رغبة المتعلم وشغفه بالمعرفة؟
يشكّل التعليم الأكاديمي المنهجي أكثر الطرق رسوخاً في العصر الحديث، إذ يعتمد على التدرج من مرحلة إلى أخرى، بدءاً من البكالوريوس وحتى الدراسات العليا. في هذا الطريق يتلقى الطالب معارف تخصصه ضمن منظومة تعليمية دقيقة، تضعها مؤسسات علمية تلتزم بالمعايير والجودة في التعليم والتقويم. ميزة هذا النهج أنه يزوّد الطالب بأساسٍ معرفي متين يمكّنه من التوسع والتعمق في مجاله لاحقاً. فخريج الجامعة لا يخرج فقط بمعلومات، بل بخريطة فكرية ترشده في مسيرة البحث والتحليل والإبداع داخل تخصصه.
لكن هذا الطريق لا يخلو من سلبيات. فكثرة المناهج وضغط المقررات، قد يؤديان إلى اختزال المحتوى، وإغفال بعض الجوانب المهمة. كما أن انغلاق بعض المؤسسات التعليمية على فكرٍ واحد، وضعف الحوار والنقاش، قد يحدّ من قدرة الطالب على التفكير النقدي والإبداعي، واستكشاف آراء وأفكار متعددة تغني مسيرته العلمية والفكرية. ويحضر هنا القول المنسوب لجان جاك روسو: «المدارس كثيراً ما تُعلّمنا كيف نفكر كما يريد الآخرون، لا كما نريد نحن». فكم من طالب خرج من الجامعة بشهادة، لكنه لم يكتسب روح السؤال أو جرأة التفكير المستقل.
في المقابل، هناك من يسلك طريق التعلم الذاتي والقراءة الحرة، حيث يعتمد على شغفه الشخصي في اختيار ما يقرأ ويتعلم، دون الالتزام بمناهج أو أنظمة أكاديمية. إنها حرية فكرية مطلقة، تتيح للإنسان أن يطرق أبواباً متنوعة من المعرفة، وأن يكوّن رؤيته الخاصة للعالم.
وقد أنجبت هذه الطريقة عبر التاريخ أسماءً لامعة لم تتخرج من الجامعات، مثل عباس محمود العقاد الذي كوّن ثقافته بنفسه، وأبو العلاء المعري الذي سبق عصره بفكره الحر، وابن خلدون الذي أسس لعلم الاجتماع من خلال تجربته وملاحظاته الذاتية.
ومع ذلك، فالحرية المطلقة في التعلم قد تقود أحياناً إلى الفوضى. فمن يقرأ بلا منهج قد يخلط بين العلم والرأي، وبين الحقائق والانطباعات، وقد يغوص في أعماق التخصص دون امتلاك الأساس الذي يُعينه على الفهم. وهنا تتجلى الحكمة القائلة: «العلم بدون منهجية جهل منظم». إن القراءة الحرة تُغذي الفضول وتُطلق الخيال، لكنها تحتاج إلى وعيٍ نقدي وتنظيم ذاتي حتى لا تتحول إلى تيهٍ معرفي.
بين صرامة المنهج الأكاديمي وعفوية القراءة الحرة، يظهر طريق ثالث يجمع بين الانضباط والحرية، يمكن تسميته بـ «التعلم الموجّه ذاتياً». في هذا النموذج، يتحرك المتعلم بحرية في اختيار مجالات اهتمامه، لكنه يستعين بتوجيه أكاديمي يضمن له بناء معرفة راسخة ومنظمة.
هذا النوع من التعلم يحقق توازناً ثميناً: فهو يمنح المتعلم حرية الاكتشاف والاختيار، دون أن يتركه في عشوائية البحث الفردي. إنه طريق يجمع بين منهجية العالم وانفتاح المثقف، بين الدقة الأكاديمية وروح الإبداع الشخصي. وهكذا يصبح التعلم رحلةً يقودها المتعلم بنفسه، بإشراف مرشدٍ يضيء له الطريق دون أن يقيده، فيتحول التعليم إلى تجربة إنسانية ثرية، قائمة على الحوار والتفكير لا على التلقين والحفظ.
لقد أحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً جذرياً في مفهوم التعليم. فالتقنيات الحديثة، مثل أنظمة التعلم الآلي والتحليل الذكي، جعلت الوصول إلى المعرفة أكثر سهولة وشمولاً من أي وقت مضى. اليوم، يمكن للمتعلم أن يبني تجربته التعليمية الخاصة عبر أدوات مثل ChatGPT وKhanmigo وCoursera AI Mentor, التي تقدم شرحاً فورياً، وتقويماً مستمراً، وحتى توصيات مخصصة لكل طالب بحسب مستواه واهتماماته.
لكن كما أن لهذه الثورة جانبها المشرق، فإن لها وجهاً مظلماً أيضاً. فالاعتماد الزائد على الذكاء الاصطناعي قد يُضعف روح البحث والتفكير النقدي، ويحوّل المتعلم إلى مجرد متلقٍّ سلبي للمعلومة. كما أن انتشار المحتوى المولّد آلياً يطرح تساؤلات حول المصداقية والأصالة العلمية.
لذلك، فإن الحل ليس في رفض هذه الأدوات، بل في استخدامها بوعي، كما قال آينشتاين: «لقد أصبح الإنسان عبدًا لأدواته. لقد صنع أدوات لخدمته، لكنه لم يتعلم بعد كيف يسيطر على خدمه. فحين يُستخدم الذكاء الاصطناعي بحكمة، يمكنه أن يُحدث ثورة إيجابية تجمع بين سرعة التقنية وعمق التجربة الإنسانية.
في الختام، لا يمكن حصر التعلم في طريقٍ واحد. فالدراسة الأكاديمية تمنحنا البنية الصلبة، والقراءة الحرة تُطلق الخيال، أما التعلم الموجّه فهو الجسر الذي يربط بين الاثنين. وكما قال الإمام علي  : «قيمة كل امرئ ما يحسن». فالقيمة ليست في الطريقة التي نتعلم بها، بل في ما نحسنه ونتقنه في نهاية المطاف.
: «قيمة كل امرئ ما يحسن». فالقيمة ليست في الطريقة التي نتعلم بها، بل في ما نحسنه ونتقنه في نهاية المطاف.
علينا - كأفراد ومؤسسات - أن نحتفي بكل من يسعى ويجتهد في طريق المعرفة، سواء أكان طالباً أكاديمياً أو قارئاً حراً، فكل هذه الطرق، تؤدي إلى إثراء العقل وبناء الوعي الجمعي.
وحين يلتقي الطرفان، المنهجي والحر، في تناغم وتعاون متبادل، تُولد النهضة الفكرية الحقيقية التي ترتقي بالأمة كلها.