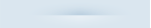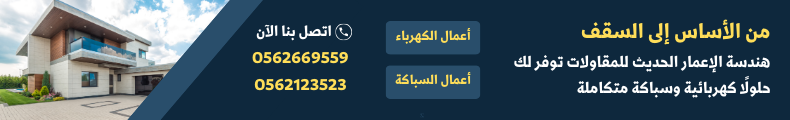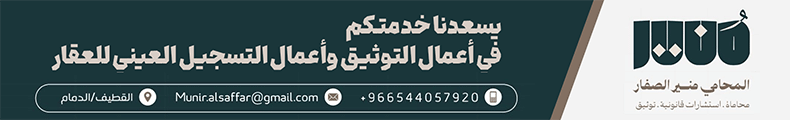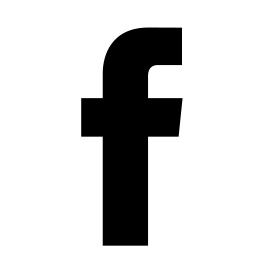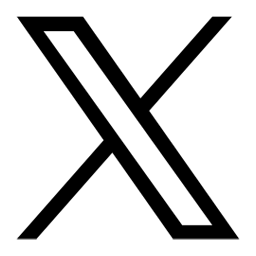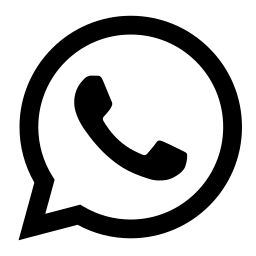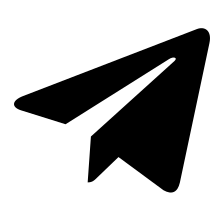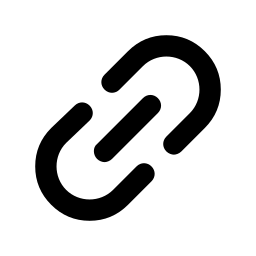بين حلم المهنة ورسالة التغيير
عندما نسأل أبناءنا الطلبة عن أحلامهم المستقبلية، كثيرًا ما نستمع إلى إجابات مألوفة تتكرر بألوان متعددة: هذا يريد أن يكون طيّارًا يُحلّق في السماء، وذاك يحلم أن يصبح طبيبًا يُنقذ الأرواح، وآخر يتمنى أن يكون مهندسًا يبني الفلل والمشاريع أو معلّمًا يصنع الأجيال، أو جنديًا يحمي الوطن…
ولست هنا لأقلل من قيمة هذه المهن السامية، فهي أعمدة الحياة وأدوات البناء، لكن السؤال: لماذا نادرًا ما نسمع صوتًا يقول: أحلم بأن أكون صاحب رسالة تُغيِّر أو أطمح لأن أكون قائدًا يُلهم الآخرين، أو إنسانًا يترك أثرًا؟
إن الإجابة في رأيي تكمن في أننا كأُسر ومدارس ووسائل إعلام نزرع في الأجيال حب المهنة، لكننا نادرًا ما نزرع فيهم فن القيادة والمسؤولية، نعلمهم كيف يعملون، ولكن نادرًا ما نعلمهم كيف يقودون، أو كيف يفكرون، أو كيف يصنعون فرقًا في الحياة.
صحيح أن مدارسنا وجامعاتنا تُخرّج كفاءات وأصحاب شهادات عليا في تخصصات متنوعة، لكنها غالبًا لا تخرج قادة ومديرين قادرين على إلهام الآخرين وترك أثر حقيقي في المجتمع، وهنا يكمن الفرق الجوهري بين المهنة كوظيفة تركز على التنفيذ والمهنة كرسالة تركز على الابتكار والقيادة والتغيير.
لكن السؤال الأهم: لماذا نكتفي بتعلم المهارات التقنية والمهنية دون تعلم القيادة والتأثير؟
والسبب ببساطة أننا ركزنا على تعليم المهنة بوصفها وظيفة لا بوصفها رسالة، وقد برمجنا أبناءنا على فكرة النجاح الوظيفي لا على فكرة الريادة والقيادة، فمنظومتنا التعليمية والمجتمعية، وحتى الوظيفية والإدارية، اهتمت بتخريج من يُحسن العمل لا من يُحسن التفكير والتغيير، ومن يعرف كيف يُنفذ، لا من يعرف كيف يبتكر ويُبدع، أو كيف يُدير ويقود.
يُضاف إلى ذلك غياب القدوات القيادية الملهمة في التعليم والإعلام، والخوف من الفشل والمسؤولية، وكلها عوامل تجعل الفرد يكتفي بدور ”الموظف الملتزم“ بدلًا من أن يسعى ليكون ”القائد الملهم“.
إن التحول نحو ثقافة القيادة يبدأ من إعادة تعريف النجاح ذاته، فالنجاح لا يعني أن تُنجز ما يُطلب منك فحسب، بل أن تُبدع فيما تقوم به وتضيف عليه معنى جديدًا. إننا بحاجة إلى تعليم ينمي شخصية الإنسان لا معلوماته فقط، ويوقظ فيه الشغف لا الطاعة، ويجعله يرى في كل مهمة فرصة للخلق والإضافة. وقد أظهرت دراسة لمعهد ”غالوب“ «Gallup» عام 2023 أن 85% من الموظفين حول العالم غير مندمجين فعليًا في أعمالهم، لأنهم لا يرون في عملهم رسالة أو معنى يتجاوز الراتب والواجب الوظيفي.
وهكذا أصبح كثير من المديرين في مؤسساتنا كمن ”يسبح في بئر“ يدور حول نفسه في مساحة ضيقة ويظنها بحرًا، وهو في الحقيقة بعيد كل البعد عن السباحة الحقيقية في محيط التجديد والتفكير. وكما يقولون أيضًا: ”من يسبح ضد التيار هو وحده من يعرف قوة الموجة“، وهو تعبير يُقال للدلالة على أن من يختار طريقًا مختلفًا عن الآخرين أو يُعارض المألوف من أجل الحق أو التغيير، هو وحده من يُدرك حجم الصعوبات والمقاومة التي تعترض طريقه. وقد أشارت دراسة صادرة عن جامعة هارفارد عام 2022 إلى أن 72% من القادة الذين أحدثوا تحولات ناجحة في مؤسساتهم خاضوا في بداياتهم تجارب مقاومة شديدة للتيار العام، لكنهم استطاعوا بفضل إيمانهم برسالتهم أن يُغيروا اتجاه المؤسسة بأكملها خلال خمس سنوات أو أقل.
إنني أعتقد أن أغلب الأمراض الإدارية الشائعة ليست ناتجة عن نقص في المعرفة أو المهارة، بل عن خلل في السلوك والفكر والاتجاه. فالمعرفة تُكتسب بالدراسة، والمهارة تُنمى بالتدريب، لكن الرسالة تُولد من الوعي والإيمان بالقيمة. قال تعالى:
﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: الآية 105]
فالعمل مراقب من قبل الله تعالى لا من المدير، ومن الضمير لا من النظام، ولا من التعليمات بل من الخوف من الله. وقد قال النبي الأعظم ﷺ:
”إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يُتقنه“،
والإتقان هنا ليس مجرد إتقان الصنعة، بل إتقان النية والغاية والرسالة. وإن تحول المهنة إلى رسالة للتغيير في رأيي يمر عبر ثلاث مراحل جوهرية، وهي كالتالي:
أولًا: الوعي بالغاية
أي أن يسأل كل إنسان نفسه: لماذا أعمل؟ هل لأعيش فحسب، أم لأضيف معنى لحياتي ولحياة الآخرين؟ فحين تتغير الإجابة يتغير الأداء. فالعامل الذي يرى في عمله عبادة، والمعلم الذي يرى في تلاميذه مشروع أمة، والطبيب الذي يرى في مريضه إنسانًا لا رقمًا، والتاجر الذي يرى في تجارته وسيلة لخدمة الناس لا لاستغلالهم، هؤلاء هم الذين يصنعون التغيير من مواقعهم. ولذلك يقول المفكر الهندي المهاتما غاندي:
”كُن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم“.
وقد أظهرت دراسة لجامعة ستانفورد عام 2021 أن الموظفين الذين يشعرون أن لعملهم معنى يتجاوز الراتب كانوا أكثر إنتاجية بنسبة 63% وأقل عرضة لترك وظائفهم بنسبة 70% مقارنة بغيرهم.
ثانيًا: القيمة قبل المهارة
المهارة هي القدرة على أداء عمل ما بكفاءة ودقة وسرعة، لكن المهارة بلا قيمة قد تُنتج محترفًا، ولكن لا تُنتج مصلحًا أو رساليًا. فالمهنة الحقيقية لا تنتهي عند حدود الوظيفة، بل تمتد لتصبح موقفًا من الحياة وسلوكًا يُلهم الآخرين. بمعنى أن العمل الشريف لا يُقاس فقط بما يُنجزه الإنسان داخل جدران مكتبه أو ضمن ساعات دوامه، بل بما يحمله من أثر وقيمة ومعنى يتجاوز ذلك الإطار الزمني والمكاني. فمهنة بلا عطاء روحي كالآلة بلا روح، لا حياة فيها ولا أثر. وكما يقول أينشتاين: ”لا تسعَ لتكون ناجحًا، بل كن ذا قيمة“، لأن النجاح قد يُكافأ، أما القيمة فتُخلّد.
ثالثًا: المسؤولية والقدوة
في تراثنا العرفي يُقال: ”من زرع المعروف حصد الشكر“، وهي دعوة لأن يرى الإنسان عمله غرسًا مستمرًا لا صفقة مؤقتة. غير أن القدوة تبدأ من الأعلى، فالقائد هو رأس المنظومة، فإذا فسد الرأس فسد الجسد كله. وكما يقول المثل الشعبي: ”السمكة العفنة تُعرف من رأسها، والشجرة الميتة تُعرف من ذبول رأسها“، وهي حكمة عميقة تُشير إلى أن أي مؤسسة أو مهنة لا تموت من أسفلها، بل من فقدان القيادة الواعية التي تُحيي القيم وتغرس المعاني. وقد لخّص الإمام علي  هذه الفكرة بقوله: ”قيمة كل امرئ ما يُحسنه“.
هذه الفكرة بقوله: ”قيمة كل امرئ ما يُحسنه“.
لتحويل المهنة من وسيلة للعيش إلى رسالة تغيير حقيقية، يمكن البدء بتطوير القيادة من الصفوف الأولى، وذلك عبر إشراك الطلاب في مهام قيادية صغيرة مثل تعيين قائد مشروع شهري لإدارة نشاط جماعي مع تقديم تقرير عن الإنجاز والصعوبات، وتشجيع المبادرات الصغيرة التي تحسن الأداء أو تحل المشكلات في البيئة الطلابية. ومن المهم أيضًا تحويل الخطأ إلى فرصة للتعلم عبر تسجيل الدروس المستفادة أسبوعيًا، إضافة إلى إبراز القدوات الواقعية من خلال استضافة أشخاص أثروا في مجتمعهم أو مجالهم المهني، مما يجعل القيادة والرسالة تجربة حية وملهمة. وهو ما أكده المفكر غاندي بقوله: ”كُن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم“.
يتجلى الفرق الجوهري بين المهنة كوسيلة للعيش والمهنة كرسالة للتغيير في العمق الذي يضيفه الإنسان لعمله، وفي القدرة على تحويل المعرفة والمهارة إلى أثر ملموس، وقيادة تُلهم الآخرين. فالمهنة الحقيقية لا تُقاس بالرواتب أو المناصب، وإن كانت هذه النظرة هي الواقع الشائع، بل بالوعي وبالغاية وباحتضان القيم قبل المهارات. فالمهنة التي لا تُغير صاحبها نحو الأفضل، لا يمكن أن تُغير العالم من حولها.