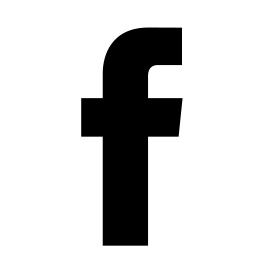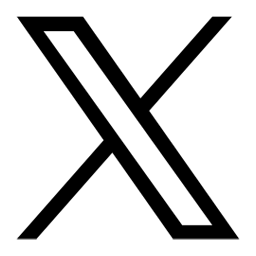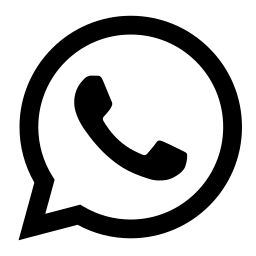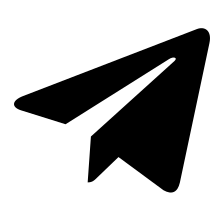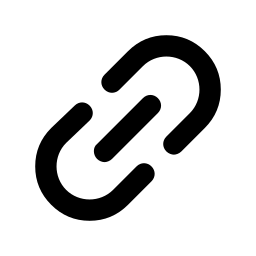سبيطية أبي البحر الخطي
ينطلق الشعراء من بيئاتهم، فمن كائناتها وعناصرها ومواردها تتشكل الحياة داخل القصيدة، وكم لفت انتباهنا وصف امرئ القيس لحصانه ذي المواصفات الخارقة، وقد ارتبط طرفة بن العبد بناقته النشطة التي تواصل سيرها غدوا ورواحا، أما الشنفرى فقد اتخذ من الذئب والنمر والضبع أصدقاء له!! ولك أن تتعجب من استنئناس الأحيمر السعدي لعواء الذئب!! كل هذه الصور تأتي في سياق الألفة مع الحيوان التي تدرسها كتب النقد المختصة بعلاقة الإنسان بالطبيعة، مثلما ذكره الناقد جرج جرارد في كتابه النقد البيئوي أن الحد الفاصل بين الإنسان والحيوان يعد اعتباطيا، وأنهما يشتركان في القدرة على المعاناة التي لا تنكرها إلا أيادي الطغاة.
قبالة هذا الانسجام مع الطبيعة ثمة وجه آخر يعكس الحالة المأساوية؛ لما تسببه هذه الكائنات من أضرار، كما حدث لشاعر القطيف أبي البحر الخطي في قصته الشهيرة عندما كان يصطاد السمك في البحرين إذ طفرت له «سبيطية» - نوع من السمك الكبير في الخليج - فجرحت خده الأيمن، ومع نزيف دمائه تفتقت قريحته الشعرية بقصيدة من أشهر قصائده:
برغم العوالي، والمهندةِ البُتْرِ
دماءٌ أراقتها سبيطيةُ البحرِ
ألا قد جنى بحرُ البلاد وتوبلي
عليَّ بما ضاقتْ به ساحةُ البَرِّ
دمٌ لم يرقْ من عهدِ نوحٍ ولا جرى
على حدِّ نابٍ للعدوِّ ولا ظفرِ
تعد قصيدة «السبطيية» من الهزليات كما هي مدرجة في تقسيم ديوانه حسب الأغراض الذي حققه السيد عدنان العوامي مشيرا إلى روح الدعابة في أكثر من موقع في قصائده مبينا أصالته الشعرية وتجاوزه في اللغة أيضا.
هذه السمكة تركت علامة في وجه الشاعر مشبها إياها بعلامة الكسر في الإعراب، وتستمر صوره الطريفة بتحويل هذه الواقعة إلى مبالغات يقتضيها الموقف نفسه، فكأنه يريد أن ينسى الألم بهذه المعالجة الفكاهية، ومن المفارقات العجيبة أن يطالب بأخذ الثأر؛ لما سببت له ابنة البحر من أذى راجعا إلى المشهد التاريخي المتأزم، وهنا يتحول الهزل إلى جد في نهاية القصيدة:
لَعَمْرُ أبِي الخطِيِّ إنْ بَاتَ ثَارُهُ
لدَى غَيرِ كُفْوٍ وهوَ نَادرةُ العَصْرِ
فَثَارُ عَليٍّ بَاتَ عِنْدَ ابنِ مُلْجَمٍ
وأعقَبَهُ ثَارُ الحُسَينِ لَدَى شِمْرِ
أربعة قرون وعدة سنين تفصلنا عن زمن كتابة قصيدة الخطي عام 1019 هـ، ورغم المتغيرات السياسية والاجتماعية التي مرت على المنطقة إلا أن هذه الروح الخليجية المتمثلة في الشاعر تبدو واضحة لنا بكل تفاصيلها، فموضوعها يلامس الوجدان مباشرة بتحويل هذه السمكة الفتاكة إلى رمز يفهمه الجيل تلو الجيل، فمعالم البيئة التي ذكرها من قرى البحرين «البلاد» و«توبلي» تذكرنا بالشاعر العربي قديما عندما يذكر الأماكن كامرئ القيس في معلقته بوقوفه بسقط اللوى بين الدخول وحومل.
في الثمانيات الميلادية قدم الأديب الإعلامي محمد رضا نصر الله ورقة عن هذه القصيدة مستعرضا فيها منظوماتها الثلاث حسب قراءته: البحر، والحرب والدم، فما ينفك الشاعر متحركا بمفرداته من محيطه وموروثه.
أما عن خلود هذه القصيدة فهو نابع من محليتها أولا، وطريقة معالجتها بكونها صورة من صور البيئة البحرية.
اتخذ الشاعر البحر فضاء شعريا لسرد حادثته التي ننظر إليها اليوم بكونها قصة اعتيادية، لكنه بث فيها طاقة متجددة من الدهشة، باستحضاره نسبه وقبيلته، وعمله على فرادة ذاته، فهذا الدم الذي أريق من خده لم يرق مثله من عهد نوح، وهكذا يتضافر عنصرا الزمان والمكان في قصته العجيبة، وتنكشف شخصية أبي البحر في مقابلة هذا الخطر وماجرى عليه بجرعة مكثفة من الاعتداد بالنفس وكأن المتنبي وهو يقف أمام مرآة ذاته:
لِيَقْضِ امرؤٌ مِنْ قِصَّتِي عَجَباً فَمَنْ يرِدْ شَرحَ هَذا الحَال يَنْظُرْ إلى شِعْرِي
أنَا الرَّجُلُ المَشْهُورُ ما مِنْ مَحلَّةٍ مِنَ الأرْضِ إلاّ قد تخلَّلَهَا ذِكرِي
فإنْ أُمْسِ في قُطْرٍ من الأرْضِ إنَّ لِي
بَريدَ اشْتِهَارٍ في مَنَاكِبِهَا يَسْرِي
لا أعتقد أن هذه الأبيات من باب الفخر فقط، وإنما هي وصف واقعي لشخصه فهو ابن القطيف وإليها ينسب باسمها التاريخي، وهو ابن البحرين أيضا متعلقا بها، وهو الذي حط رحاله في شيراز وقال كلمته الأخيرة فيها، تاركا لنا أنموذجا للشخصية العلمية والأدبية.