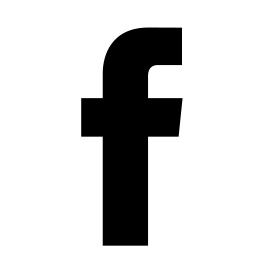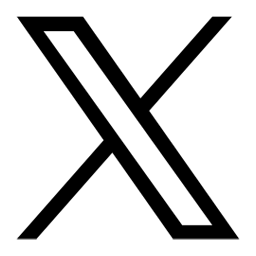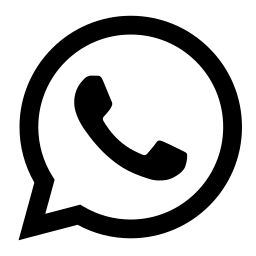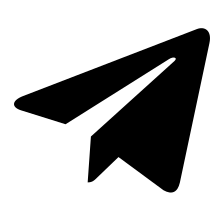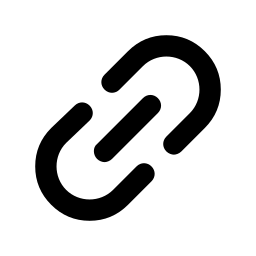من عبق الماضي: طقوس السكن الشعبي في بيوت القطيف
لم يكن البيت في القطيف قديمًا مجرد بناء من طين وجريد وجذع نخيل، ولا فضاءً ماديًا يؤوي الجسد فحسب، لكنه كان أيضًا كيانًا حيًا تنسج فيه الروح، وتغرس فيه البركة، وتتشكل بين جدرانه أولى ملامح الاستقرار والأمان. وكان السكن الأول «البيت العود»، أو كما يحلو للبعض تسميته البيت الكبير أو بيت العائلة، حدثًا مفصليًا في حياة الأسرة، حيث تحيط به طقوس وعادات متوارثة امتزج فيها الموروث الشعبي بالبعد الديني والاجتماعي، فصار البيت شاهدًا على علاقة الإنسان بالمكان، وعلى وعي جمعي يرى في المسكن بداية عمر لا مجرد مأوى.
منذ اللحظات الأولى لدخول البيت، كان التعطير بالبخور أحد أبرز الطقوس الملازمة للسكن الجديد، ولم تكن الروائح العطرة ترفًا، لكنها كانت رمزًا للطهارة الروحية والجسدية، واستدعاء للسكينة والطمأنينة. اعتادت نساء القطيف التزود من عند «الحواج» بمواد عطرية طبيعية مثل النقضة والشب والحرمل، ويخلطنها بكسرات من اللبان لينتجن خليطًا نفاذ الرائحة وطويل الأثر، يعلق بالجدران ولا ينسى من الذاكرة.
ولهذا البخور حضور خاص مع دخول شهر صفر، حيث ساد الاعتقاد بأنه يطرد الهوام والآفات، ويحول دون اقتراب الشياطين من البيوت، كما استخدم أيضًا بخور الجاوي، وهو حجر داكن منقط ذو رائحة قوية، في البيوت والمقابر والمناسبات الدينية، ولا يزال إلى اليوم حاضرًا في بعض البيوت لتغيير الجو أو لدفع الأذى، مثلما يعتقدون.
ولم تقتصر ممارسة التعطير على إشعال المبخر فقط، بل كانت المرأة تتجول به في أرجاء البيت، متوقفة عند الزوايا التي تُعرف «القرنة»، وهي مواضع كان يعتقد بوجود الشياطين والجن فيها، ويرافق تلك العادة الذكر والدعاء. وعند دخول أحد إلى البيت كانت المرأة تلوح بالمبخر فوق رأسه مُصلِّيَةً على محمد وآل محمد، في طقس يجمع بين التبرك والالتزام بنهج الأجداد واحترام العادات الموروثة.
وترتبط هذه الطقوس ارتباطًا وثيقًا ببناء البيت الجديد، فقد درج بعض الأهالي على ذبح ذبيحةً في أرض البناء قبل وضع اللبنات الأولى، فتراق دماؤها على الرتبة، ويوزع جزء منها في أرجاء الأرض، فيما تطهى بقيتها وتقدم لأهل البيت والجيران. وهذه ممارسة تعكس امتزاج المعتقد الشعبي بروح التكافل الاجتماعي، وبعد اكتمال البناء ونقل الأثاث يحين موعد «الظعن»، أي الانتقال إلى السكن الجديد، وهو يوم ذو رمزية خاصة واحتفاء جماعي.
وفي يوم الظعن تفتح أبواب البيت للأهل والجيران، ويقام إعداد ضيافة من الشاي والقهوة إلى المشروبات التقليدية مثل «الماء القروف» المحلى والليمون والدارسين والزنجبيل، وإضافةً إلى أطباق الطعام المتنوعة، ويقام مجلس ترفع فيه الصلوات على محمد وآل البيت  ، وتردد الأهازيج الشعبية، فيما يدور المبخر والمرش بين الأيدي، وتنثر الحلويات، وتتبادل الدعوات بالخير والبركة تعبيرًا عن الفرح الجماعي بالسكن الجديد. وهناك كان بعض الأهالي يحرصون على إقامةِ المجالس الحسينية الأسبوعية في بيوتهم تكريمًا لمصاب أهل البيت
، وتردد الأهازيج الشعبية، فيما يدور المبخر والمرش بين الأيدي، وتنثر الحلويات، وتتبادل الدعوات بالخير والبركة تعبيرًا عن الفرح الجماعي بالسكن الجديد. وهناك كان بعض الأهالي يحرصون على إقامةِ المجالس الحسينية الأسبوعية في بيوتهم تكريمًا لمصاب أهل البيت  وطلبًا للرزق والبركة وقضاء الحاجة، في صورة واضحة لامتزاج الدين بالحياة اليومية، ولتحويل البيت إلى فضاء تعبدي واجتماعي في آن واحد.
وطلبًا للرزق والبركة وقضاء الحاجة، في صورة واضحة لامتزاج الدين بالحياة اليومية، ولتحويل البيت إلى فضاء تعبدي واجتماعي في آن واحد.
ويعد «بيت العود» الذاكرة الأولى للسكن والمكان، ومن خلاله نتعرّف على المسميات القديمة لأقسام البيت ومحتوياته، وهي مسميات لم تكن اعتباطية، لكنها تعكس وظيفة كل زاوية ودورها في حياة الناس. فبينما اتجه البيت الحديث إلى الاتساع والتقسيم الوظيفي الصارم، ظل البيت الشعبي بسيطًا في شكله وعميقًا في معناه، وغالبًا ما يتكون البيت الشعبي من غرف ترتب على شكل مربع تتوسطها مساحة مفتوحة تُعرف «بالشمسية»، وقد تكون مكشوفة كليًا أو جزئيًا، فالجزء المكشوف منها يسمى «الليوان»، وهو القلب الذي تدور حوله حركة البيت اليومية، أما الجزء المسقوف المفتوح عليه فيُعرف «بالحوي»، وهو الحوش الذي تطل عليه الحجر «الغرف» السكنية.
وتتنوع تصاميم البيوت، ففي بعضها تنفتح الدروازة مباشرة على الليوان، وفي أخرى تصف الغرف على جهة واحدة أو جهتين، وتترك بقية المساحة أرضًا خالية تسمى «الدالية». أما الغرف فلها خصائصها المعمارية، إذ تحتوي جدرانها المعروفة «بالطوف» على دخلات تسمى «الرواشين»، وتستخدم كخزائن إضافية، إلى فتحات أخرى تعرف «بالدرايش»، وهي النوافذ، تؤدي دور التهوية وإدخال الضوء.
وكانت «الكرفاية» أو «السجم»، وهي الأسرة المصنوعة من الخشب وجريد النخل، من أهم أثاث الغرفة، فيما استخدمت جذوع النخيل كجسور تدعم الجدار، ويتكوّن السقف من خشب «الدنجل والبازجيل» المستوردين من الهند، وترص فوقها البواري، ثم يستكمل البناء بالمحجر «المحير» كسور للسطح، وترص حجارة القيد ويصب فوقها الجص.
وكانت الجدران تمسح من الداخل والخارج بالجص، ثم يطلى بالنورة مانحًا البيت إشراقه المميز. وفوق السطح يبنى العريش من السعف وجريد النخل ليكون موضع النوم في ليالي الصيف، حيث تنخفض الحرارة نسبيًا، وفي ركن بعيد عن الغرف يقام «اللبد»، ويخطئون حينما يسمونه «الأدَب»، وهو الحمام أعزكم الله المصنوع من السعف، بباب بسيط من الستار «الأخدره».
لقد عشنا تلك المرحلة، وإن جاءت في زمن متأخر، إلا أننا شهدناها بكل تفاصيلها الجميلة وملامحها الأصلية. نعم، كان «بيت العائلة» ولا يزال بناء متواضعًا في مواده، لكنه غنيًا في مسمياته، متكاملًا في وظائفه، يحتضن تفاصيل الحياة اليومية، ويحفظ في زواياه حكايات الأجداد والجدات. ولم يكن مجرد جدران وسقف، بل ذاكرة حية وروح نابضة، وشاهدًا على زمن كان فيه السكن طقسًا، والبيوت هويةً، والاستقرار فعل إيمانٍ وانتماء.